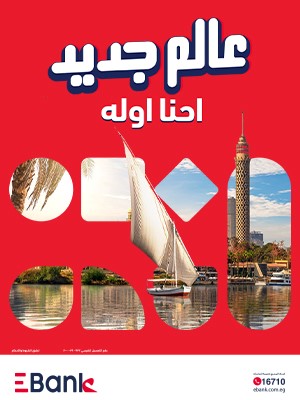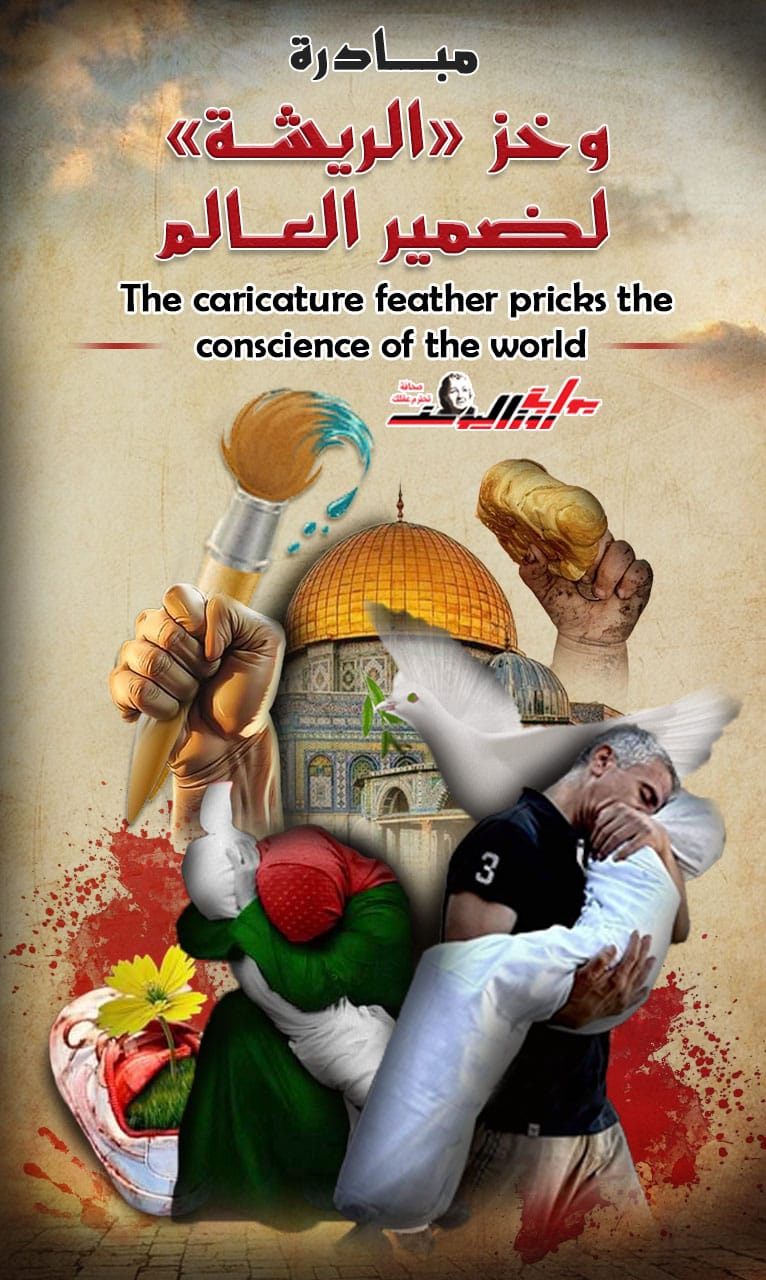د. عصمت نصار
دين بلا كهنة وعلمانية بلا إلحاد
بقلم : د. عصمت نصار
لا غرو في أن تأكيد الأستاذ الإمام محمد عبده على أنه (لا سلطة دينية في الإسلام) لم يقصد به تبيان أن الإمامة أو القيادة السياسية في الإسلام ليست ثيوقراطية كما هو الحال في المسيحية فحسب بل كان مراده أوسع من ذلك ، إذ رغب في تحرير الفكر الإسلامي من قيود عدة بداية من حرية الاجتهاد في قراءة النصوص واستنباط الأحكام ومرورا بمشروعية الشك في ما يعترض العقل من ملابسات وحرية تجديد الخطاب الفقهي ليتواءم مع احتياجات العصر وتخليص الثقافة الإسلامية من قيود التبعية للموروث من العادات والتقاليد والأعراف وانتهاء بتوضيح أن شيخ الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف لا سلطة شرعية لهم بل جميعهم يضطلع بوظيفة متعلقة بالمعاهد والمؤسسات الدينية وأن اجتهاداتهم في الفتوى يؤخذ منها ويرد تبعا لقوة السند والبرهان وعلم المقاصد وفقه المآلات والحدود.
وقد صارت مدرسة الأستاذ الإمام على نهجه في الرد على المستشرقين من جهة ومناقشة القضايا العقدية والفقهية والسياسية من جهة أخرى فجلهم كان يرى أن الإسلام دين العلم والمدنية ومن ثم لا ينبغي على الفقهاء والمفسرين تبديل هذه الطبيعة أو سجن النصوص القرآنية في تفسيرات وتأويلات الأقدمين ، ولعل كتابات (عبدالعزيز جاويش ومصطفى المراغي ومصطفى عبدالرازق وعبدالمتعال الصعيدي ومحمود شلتوت ومحمد يوسف موسى وخالد محمد خالد) خير من عبر وطبق هذا المنحى الفلسفي الذي أكد أن الأصولية الإسلامية لا تعني الجمود أو نقض الحريات وقد شارك أحمد ذكي أبوشادي في المساجلات التي دارت بين المجددين والمحافظين الرجعيين حول قضايا الفقه والعقيدة غير أنه ذهب كعادته إلى مصادرة الفكرة المطروحة لصالح وجهته التغريبية الثيوصوفية.
فقد أكد أبو شادي على مجه التعصب الديني في كل صوره وذهب إلى أن القيم التي تحويها الأديان من بر وتسامح وتراحم وخشية وصدق ومحبة تستطيع أن تجمع شتات الأمة وتعمل على تماسك المجتمع والارتقاء بأخلاقيات وسلوك أفراده، وعلى العكس من ذلك فإن الجمود والتعصب والحجر على الحريات وتكفير المخالف والتعالي على الأغيار تثير الفتن وتعمق الأحقاد والصراعات بين الأفراد والطوائف والجماعات.
فيقول: "يجب أن يكون الدين مسألة شخصية بحتة، لا أن يتغلغل في شئون الدولة، ولا أن يكون عاملاً من عوامل التفريق الخبيث بين أبناء الأمة."
ويرى أبو شادي أن وصف بعض الجماعات المتأسلمة للأناجيل والتوراة بأنها كتب مدنسة ونجسة، ومن ثم لا ينبغي على المسلمين الاطلاع عليها، قول يتعارض مع طلب العلم الذي لم يحده الشرع بحد وحرية البحث والاطلاع التي كفلها الدستور والقانون، كما أن الترويج لمثل هذه الآراء يؤجج نار الفتن الطائفية ويزيد من لهيب التعصب والعنف بين أفراد الأمة.
ويقول: "فهم المسيحية واجب مقدس على كل مسلم ومسلمة، فهو كطلب العلم بمثابة الفريضة. إن عهود الحظر على الاطلاع قد انتهت إلى غير عودة اللهم إلا في الأقطار التي تستعبدها الدكتاتوريات"
ويشيد أبو شادي بالدراسات العلمية المقارنة التي وضعها الشيخ محمد بيرم الخامس والسيد شكري باشا عن المسيحية وكذا خطبة طه حسين - في مؤتمر السلام المسيحي عام 1953م – تلك التي أورد فيها بعض أحاديث النبي صلَّ الله عليه وسلم بالفرنسية التي تدعو للسلام بين الأفراد والمجتمعات على الرغم من اختلافهم في العقيدة مبينا أن التسامح والسلام هو الجوهر الحقيقي الذي ينبغي على المسلمين والمسيحيين توضيحه وذلك في دعوتهم للوحدة الوطنية.
ويتفق أبو شادي مع محمد فريد وجدي في أن النظر للعلماء بأنهم ورثة الأنبياء يرجع إلى أن عقولهم ومعارفهم تمكنهم من الاهتداء إلى أن لهذا الكون صانع ومدبر وأنه لم يخلق عبثاً، وأن اكتشافاتهم تفصح عن القدرة الإلهية المبدعة في كل مخلوقاته، وعليه لا ينبغي على الرأي العام التابع حصر العلاقة بين الأرض والسماء في دائرة رجال الدين أو الشيوخ الذين عكفوا على دراسة التراث الفقهي والعقدي، بل يجب أن تتسع تلك الدائرة ليشغل مركزها العلماء على مختلف تخصصاتهم ويقول:
"إن أصلح رجال الدين هم رجال العلم الأتقياء الباحثين نظرياً وعملياً لا رجال الحفظ والكلام وشقشقة اللسان. وهل من صعوبة في أن يفهم العامة كما يفهم الخاصة أن القوانين العلمية الثابتة الأصول هي قوانين إلهية، الخير كل الخير في إتباعها والوبال في التغاضي عنها وإغفالها، وإن الدين الحقيقي الصالح لكل زمان ومكان هو الذي يماشيها ويفسر دائماً على ضوئها؟"
ويقول في موضع آخر:
"إن مبادئ الإسلام السمحة ممتزجة بالروح العلمية كفيلة بأن تعطي للإنسانية جمعاء ديانة شاملة حتى لمن لا يعتقدون في الإسلام اعتقاداً دينياً صرفاً. فالعلم هو الساعد الأيمن للإسلام العصري بل للإسلام في جميع عصوره النيرة. وليس المشايخ هم الذين يخدمون الإسلام بعنجهيتهم وجمودهم، وإنما يخدمه من خلصت نواياهم وصح إسلامهم من رجال العلم، وهؤلاء يجب أن تكون لهم الصدارة في تفسير كتاب الله العزيز تفسيراً جديداً بعيداً عن الأباطيل والأوهام والأضاليل"
ويمضي أبو شادي مع المفكرين العلمانيين وعلى رأسهم سلامة موسى ومحمود عزمي إلى ضرورة فصل الدين عن البرامج التعليمية في المدارس والجامعات وكذا عدم الزج بالشرائع الدينية في ميادين السياسة، ويرى أن علاقة التجاور بين الدين من جهة، والعلم والتعليم والسياسة من جهة أخرى أفضل إلى الأمم الناهضة من الخلط بينهما، وهذا لا يرجع بطبيعة الحال للقيم الدينية مسيحية كانت أو إسلامية، بل يرجع للقائمين عليها الذين دأبوا على التعصب الملي والمنطق الإطاحي مع المخالفين، الأمر الذي يعمل على تشتت ولاءات الأمة ويشعل الفتن الطائفية ويقيد السياسة بثوابت مصطنعة تحجر على الحريات وتدعم أركان السلطة الحاكمة والاستبداد والعنف، ونجده يحمل في هذا السياق على دعوة أبي الأعلى المودودي للقومية الدينية وذلك في رسالته (منهاج الانقلاب الإسلامي) مبيناً أن هناك فارق عظيم بين مفهوم الحاكمية الذي ينادي به أبو الأعلى المودودي وسيد قطب ومفهوم التشريع الإسلامي الذي يعلي من شأن العقل ودراسة الواقع في وضع الأسس القانونية الحاكمة للدولة على نحو لا يخالف الثوابت العقدية، ويتفق في ذلك مع علي عبد الرازق في أن الحكومة الإسلامية حكومة مدنية إنسانية
ويقول في ذلك: "إن تعليم الدين في المدارس لناشئة غير موحدة العقيدة من أخطر عوامل التنافر كما نعرف ذلك بالتجربة، والفضائل الأدبية التي يجب أن تدرس في المدارس يجب أن تقوم على السيكولوجيا الحديثة وعلى فلسفة الاجتماع بحيث يشعر كل طالب بشخصية ضميره كوازع ومرشد في نور العلم الصحيح لما فيه خيره وخير وطنه وخير الإنسانية، وبحيث يجد لذة عظيمة في ذلك. أما شؤون العبادات لمن يؤمن بها فلا شأن لها بالمدرسة ولا بأي مظهر من مظاهر الحكم، ولا يجوز أن تتسرب إلى المعاملات، ولا ينبغي أن تفرق بين أبناء الوطن الواحد... دعونا من قديم إلى فصل الدين عن الدولة... ومن المغالطة لأنفسنا أن نعتبر الدين من عناصر الاستقلال حينما نجده يزعزع عمد الاستقلال بما ينتجه من شقاق بأنواع الخلافات المذهبية وغيرها."
"لم أكن من أنصار الخلط بين الدين والسياسة وأؤثر فصل الدين عن الدولة لمصلحة كليهما"
ويحمل أبو شادي على الجماعات المتدينة والمتأسلمة التي نصبت من أنفسها حماة للدين وسلطة لتطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومرجعية تستأثر بالحقيقة دون غيرها، ويرى أن مثل وجود هذه الجماعات مثل الإخوان المسلمين والوهابيين، يشكل خطراً كبيراً على السلم الاجتماعي وتماسكه من جهة، وحرية الفكر والعقيدة من جهة ثانية، وروح التسامح التي تتميز بها الشرائع السماوية من جهة ثالثة، ويتفق في ذلك مع طه حسين ويستشهد بقوله:
"لم يأت هذا الشر الذي تشقى به مصر الآن من طبيعة المصريين لأنها في نفسها خيرة، ولا من طبيعة الإسلام لأنه أسمح وأطهر من ذلك، وإنما جاء من هذه العدوى"
ويقول في ذلك:
"هؤلاء وخلفاؤهم لا يستحقون إلا الإعراض عنهم؛ لأنهم مرضى النفوس، يتاجرون بالدين أو بالسياسة أو بالنزعات القومية."
ويمضي أبو شادي في نقوده للجامدين من شيوخ الأزهر موضحاً أن المادة 149 من دستور 1923م التي جاء فيها (الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية) لا تخول لهم الحجر على الآراء وصد المجتهدين والناقدين عن البحث في أمور الإسلام واللغة العربية بمنحى مغاير لطرائقهم والانتهاء إلى تصورات وأفكار مغايرة لما يعتقدون في صحته، لأنهم بذلك يعتدون على نصوص الدستور التي كفلت حرية الفكر والبحث والإبداع والاعتقاد من جهة، وتخالف في الوقت نفسه تعاليم الإسلام التي دعت إلى التفكر والتدبر والاجتهاد والتجديد من جهة أخرى.
فيقول في ذلك: "الذين يطالبون بفصل الدين عن الدولة ليسوا خصوماً للإسلام، وإنما هم في طليعة الغيورين على كرامته ضناً بها على الابتذال، إذ يقوم المشايخ بين وقت وآخر بمصادرة حرية الفكر التي رعاها الإسلام في جميع العصور استناداً على هذه المادة التي تكاد تفكك وحدة الأمة كما تكاد تعاكس كل تطور إصلاحي. والتاريخ يشهد في جميع البلاد بأن رجال الدين لم يسيطروا على الإدارة المدنية وكان النجاح حليفهم، بل الأمر بالعكس... وما يجرّئ على هذه التصرفات المنتقصة من قدر الحرية الفكرية غير الخلط بين السياسة والدين...
وعلى هذا فالمفكرون الداعون إلى صون كرامة الدين وروحانيته العليا بهذا الفصل المنشود يزيدون في الواقع غيرة على الدين ورغبة في حسن تطبيق أصوله عن أولئك المهاترين الذين يجدون في حمى السياسة غنماً خاصاً بهم وإن لم يكن في الواقع غنماً للدين ولا للمؤمنين...
فإذا لم تكن الأمة على استعداد للسير على الخطط الإسلامية كما يفعل الوهابيون، فمن الكرامة للإسلام نفسه أن نكتفي بالنظام المدني للدولة وأن نصون للإسلام عزته الروحية المستقلة في العبادات بدل هذه الذبذبة المحزنة التي لا يرضاها في الواقع أي مسلم غيور."
ويعد أحمد زكي من أبرز رواد الاتجاه العلمي الذين حملوا على القديم والموروث إذ كان يعتبر التعصب له والتغني بنجاحاته من أهم معوقات النهضة والتقدم ويقول في ذلك:
"يجب أن نشغل بالحاضر والمستقبل، فما من مؤرخ أمين أو ناقد متفلسف بصير يمكن أن ينكر فضل الإسلام التقدمي على الإنسانية."
وإذا ما انتقلنا إلى موقف أبي شادي من العادات والتقاليد فسوف تجده أقرب إلى الاتجاه الإصلاحي الذي يدعو إلى نقد الموروث من العادات وغربلتها وانتخاب الصالح منها لمقتضيات الواقع واحتياجات الحاضر فيقول:"يجب على المصلحين في الأمة تكييف العادات تكييفاً يتمشى مع تطور الحضارة...- ويمضي مع زكي مبارك في أن- العادات لا تكون من مقومات الاستقلال إلا إذا كانت صوالح، أما العادات السيئة فهي من أسباب الانحلال."
كما يرى أن المتأمل للدستور الإسلامي وما فيه من مبادئ وقيم تربوية سوف يدرك أن ما نحن فيه من تخلف وانحطاط أخلاقي وانحراف سلوكي ما هو إلا ردة جاهلية همجية يبرأ الإسلام منها، وعليه فإذا ما أراد المسلمون إصلاح أحوالهم فعليهم بالعودة ثانية إلى ما جنحوا عنه وأهملوه، ليس من بطون الكتب الصفراء بل من المناهج الغربية الحديثة التي تفهمت جوهر الديمقراطية الإسلامية أكثر من العرب الشرقيين فأثمرت في ثقافتهم حضارة راقية علينا الاقتداء بها، ويقول:
"إن التربية الإسلامية تربية ديمقراطية إنسانية واسعة الآفاق وقد أضاعها المسلمون أنفسهم، فإذا شاءوا أن يغنموا الخير من دينهم ودنياهم فما عليهم إلا الرجوع إليها، وهذا ميسور إذا ما التفتوا إلى الغرب واقتبسوا جذوتها منه لأنه صانها لهم وللعالم بأسره في مثل المدنية الحديثة الرفيعة."
ويحمل أبو شادي على التعليم في الأزهر ومناهجه العقيمة في البحث والدرس وذهب إلى أن دعوة الأستاذ الإمام محمد عبده -إلى إدراج العلوم الحديثة ضمن البرامج الدراسية الأزهرية، وذلك لدرء التعارض المتوهم بين صحيح الدين والعلم- ما زالت غاية صعبة المنال، وعلى الرغم من جهود تلميذه مصطفى المراغي في تحديث المقررات وإعمال العقل في كتب التفسير القديمة لتقويم ما فيها من الآراء التي تعارض ما أثبته العلم الحديث من قوانين ونظريات، فإن مثل هذه الجهود ما زالت مجرد دعوات إصلاحية طالما واجهها مشايخ الأزهر الجامدون بالعنت والمناهضة، ويمضي مع محمد عبده وخالد محمد خالد وعبد المتعال الصعيدي إلى أن الإسلام قد تميز عن غيره من سائر الديانات بخلوه من طبقة الكهنة، وعليه فالاحتكام للعلم والعقل والتخصص في مناقشة القضايا التي يثيرها القرآن، بداية من تفسير الآيات ونهاية بالاجتهاد في وضع الأحكام التي لم يرد فيها نصاً قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ويقول عن ذلك: "ليس في الإسلام قسيسية ولا كهنوت، ولكن فيه تفقه، وهذا بابه مفتوح أمام جميع المسلمين، وواهم من يتصور أن هذا يدعو إلى الفوضى، بل إنما هو يدعو إلى مداومة الاجتهاد الحصيف النافع، كما هو الحال في الجامعات مثلاً، إزاء جميع العلوم والآداب والفنون. وهذه الروح الجامعية من صميم الإسلام ولا روح غيرها وراء تعاليمه."
ويؤكد أبوشادي على أصالة العلاقة بين التشريع الإسلامي والعقل والعلم، ويقول في ذلك: "إن الإسلام قام في نشأته على دعائم المنطق والعلم، وبلغ ذروة عزته بهما، ولن تعود له مكانته السابقة إلا بهما، ولا رسالة له ولا روح من دونهما وهو في عالميته لا يعرف شرقاً ولا غرباً، وإنما يعرف الإنسانية جمعاء ويقول للمدنية العلمية الحديثة: لولاي يابنيتي لما كنت، فأنا موجد عصر النهضة وأنا حامي رجال الفكر والعلم، وإذن فعلماؤك هم علمائي، وهم جد أهل لتفسير مبادئي وتفسير (كتابي) المنزل. هذه هي روحي، ومن عارضها فلا حق له في الانتساب إلي، فما لي شأن بالظلام، ولا بالقرون المظلمة، ولا بالعقول الضيقة التي لا تفهم أن أئمة هذا العصر هم أوسع ثقافة وأحصف رأياً وأبعد نظراً وأجل إنسانية من الأئمة القدامى الذين صاروا في ذمة التاريخ البعيد وصارت معظم تواليفهم في حكم الأثريات فحسب. روح الإسلام إذن هي روح التجدد المستمر المبني على التجربة العلمية لسعادة البشر أينما كانوا وفاقاً لتعاليمه الأدبية الخالدة وتجاوباً مع الصالح العام."