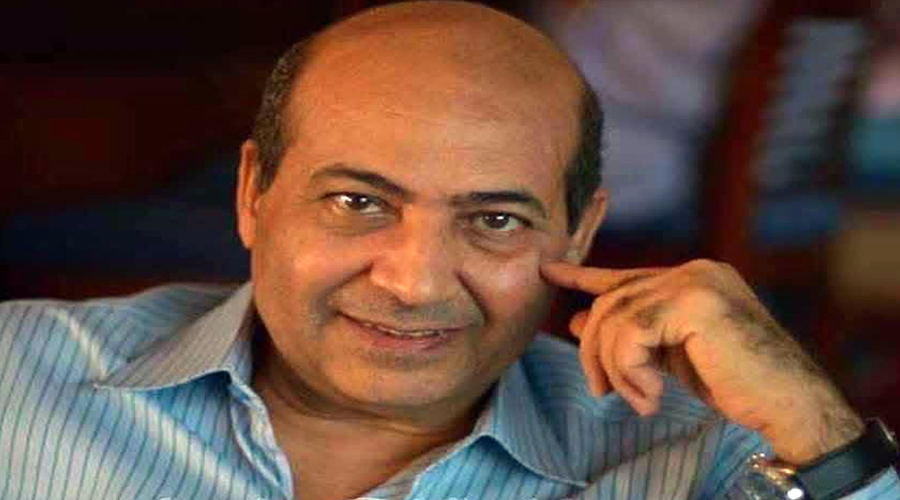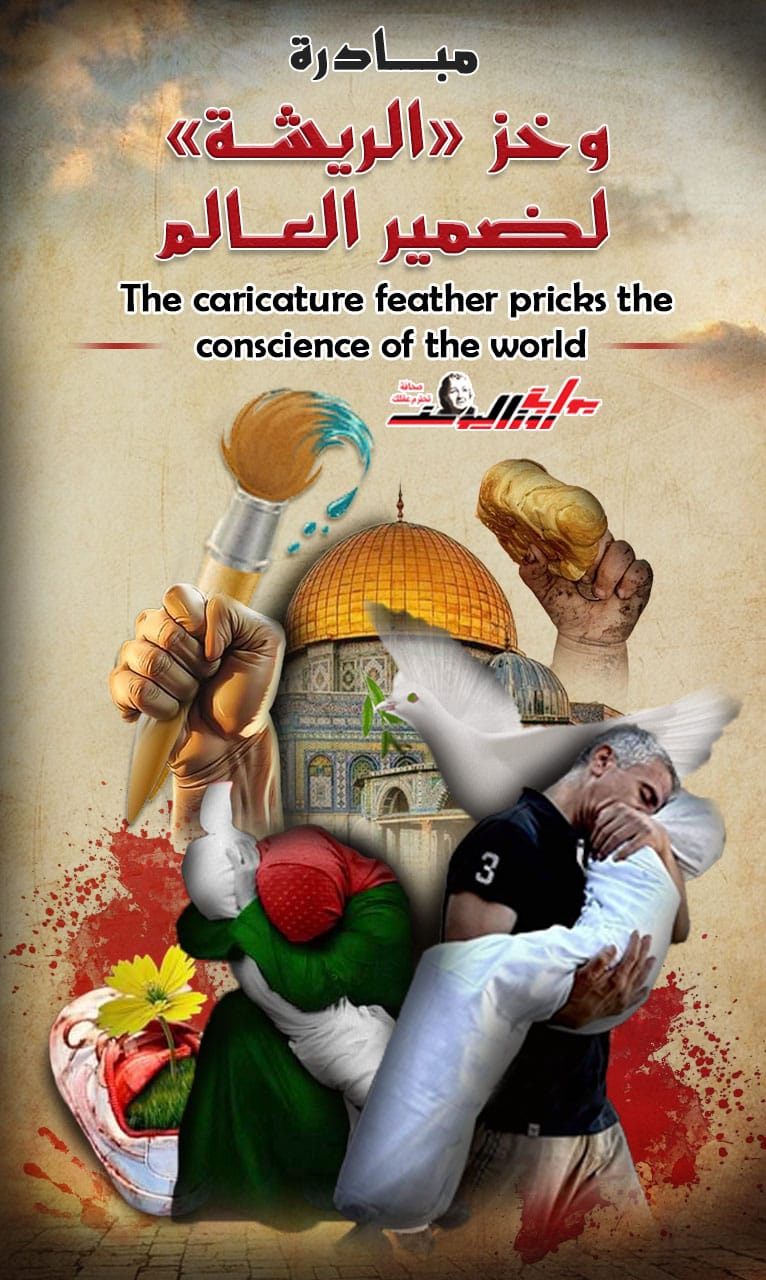د. عصمت نصار
عِلمانية المقدس وفلسفة الدين
بقلم : د. عصمت نصار
لم تقف المساجلات الثقافية بين المفكرين المصريين والشوام المحافظين والمجددين المستنيرين عند مناقشة قضايا الأدب والسياسة وحرية المرأة والثقافة الغربية وتقييم التراث العربي الإسلامي وسبل الإصلاح فحسب، بل كانت أعنف المحاولات والخصومات الفكرية حول قضايا الدين، بداية من مفهومه والعلوم الشرعية التي تسانده، وتقييم كتابات المستشرقين عن الإسلام، والرد على ما فيها من طعون ومرورًا بقضايا الإيمان والإلحاد، وطبيعة العلاقة بين الدين والعلم والفلسفات المادية والروحية، والإعجاز العلمي للقرآن وموقف الفلسفات المعاصرة من أدلة وجود الله، والنبوة والكتب المقدسة. وكان لزامًا على أبو شادي أن يدلي بدلوه في هذه المناقشات الجادة والمعارك الحامية، وكان يُحسب آنذاك على التيار العقلي، أو إن شئت قل الاتجاه العلماني، وكان يمثله في هذه الحقبة من المفكرين المصريين إسماعيل مظهر، وسلامة موسى، ومحمود عزمي، وإسماعيل أدهم، وحسين فوزي السندباد وغيرهم من الذين تأثروا بالفلسفات الغربية والنظريات العلمية المعارضة للمعتقدات السائدة والمألوفة.
وحسبنا أن نشير في هذا السياق إلى أن أبوشادي كان من أبرز أعضاء البرلمان العالمي للأديان الذي تأسس عام 1893م بولاية شيكاغو الأمريكية وكان يهدف إلى مناقشة القضايا والمشكلات التي تحول بين ترسيخ قيم المحبة والتسامح والسلام واستقرار الأمن بين جميع ديانات العالم سماوية كانت أو وضعية ومازال هذا البرلمان يعقد كل خمس سنوات، وقد صرح أبو شادي بأن علة اشتراكه في هذا البرلمان ترجع إلى رغبته في تأصيل ما يؤمن به من حقيقة روحية للأديان تتخطى كل المفاهيم والتأويلات العقلية والكتب المقدسة، تلك الحقيقة المستوحاة من الطبيعة الإلهية الخيرة الراعية والمنعمة والرؤوفة بكل مخلوقاتها ومن أقواله في ذلك:
"إن روح الله لأعظم من أن توصف وصفاً شاملاً إذ أنها تفوق فهم العقل البشري الحاضر...ومن ثمار التعاون بين الأديان فهم روح الله فهماً أصلح وفي هذا المجال قد يسهم الإسلام إسهاماً كبيراً. إن الخلاف على عقيدة الألوهة بين الأديان كان من علل التعصبات الذميمة بل والمنازعات الدموية التي لطخت تاريخ الإنسانية في قرون سابقة ولا يزال من علل شقائها الحاضر" أما في مصر والشام
فقد انقسم المفكرون فيما بينهم إلى ثلاثة اتجاهات: أولها رافض للفلسفة والنظريات العلمية والتأويلات العقلية للنصوص الدينية، بحجة أن المقدس لا يدنس بالاجتراءات والشطحات الإلحادية – وكان يمثل هذا الاتجاه العديد من شيوخ الأزهر والكثير من الآباء اليسوعيين وعلى رأس لويس شيخو (1859 – 1927) ولويس المعلوف (1876 – 1846). في حين ذهب الاتجاه العلماني المنتصر للعقل المحض والفلسفات الوضعية والنظريات العلمية إلى أن الدين شكلٌ من أشكال الخرافة التي اعتنقتها المجتمعات البدائية فألفتها الأذهان وأعطت لها صفة القداسة، ثم جاء العلم ليحرر تلك العقول من سجنها الذي اصطنعه السدنة والكهنة على مر العصور، أما الفريق الثالث فذهب إلى أن هناك إمكانية للتأليف بين هذه الثنائيات، باعتبار أن النص المقدس ثابت يمكن تأويله ليتعايش مع المتحول والمتغير والذي يستمد معارفه من الواقع المعيش وفي ذلك السياق.
ذهب مفكرنا إلى أن جل محاولات المصالحة أو التوفيق بين النصوص المقدسة وما انتهى إليه العلم من حقائق قد باءت بالفشل على يد رجالات الأزهر الرجعيين الذين لم يحسنوا فهم المنقول ولا تعقٌل أو استيعاب النتائج العلمية, ويرجع ذلك في رأيه إلى مناهجهم العقيمة المبنية على الحفظ دون الاستيعاب، وكذلك عزوفهم عن الجديد من الآراء والحديث من الآليات والنظم، وحجتهم في ذلك أن في الموروث كل ما يحتاجه المرء لتسييس دنياه وتمهيد السبيل لحسن المآب والمقام في الآخرة، الأمر الذي جعله يثني على تلك اللجنة التي أزمع الشيخ مصطفى المراغي تشكيلها لتجديد الفقه وأصوله والدعوة وخطابها، وذلك عن طريق الجمع بين النابهين في العلوم الشرعية والنابغين في العلوم التطبيقية والمعملية، راجيًا من عملها مراجعة التفاسير القرآنية التي تربط بين الثابت والمتحول في شروحها على نحو يجعل من النصوص المقدسة غير معارضة للاكتشافات العلمية.
ويرفض أبو شادي تلك الكتابات التي تحدثت عن الإعجاز العلمي للقرآن، فربطته بين دلالات لفظيه وظواهر علمية احتمالية بعينها، الأمر الذي يوقع من يؤمنون بها في الشك والريبة، فإذا ما صدَقوا النصوص المؤولة انكروا دونها من نظريات استندت عليها، وأثبت العلم الحديث خطأها، وإذا ما أنكروها ارتابوا في مصداقية النص الذي ارتبط بالدلالة أو التفسير الظني انتصارًا للعلم. ويقول: "وعندنا أن مثل هذه اللجنة تحتاج إلى شجاعة كبيرة لتفسير كل ما يخالف حرفية الحقائق العلمية تفسيرًا رمزيًا ولو تناول التفسير الأصول التي تشبثت الأجيال المتعاقبة بشروحها التقليدية المخالفة للعلم الثابت، وبغير ذلك يستحيل التوفيق بين العلم والدين ... ونحن شخصيًا نفسر القرآن الكريم تفسيرًا علميًا لتلاميذنا ولأولادنا ونعتقد أننا ناجحون في ذلك، ولكنا لسنا متهافتين على نشر هذا التفسير إلى أن يطهر الجو الديني من الأوبئة المتفشية فيه، وحينئذ تقدر هذه الحزمة لنا ويفهم مذهبنا في "التصوف العملي" على وجهه الصحيح بدل أن يحاول الكائدون تصويره على عكس صورته التي نؤمن بأنها أجل ما استطعنا تقديمه من خدمة لروح الإسلام وأدبه، ولئن لم نكن من محترفي التصوف فإن مذهبنا ذلك له حرمته عند مريديه وسيتضاعف عددهم بمرور الزمن، وسيكون يومًا من العناصر الصالحة لنقاء الإسلام ولخدمة الإخاء الإنساني، وسيجيء وقت يكون فيه هؤلاء "المتصوفة العلميون" فخرًا للإسلام ولو كره الجامدون والكائدون".()
كما نزع أبو شادي إلى نقض الكتابات التي تحاول تأويل القرآن والأحاديث لإثبات ما يطلقون عليه الإعجاز العلمي للنصوص المقدسة، ولاسيما تلك التي تستند على نظريات علمية مشكوك في صحتها واستشهد في هذا السياق بما كتبه الشيخ يوسف الدجوي (1870-1946) عن الإعجاز العلمي في حديث (الذبابة)
ويقول: "إني لم أكن مغالياً في محاضراتي وبحوثي الإسلامية السابقة حينما تشبثت بمنزلة العقل من الإسلام وبواجب التوفيق بين الدين والعلم بحيث ينبغي تفسير الدين على ضوء العلم تفسيراً مقبولاً، وبحيث كذلك ينبغي أن يبعد من الشوائب الدخيلة على الدين ما لا ينسجم مع مقررات العلم والعقل ولو أحيطا بهالة كاذبة من العنعنة والتقديس المصطنع."
ولم يقف تصور أبو شادي لطبيعة العلاقة بين الدين والعلم عند علاقة التجاور بين الثابت والمتغير، بل أراد مصادرة المنقول لصالح المعقول، إذ جعل العلم المدخل الرئيسي لتفسير النص المقدس وتحديث شريعته وتطوير عباداته وتعاليمه، ويقول:
"والمدرسة الأمريكية الإسلامية- أي التي تمثل أرقى ما وصل إليه التفكير الإسلامي في العالم الجديد، إن لم تقل أرقى ما وصل إليه التفكير الإسلامي إطلاقاً- لا تعرف شيئاً اسمه التوفيق بين الدين والعلم ، إذ أنها تعتبر العلم أداة للدين أو مظهراً له، لأن العلم يفصح عن عظمة الوجود وعن أزلية الله سبحانه وتعالى، ولأن الدين سلوك أدبي نقي، والسلوك الذي يعارض العلم أو يناقضه لا يمكن أن يعتبر سلوكاً أدبياً."
ويحمل أبو شادي على كتب الأحاديث ولاسيما ما ورد فيها من أقوال وأقاصيص لا تخلو من الاضطراب والمسحة الخرافية –على حد تعبيره- الأمر الذي برر عزوفه عنها في نزعته الأصولية العلمية التي تقوم على النظر العقلي في القرآن دون احتكام للتفاسير السابقة والاعتماد فقط على الثقافة العلمية السائدة.
وينتقل أبو شادي إلى فلسفة أبي حامد الغزالي ويرى أنها لا تعبر عن الفلسفة الحقيقية للإسلام وذلك لأنها انتهت بعد رحلة ارتيابها في الحس والعقل إلى الاستسلام للوجدان والحدس الصوفي، فمعرفة الله عند أبو شادي لا تأتي عن طريق العرفان الصوفي فحسب، بل التأمل العقلي والمعرفة العلمية أيضاً الأمر الذي جعله يعلي من شأن الجاحظ والفارابي وابن سينا وابن رشد ويجعل من آرائهم الفلسفية الممثل الحقيقي للفكر الإسلامي ويقول:
"إن الغزالي شخصية تاريخية تمثل طوراً من أطوار التفكير أو على الأصح من أطوار المساومة بين المعقولات والخيالات، وقد جنى – عن غير قصد - بهذه المساومة على رقي الفكر الإسلامي، فليس مثله حجة للإسلام في شيء، بل نراه على العكس من ذلك خلافاً للفارابي وابن سينا مثلاً، وقد كان ابن سينا على الأخص إماماً عظيماً في الشريعة لا في الطب والفلسفة فحسب، وهو الذي لم يوجب من الأحكام مثل ما أوجبه الغزالي، ولم يذهب إلى مثل تفاسيره الخرافية، وبمثله يعتز الإسلام حقاً كما اعتز بابن خلدون الذي سبق داروين بنظرية النشوء والارتقاء، وكما اعتز بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وطنطاوي جوهري وغيرهم من أنقياء المسلمين الأئمة الأحرار الذين عملوا على رد الخزعبلات والأوهام عن الإسلام، وأيدوا دعامته الأولى وهي العقل الحر الباحث المقتنع بالمنطق العلمي والتجربة"
ويرى أبو شادي أن مطالعة الكتابات الناقدة للقرآن والناقضة للأديان والحديث عنها لا يشكل خطرًا على العقيدة ذاتها، بل أنه يدفع من يدعون أنهم حُماة الدين وسدنته إلى الزود الحقيقي عما يعتقدون في صحته، وذلك عن طريق التثاقف العلمي والاحتكام إلى الحجة والبرهان والأسانيد التاريخية والتفاسير العقلية، أما أسلوب الأزهريين في مناقشة هاتيك الآراء فهو أقرب إلى العنف والإرهاب الفكري منه إلى التناظر العلمي والجدل المحمود. وإذا كان مثل هؤلاء يظنون بأن سيف التكفير سوف يخرس صوت التفكير، ويقصف سنان أقلام النقد فإنهم بلا شك واهمون، فصنيعهم يفتح الباب على مصراعيه أمام المرتابين والمشككين في النصوص المحفوظة التي لا يقبلها العقل، "ومعاذ الله أن تؤدي الحماسة للإسلام إلى الشر والعدوان".()
وحقيق بي في هذا السياق توضيح أن مفهوم الدين عند أبو شادي لا ينفصل عن اعتناقه الماسونية ونزعته الثيوصوفية (وهي التي تحدثنا عنها في مقالات سابقة) ويبدو ذلك في إيمانه بوجود إله واحد، وأن عقله الفعال فاض بقبس من علمه الأزلي على بعض المصطافين والأتقياء والأولياء والملهمين بدستور واحد قوامه التقوى والمحبة والتآخي بين الناس والسلام على الأرض وغير ذلك من فضائل تُمكن البشر من بلوغ السعادة الإنسانية والتصالح النفسي والتسامح العقلي.
لذا نألف مفكرنا لا يُعَول كثيرًا على مواطن الخلاف بين الأديان الوضعية والسماوية، بل إن نزعته الصوفية العلمية تجعله ينظر إلى الدين والعلم باعتبارهما جناحان للنفس البشرية يرتقيان بها إلى عالم الكمالات والأنوار، ودون ذلك من اعتقادات وملل أو نحل يعد في رأيه ضيق في الأفق أو قصور في الفهم أو ضعف في بصيرة التذوق للحقائق الربانية. ويقول: "فالشعور الديني ليس عقليًا فحسب بل لابد له من استعداد وجداني، وهذا التأمل الصوفي هو ما نعته الغزالي بوجه الله ... وأن عقيدة الألوهة من الناحية الفلسفية هي ظاهرة سيكولوجية، وهي إحساس الجزء بالكل، وهي تندرج تحت أسماء مختلفة من شعور الإنسان نحو وطنه ونحو زعيمه ونحو الإنسانية مثلًا إلى شعوره نحو الكون بأسره ونحو الألوهة الشاملة والمطلق ... فالإحساس بالألوهة قد يكون واحدًا (وإن تدرج) عند أصحاب الديانات المختلفة من متمدينين وهمجيين لأنها ظاهرة سيكولوجية متماثلة المنشأ ولكن تفسيرها يختلف بينهم جد الاختلاف ولو كانوا جميعًا مخلصين في إيمانهم ... وأن الإيمان بالله يتمشى مع العلم، على اعتبار أنه ليس سليل الوهم أو الجهل أو الفلسفة الخاطئة".()
وذهب إلى أن جون لوك، وديفيد هيوم، وجون ستيوارت مل، وهربرت سبنسر لم يقطعوا أو ينكروا إنكارًا تامًا لوجود إله بل صرحوا بأن العقل عاجز عن إدراكه إدراكا حسيا (اللا أدرية)، أما كانط، وفشته، وشلنج، وهيجل، وشوبنهاور فقد فصلوا جميعًا بين العلم بمفهومه الحديث والإيمان الذي يعول على الشعور والمدركات الروحية، غير أنهم لم ينكروا تمامًا وجود ذلك الإله.
وانتهى إلى أن كانط من بين فلاسفة التنوير قد استطاع تقديم الحجج على وجود الله استنادًا على العقل العملي الأخلاقي والشعور الوجداني على الرغم من تصريحه بأنه لا أدريٍ إذا ما عرضت قضية الألوهية على العقل الخالص أي المعرفة العلمية البحتة.
بينما وحد هيجل بين الروح والحقائق المطلقة وفكرة وجود الإله وجعل من ذلك التصور منحى جدلي يجعل العلوم الجزئية ضمن حركة انتقاله من الحس إلى العقل إلى الروح المطلق.
ورغم ذلك لم يفلح الفلاسفة المحدثون في مناهضة الإلحاد وإيقاف مؤشر الإيمان عن التراجع ولاسيما بين الشباب إلى درجة أن الإيمان بالإله أضحى مصطلحًا يعبر عنه في الأوساط الفلسفية بالحاسة الدينية أو الإدراك الشعوري.
ثم سادت الفلسفات الوضعية وذاعت النظريات المادية في مطلع القرن العشرين إلى درجة بات فيها الحديث عن وجود الإله حديثًا أقرب للغو والخرافة .
ويصرح أبو شادي بأن المتدينين المعاصرين لا يمكننا التسليم لهم بأن مسيحيتهم أو إسلامهم نتيجة فعل إرادي، بل أن ذهابهم إلى الكنائس والجوامع أضحى من العادات الاجتماعية والمعتقدات الموروثة والمشاعر النفسية، أي أضحى التدين مجرد شكل بلا مضمون لا يعبر عن صلب التعاليم الربانية، ويقول: "والواقع أنه حتى في الجيل الحاضر تثبت إحصائيات الكنائس أن ثلثي من ينتسبون إلى المسيحية هم عمليًا بعيدون عنها ولا صلة لهم بأية كنيسة، مع هذا لا يمكن مطلقًا لأي بحاثه اجتماعي أن ينكر أن الإنسانية الحاضرة سامية في أخلاقها وإن كانت غير متمسكة بأديانها الموروثة، وإنما ينصب تمسكها على الاستفادة من تجاريب الحياة التي تعتبرها مصدر إلهامها الوحيد الجدير بالاحترام. ()
ويعود أبو شادي ويؤكد أن الفلسفات الروحية وعلى رأسها التصوف هو الباب الأرحب والسبيل الآمن لبلوغ الحقيقة المتمثلة في الفضائل الأخلاقية التي تدفع معتنقيها للعمل بمقتضاها فيثبتون عمليًا بأن ذلك المبدع للكون حي فينا وهو منا بمثابة الأب المطاع والكنز الخفي والمصباح المنير الذي يرشد قلوبنا قبل أعيننا للحقائق الكلية. فالتصوف العلمي عنده هو الدين الحق.