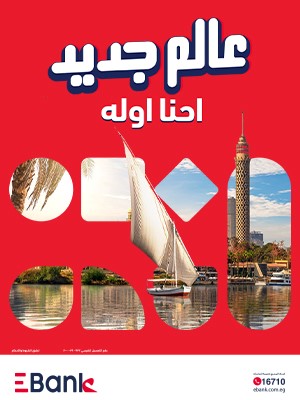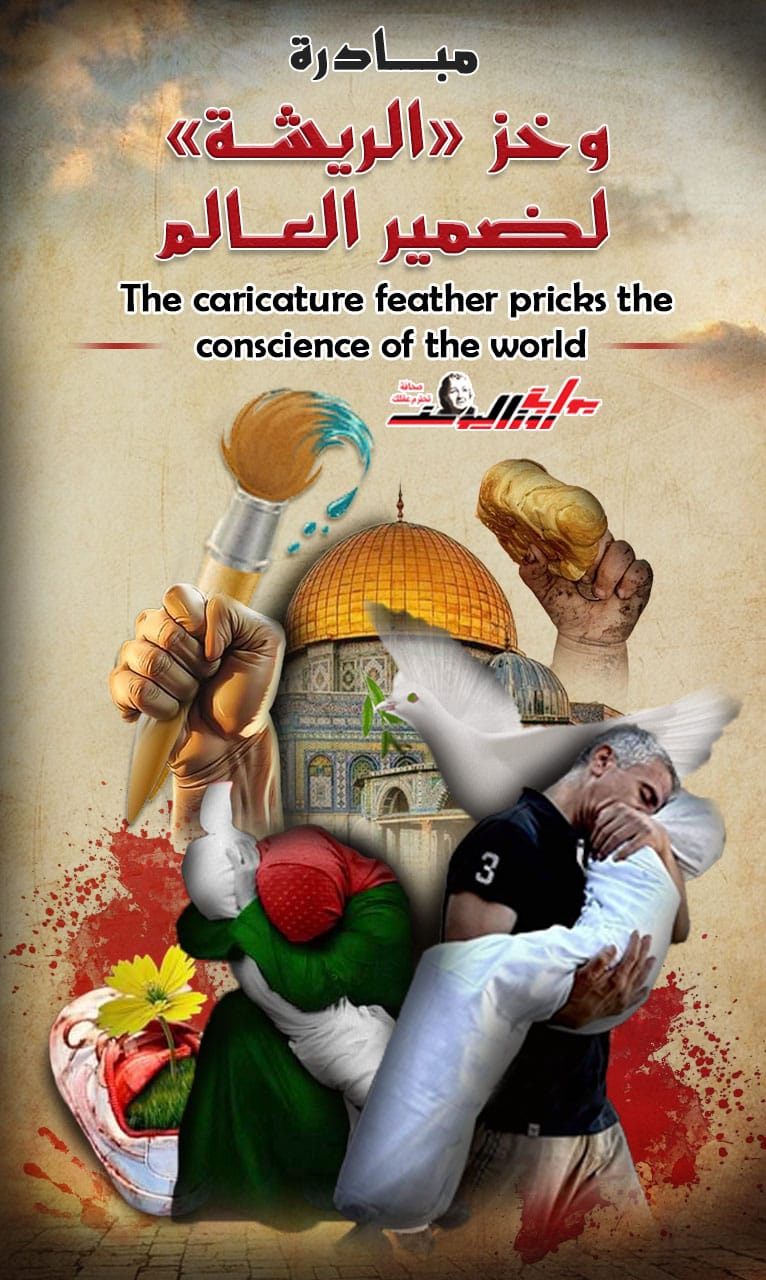د. عصمت نصار
الطريق من هنا
بقلم : د. عصمت نصار
1) بين التفاؤل والتشاؤم
لقد شغلت قضية التفاؤل Optimism والتشاؤم Pessimism حيزًا كبيرا على مائدة فلاسفة الإصلاح والتنوير الأوربيين في القرنين السابع عشر والثامن عشر وقد انقسموا حيالها إلى ثلاثة اتجاهات. أولها يرى أن خيرية العالم هي الأصل وأن الشر محدود ويمكن السيطرة عليه والحد منه، وذلك تبعا للقوة الرغبة في الإصلاح وصدق التعلق بالأمل في غدٍ أفضل. وأن الله العادل قد غرس المحبة والتراحم في قلوب البشر غير أن المطامع المادية هي التي جنحت بالإنسان وقذفت به إلى أتون الصراع والظلم والاستبداد والأنانية ومن ثم يمكن إعادة ذلك الإنسان إلى فطرته، عن طريق التربية القويمة وطاعة الله. وأن الشرور الجزئية التي نضيق بوجودها في عالمنا لا غنى عنها لأنها تذكرنا بجمال الخير، فالنقص هو الذي يجعلنا نطمح إلى لكمال، والمرض هو الذي يشعرنا بنعمة الصحة. وأن إدراكنا لماهية الرذائل والآثام هو الذي يدفعنا إلى الإقلاع عنها بعد وقوفنا على وجهها القبيح ومآلها الخسيس. ومن أشهر الذين دافعوا عن هذه الرؤية ديكارت (1596-1650) ، سبينوزا (1632-1677) ، لايبنتز (1646-1716).
وعلى النقيض منهم ذهب كل من باسكال (1623-1662) وجون لوك (1632-1704) وبير بايل (1647-1706) ، إلى أن العالم شاغل بالشرور وأنه ليس هناك أمل في تحقيق السعادة على الأرض وأن الشيطان قد نجح في توجيه الإنسان إلى عالم الشهوات والرذائل، فاندفع بدوره يصارع ويسفك الدماء ليغتصب ما ليس له، اعتقادًا منه بأن الأنانية وحب التملك والطمع سوف يحقق له السعادة ويخرجه من الشعور باليأس والقلق.
وبين أولئك وهؤلاء يقدم المرتابون والملحدون والماديون تشككاتهم في خيرية العالم وأن الله قد خلقه على نحو هو الأفضل من بين الممكنات، وأن الشرور الطبيعية كالزلازل والبراكين لها مبررات ميتافيزيقية وأنها عقابًا عادلا للمتجبرين في الأرض، وأن الأنفس الشريرة يمكن إصلاحها، وأن الإنسان في مقدوره أن يقيم المدن الفاضلة على الأرض حيث العدالة والحرية والسلام، وأكدوا جميعا أنه إذا كان الله موجودا باعتباره أصل العدالة والمحبة فإن أقداره سوف تظل لغزًا محيرًا لا يستطيع العقل فهمها وتفسيرها. ومع افتراض أن الإنسان خيّر بفطرته فإننا لا يمكن إنكار مسئوليته عن وجود الشر في سلوكه وطباعه وأفكاره. ويمثل هذا الاتجاه مونتاني (1533-1592) وتوماس هوبز (1588-1679) وفولتير (1694-1778) وهيوم (1711-1776).
وإذا ما انتقلنا إلى الفكر العربي الحديث، فإننا سوف ندرك أن معظم المجددين والتنويريين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، قد أكدوا على أن اليأس والاستسلام للواقع والنظرة التشاؤمية للمستقبل والشك في آليات التغيير ومقاصده والنظر إلى قلاع الاستبداد والرجعية والظلم والانحطاط والتدني والفساد في شتى نواحي الحياة على أنه قدر محتوم أو قوة عظمى ولا قبل للثائرين لها وأن الجهود الإصلاحية أضعف من أن تزيحها. أي أن تلك النظرة التشاؤمية هي العائق الحقيقي للنهوض والإصلاح والتبدل، وأن غيبة الأمل في نفوس الشباب وعقول الشيوخ يؤدي حتمًا إلى مزيد من التخلف والتردي والانحطاط، ومن ثم ليس هناك طريق للتغلب على مشكلات الواقع والتخطيط لمستقبل أفضل سوى إعادة الأمل ونشر روح التفاؤل في الرأي العام. الأمر الذي مكن زعماء الإصلاح في مصر والشام والعراق وتونس والجزائر من إعادة بناء العقلية العربية وتجديد الفكر الديني ووضع الخطط الإصلاحية في السياسة والاجتماع والتعليم والتربية والأخلاق.
وإن من يتأمل واقعنا المعيش، سوف يجد شبيبتنا على وجه الخصوص والرأي العام التابع تسوده وتسوسه روح التشاؤم والإحباط واليأس، ويرجع ذلك إلى عاملين:-
- أولهما عجز قادة الرأي عن إيجاد حلول جذرية للمشكلات التي يعاني منها المجتمع العربي بعامة والمصري بخاصة (الفرقة – التمزق – الصراع – الإرهاب – العنف – الأزمات الاقتصادية والسياسية – التفكك الاجتماعي – انحطاط مستوى الصحة والتعليم والتربية والأخلاق – فساد الذمم والأذواق – غيبة المنابر الثقافية التي تعمل على ترسيخ الهوية – هجرة العقول المبدعة – تعملق الأقزام).
- وثانيهما فشل الانتفاضات العربية التي أطلق عليها الغرب "الربيع العربي" في مخططه الشرق الأوسط الجديد، عن تحقيق ما كانت الشعوب العربية تطمح إليه من (رغد وسعادة، وثراء، وتكافل اجتماعي، وحرية، وعدالة، وارتقاء بشتى نواحي الحياة، وحل المشكلات المزمنة التي توارثتها الأجيال من وهن وضعف وتخلف). وقد أُصيب الشباب بصدمة دفعته إلى العبث تارة والاكتئاب تارة ثانية والاغتراب تارة ثالثة. وذلك بعد عجزه عن بلوغ مآربه كما كان مخطِط لها في المجتمع الافتراضي (ثورة – تغيير راديكالي يؤدي إلى استقرار وسعادة – مدينة فاضلة). أضف إلى ذلك كله الحملات التشكيكية المثبطة والميئسة من أي فعل أو تصور أو محاولة لمعالجة الواقع. وقد تضافرت جهود الجماعات الجانحة وقلاع الرأسمالية الفاسدة والليبرالية المتطرفة وتيارات اليمين المتعصب في أميركا وأوربا والمؤسسات الصهيونية في الترويج الإعلامي لفلسفة التشاؤم ودعم العنف وتضييق الخناق على قنوات الإصلاح الاقتصادي في مصر بخاصة ومعظم أنحاء العالم العربي بعامة.
ويحذر علماء النفس المعاصرون من الإفراط في كلا الشعورين (أعني التشاؤم والتفاؤل)، وتفشيهما في شبيبة الرأي العام التابع وشيوخ الرأي العام القائد. وذلك لأن مثل هذه المشاعر الخادعة تحول بين العقل وفحص الواقع ودرس ما فيه من مشكلات وانتخاب الأفضل من الحلول والإلقاء بالذهن والإرادة في عالم الأحلام تارة وظلمة الكوابيس تارة أخرى، والنتيجة واحدة في الأمرين ألا وهي عدم التمكن من تحقيق المراد والمقصود. ولا غرو في أن التطرف في التفاؤل والتهوين من المعوقات يؤدي إلى تزييف الرأي العام ثم فقدان الثقة في الحكومة وقادة الرأي، الأمر الذي يدفع إلى أمرين، إما الثورة والعنف والمجون، أو الانتحار. والعكس صحيح فأبواق التيئيس ذات النغمات المتشائمة والألحان المشككة التي تهول من حجم المشكلات تدفع العوام في معظم الأحايين لنفس النتيجة.
لذلك كله أرى أن السبيل للخروج مما نحن فيه هو إعادة قراءة الواقع في ضوء مشخصاتنا الإسلامية، وتصورات وتجارب المجددين العرب الذين اجتهدوا في التغلب على المشكلات المماثلة والأوضاع المتشابهة، ثم محاولة تفعيلها باعتبارها إحدى مشروعات التجديد.
فقد حثت الأديان بعامة والإسلام بخاصة على التفاؤل والتمسك بالأمل والابتعاد كلية عن التطير والتشاؤم. وذلك إذا أحسن المرء عمله وأتقنه واجتهد في طلب الرزق الحلال ثم توكل على الله. فالأخذ بأسباب النجاح والإخفاق وتقدير عواقبها ملقاة على كاهل الفرد الذي أمره الله بمجاهدة نفسه ورعاية من يخضعون لولايته ومن يستظلون برعايته، أي أن السعي والاجتهاد والأمل في غد أفضل هو الذي يقود المسلم إلى التفاؤل، وأن الإحباط وسوء التقدير والانحراف عن القيم الخلقية والروحية هو الذي يدفع الشخص لليأس والتشاؤم والارتياب في رحمة الله والشك في قدرته على تفريج الكرب وإزاحة الهم. وقد نبذ الإسلام التطير وضرب الأقداح وقراءة الطالع وغير ذلك من صور التواكل –تلك التي ألفها العرب في جاهليتهم- التي جعلت مصائر الأعمال في يد عبس الأقدار. وذلك لأن الله قدر مقاديره بعلمه وليس إرادته، فالله لم يكتب الشر على بعض الناس ليجعلهم أشقياء ولم يخص به البعض الأخر ليعيشوا في سعادة ورغد العيش، بل إنه علم مآلات الأفعال التي اختارها الإنسان بمحض إرادته فكتبها عليه فأضحت قدره (من أعمالكم سلط عليكم – إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا – نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها)، فالتطير شرك، والشك في عدالة الله وخيريته خروج من الملة (وما كان ربك بظلام للعبيد).
وأعجب من الذين يستقرأون الغيب على ألسنة الكهنة والعرافين والسحرة والمشعوذين، ويتفاءلون ويتشاءمون تبعًا لتكهناتهم. وجاء في الحديث أن إصلاح المجتمعات والخروج من الأزمات لا يتحقق بالتواكل أو بصدق الدعوات، بل بالاجتهاد والعمل والكفاح، وتقويم الأنفس قبل المرافق والدواوين، ونزع اليأس من الصدور، وإن ضاقت الأرزاق وزاد الفساد وأوشكت الأمة على الهلكة، وذلك لأن اليأس يثبط الهمم ويقعد الناس عن العمل ودفع الضرر وتقويم المعوج.
وأنني أعجب كذلك من الذين يسخطون على الحاضر ويتباكون على الماضي ويتوعدون الناس بأعاظم الشرور في المستقبل ثم بعد ذلك يتحدثون عن وعورة دروب الإصلاح، ويشيعون أن الهروب من مسئولية المواجهة أفضل الحلول، و أأسف في الوقت نفسه على أولئك الذين يزيفون الوقائع ويخفون الحقائق ظنًا منهم بأن ذلك الصنيع يحمي السلطة القائمة ويقنع الجمهور بأن ما هم فيه من ضنك هو مقدر عليهم ولا مراد للمقادير، ومن ثم عليهم بالصبر. وعندي أن أيسر الحلول لما نحن فيه هو المصارحة والشفافية والصدق في الوعود وطلب العون من كل أفراد الأمة لتحقق العهود. فقد مضى عصر المعجزات واستحالة الواقع إلى نقيضه ومن توهم غير ذلك فليس أمامنا سوى طريقين: أولهما اعتزال المجتمع والاستغراق في عالم الأحلام حيث المجتمع الافتراضي أو دنيا الإدمان والمخدرات أو تسول العجزة والمحبطين، أما الطريق الثاني فهو التمرد والثورة الهدامة والعنف والانتحار.
وأعلم أن نفر غير قليل من بيننا سوف يتهكم على ما استفضت في شرحه وتبيانه، ولا أملك ما أعطيه له سوى التصريح غير ناصح بأن تلك هي الحقيقة، فلا سبيل أمامنا سوى إعادة البناء راضين أو مكرهين.