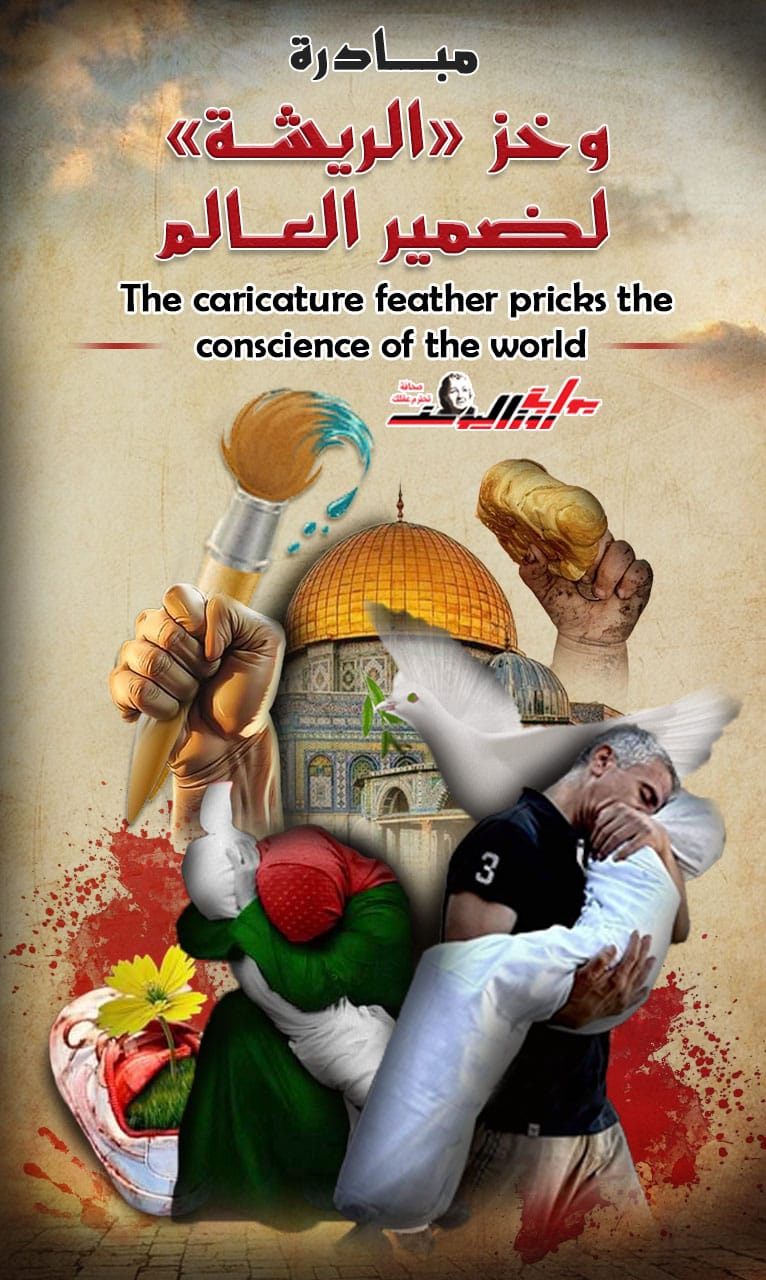شاكر موسي يكتب: الخطاب الدعوي ودوره في ترسيخ السلام العالمي

قراءة في خطابات الإمام الأكبر شيخ الأزهر
إن قضية تطوير الخطاب الدعوي، تُعد بمثابة حاجة ملحة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية التي تُحيط بنا. والناظر إلى خطابات الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، يمكنه أن يرى أن فضيلته يدعو دائمًا إلى ضرورة مواكبة الخطاب الدعوي لقضايا الواقع. ولذا فإن الداعية عليه أن يُدرك في المقام الأول حجم المسؤولية الدينية والقومية الملقاة على عاتقه، الأمر الذي يتطلب منه أن يُخاطب الجمهور بلغة تمس واقعهم وتطرح حلولًا لمشكلاتهم. فكثير من الناس ينظرون إلى الداعية على أنه إنسان يتوسم فيه الصلاح، بل وربما يبالغ البعض ليرى فيه الإنسان الذي يقدم له حلولًا لكل مشكلاته، ويصل الحد إلى اللوم علي واتهام بالتقصير، ناسيًا كون الداعية إنسانًا لديه قدرات وحدود. ربما يحمل ذلك على المحمل الطيب، وهو أن الداعية له تأثير كبير بين الجمهور، رغم محاولات التشويه التي نراها في العديد من وسائل الإعلام، والتي هي أحد مصادر التلقي للمواطن العادي وأحد الوسائل التي تشكل خلفيته الثقافية، هذه الصورة التي تقدمها عن الداعية يشوبها التشويه المتعمد في العديد من الأحيان، وقد يصل الأمر لحد الاستفزاز في بعض الأحيان، لكن الجمهور الواعي يُدرك أن الداعية يسعى إلى تبليغ كلمة الله تعالى إليه، وأنه لا يملك له إلا النصح. كما أن الدعاة الأزاهرة قد حققوا، ولله الحمد، تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، وهنا عقّب فضيلة الإمام الأكبر في أحد خطاباته "إنَّما بلغَ هذا النجاحُ ما بلغَ بالقدرةِ على التحرك والنزولِ إلى الناسِ بدُعاةٍ وداعياتٍ، ودُخولِ البيوتِ في القُرى والكُفُورِ، عِلاوةً على اعتلاءِ بعض المنابرِ".
ورغم ذلك لا ينكر أحد أن هناك عزوفًا من بعض الأشخاص عن الخطاب الدعوي، وليس عن الدين، فهناك فارق كبير بين هذا وذاك، حيث يربط البعض بطريق الخطأ بينهما، الأمر يرجع في ذلك إلى حالة الترهل التي سادت على الخطاب الدعوي، خلال الفترة الأخيرة، وهذا له أسباب كثيرة يصعب علينا سردها وتحليلها في هذا المقام.
لكن لا بد لنا من معرفة شخصية من يقوم على الخطاب الديني، ذلك لأن علوم الدين هي من أهم وأجل العلوم التي لا غنى للإنسان عنها، حتى أولئك الذين يدعون خلاف ذلك، فالإنسان كائن متدين بطبيعته، ف«التديُّن والشعور الدِّيني»، كما أورد فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب غريزة ثابتة في فِطْرةِ الإنسان، وأنَّه أقوى تأثيرًا في قيادةِ الإنسانيةِ نحو السَّلامِ والعَدْلِ والمُسَاواةِ، لكن من الذي نأخذه عنه هذا العلم الجليل؟ ومن هذا الذي يسلم له عقول الشباب والشيوخ؟ لا بد من وضع معايير لمن يتولى الخطاب الدعوي، إذ لا يكفي على الإطلاق التدين الشكلي فلابد من وعي كامل بالواقع، وكذلك بالقضايا المختلفة المحلية والعالمية. كما أن الداعية يجب أن تكون لديه ثقافة واسعة في كل المناحي التاريخية والإنسانية، حتى يتمكن من توصيل المعلومة إلى المتلقي بشكل صحيح ومبسط.
إن الهجوم على المؤسسات الدينية، هو أمر في غاية الخطورة، ذلك لأنه يؤدي بلا شك إلى فقدان الثقة فيها واللجوء إلى البديل، وهذا البديل يتمثل في الجماعات المتطرفة، والتي تحمل أفكارًا هدامة. هذه الجماعات لا تمثل تهديدًا لعالمنا العربي والإسلامي فقط، ولكن تهدد السلم العالمي، وللأسف فقد أصبحت خنجرًا مسمومًا في خاصرة الإسلام والمسلمين. وأصبح الدين الإسلامي موضع اتهام نتيجية لتصرفات بعض المحسوبين عليه، ومكلفًا من العديد من الدوائر المحلية والعالمية لدفع فاتورة تصرفات شاذة لا تمت له بصلة. بل إننا لا نبالغ على الإطلاق إذا ما قلنا إن بعض الجهات الخارجية التي تناصب الإسلام العداء على التي تقف خلف الجماعات المتطرفة، وتوفر لها الغطاء والتمويل.
إن القيادات الدينية تقع عليهم المسؤولية الأولى في ترسيخ مفهوم التعايش السلمي، بغية بث الطمأنينة والسلام العالمي، والذي يركز عليه دائما فضيلة الإمام الأكبر في خطاباته. حيث يرى فضيلته أن "عُلَمَاءَ الدِّين ورجالَه – (هم قبل غيرهم تقع المسؤولية عليهم)، لتدارك هذه الأزمة التي يَختَنِقُ بها العالَم اليوم، وطريق ذلك: أن الأخوَّة العالميَّة التي راودَت أحلامَ الأزهرِ في ثلاثينيات القرن الماضي، ولا زالت تراودُه حتى هذه اللحظة، تبدأ من الأخوَّة بين رجالِ الدِّين أوَّلًا، أو كما يقول اللاهوتي الكبير/ هانز كينج: «لا سَلام للعالَم بدون سلام ديني»، وعليه فإن علماء الأديان –اليوم- إذا كانوا ينتوون القيام بدورهم في التبشير بالسلام العالَمي، وإحلال التفاهم محل الصراع، وتحقيق آمال الناس في عالَم مُتكامِلٍ متفاهم - فعليهم أن يحققوا السلام والتفاهم بينهم أوَّلًا، حتى يُمكنَهم دعوة الناس إليه". ذلك لأن ما يمكن أن يحققه هؤلاء قد يعجز عن تحقيقه غيرهم، لذا فمن الممكن أن يلعب رجال الدين دورًا إيجابيًا أو سلبيًا، وذلك طبقًا لتوجهاته الدينية المعتدلة وتوجهاته الوطنية. ومن هنا يتحتم وجود الدقة في تقديم الأصلح، لأن من يقف أمام الناس مخاطبًا إياهم من منطلق ديني لا بد، وأن يحظي أولًا بالأمانة وكذلك التسامح. وهذا هو منهج الأزهر الشريف الذي يدعو إلى الوسطية والتعايش ونشر ثقافة التسامح، ويدعم الحوار مع الآخر أيًا كان توجهه أو جنسه أو دينه.
إن تهديد السلم العالمي أصبح أمرًا واقعيًا خاصة مع تنامي الفكر المتطرف في كل مكان، فقد تنامت الحركات المتطرفة في أوروبا، وأصبحت تمثل قلقًا بالنسبة لهذه المجتمعات، الأمر الذي سبب حالة من الجور والظلم وتعميم لأحكام ظهرت آثارها السلبية على المسلمين المهاجرين. وقد لعب الإعلام بكل أسف دورًا سلبيًا في هذا الأمر، نظرًا لأن من يقومون عليه إما أنهم يخدمون مصالح سياسية لدول معينة نظير أموال طائلة تقدم لهم، أو بسبب حالة الجهل المطبق لدى العديد منهم، الأمر الذي يحملهم على الهجوم دون أن يعطي للآخر مساحة لإيضاح ما غمض من الأمور. وسواء أكانت الأولى أم الثانية، فالنتيجة واحدة وهي تقديم صورة مشوشة ومشوهة للمشاهد الأوروبي والغربي بشكل عام، بل ونقول إن هناك دولًا أخرى آسيوية صارت تتأثر بهذه الصورة النمطية التي تقدم في وسائل الإعلام، يعقبه بلا شك ردود فعل عنيفة من حرق مصاحف، ومساجد بل وفي العديد من الأحيان يصل الأمر إلى تهديد السلامة الجسدية وتهديد الأرواح، وهناك العديد من النماذج التي لا يتسع المقام لذكرها. فهناك، للأسف الشديد، من يظهر أن القتال مع الآخر إنما سببه ديني في المقام الأول وأن الغرض منه إجبار الآخر على اعتناق الإسلام. وهنا يفند الإمام الأكبر هذا الافتراء قائلا "الإسلامُ هو دِينَ السَّلامِ بامتيازٍ، كما كان دِينَ المساواةِ بامتيازٍ؛ وإذن فليس صحيحًا ما يُقالُ وما يطبَّقُ للأسفِ الشَّديدِ الآنَ مِن أنَّ سببَ مشروعيَّةِ القتالِ في الإسلامِ هو كفرُ الآخَرِينَ، فهذا كذبٌ محضٌ على الإسلامِ وعلى سيرةِ رسولِ الإسلامِ. والحقُّ الذي يجبُ قولُه وتتحتَّمُ معرفتُه في هذه القضيَّةِ هو أنَّ مشروعيَّةَ قتالِ الآخَرِ في الإسلامِ هي ردُّ «الاعتداءِ والعُدوانِ»، وليسَ الكفرَ، أو عدمَ الإسلامِ، أوِ الخلافَ في الدِّينِ، وإلَّا فكيف نصَّت كلُّ كتبِ الفقهِ التي حَفِظَت لنا أحكامَ الفتوحاتِ على حقِّ بقاءِ أهلِ البلادِ على أديانِهم وتمتُّعِهم بكاملِ حقوقِ المواطنةِ، وتطبيقِ قاعدةِ: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا».
إن الأمن والسلم العالميين يرتبطان ارتباطًا وثيقا بالمؤسسات الدينية، ذلك لأن القائمين على أمر الدين يمكنهم التأثير في ملايين العقول. من هنا نقول إنه على المؤسسات الدينية أن تشارك بشكل فعال في ترسيخ ثقافة السلام العالمى والتعايش مع الآخر وكذلك التأكيد على مبدأ الحوار، وتوضيح حقيقة الخلاف بين أبناء المجتمع الواحد وبين المجتمعات. على أن يكون رجل الدين على معرفة جيدة بالناحية الحضارية والتاريخية والدينية، التي تؤهله للحديث عن الآخر، بل وللحديث مع من يتلقون عنه أمور دينهم.
ولذا يقول فضيلة الإمام، إن "اختلافُ النَّاسِ سُنَّةٌ إلهيَّةٌ يُقرِّرُها القرآنُ في نصوصٍ مُحكَمةٍ، ومُقتضى ذلك أن تجيءَ العَلاقةُ بين المختلِفين متوائمةً ومتَّسِقةً معَ طبيعةِ الاختلافِ والتَّبايُنِ، ولا تُضادُّه ولا تَنقُضُه؛ إذ ليس من المعقولِ ولا من الحِكمةِ في شيءٍ أن يُريدَ اللهُ اختلافَ النَّاسِ ثمَّ يأمرَ بإكراهِ النَّاسِ على ما يَنقُضُ فِطرتَهمُ الَّتي طَبَعَهم عليها، أو يأمرَ بقتالِهم لِيَضطرَّهم إلى الكدحِ إلى ما يُخالِفُ مشيئتَه فيهم".
إن التعايش يتطلب قبول الآخر قبولًا إيجابيًا وليس مجرد إضافة أو مجرد تحمل لهذا الآخر على مضض وإنما يتطلب استدعاء ذلك الآخر، ليكون بمثابة المحاور والشريك في هذا الكون الكبير، الذي يسع الجميع.
وهنا أختم كلامي بما ذكره القس نبيل حداد، حيث قال إن، "كل تعايش يتقدم بوصفه تغاضيًا مؤقتًا عن الاختلاف، ليس تعايشًا خلاقًا لا يسهم في بناء المجتمعات، والتعايش ليس خيارًا بين خيارات يمكن للأحوال السياسية والدينية والحضارية في العالم أن تستقيم بوجوده أو انتفائه، بل هو خيار إلزامي ومعبر ضروري إذا شاءت المجتمعات أن تهزم الكراهية والعنف والموت والحروب والدمار، ففي غياب ثقافة الحوار والتعايش لا ثقافة للسلام ولا أساس فلسفيًا للسلام نفسه".
*الأستاذ بكلية اللغات- جامعة الأزهر