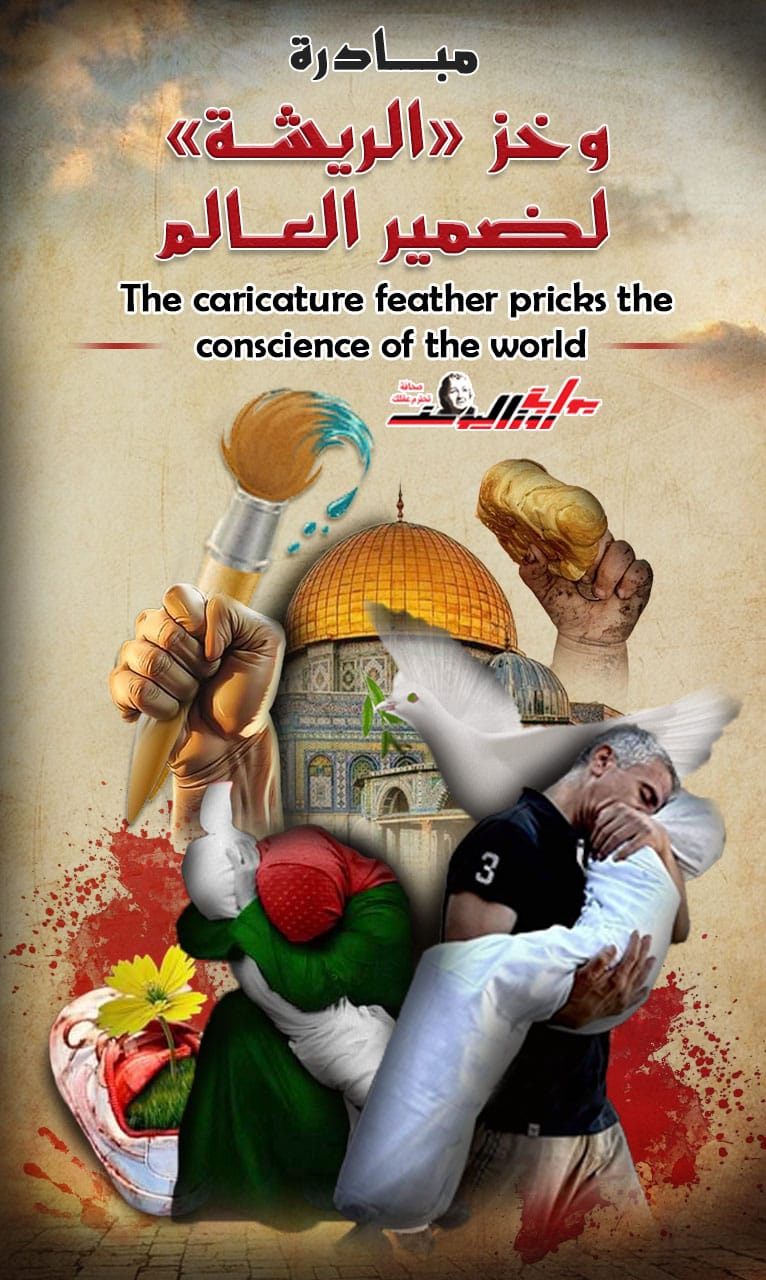محمد عبد السلام
الدواء فيه سُم قاتل
بقلم : محمد عبد السلام
بلغني أيها الملك السعيد، ذو الرأي الرشيد، أنه في أرض غير الأرض، وفي زمان غير هذا الزمان، استاء حاكم البلاد من أمر الرعية، فإنعزل عن الجميع وأغلق علي نفسه باباً، وراح يقرأ تجارب الأولين، بحث بين الصفحات عن حل لإصلاح حال امته، وحينما عجز، إجتمع بالحكماء وأصحاب الشوري، ليطلب منهم المشورة، وفي بهو القصر، وأمام جميع الحشد، صرخ قائلا: بلادنا لازم تقوم، شعبنا يستحق إنه يعيد من تاني عصر الأجداد، حان الوقت لأمتنا إنها تنول حظها من الرقي والتقدم.
"وجدتها.. وجدتها".. شق سكون بهو القصر فجأة صراخ الحاكم، كطفل صغير راح يقفز مصفقاً ومهللاً، لم يجرؤ أي من رجال حكمة علي التلفظ بأي كلمة، فقط تابعوه في صمت حذر، هدأت ثورة الحاكم فجأة كما بدأت فجأة، فقد فطن إلي وقوفه بين قيادات رعيته، فعاد إلي عرشة مطأطئ الرأس خجلاً، جلس فارداً حرملته الخضراء علي كتفية، ثم أشار إليهم وكأنه سُيلقي بياناً عسكرياً.
"أئتوني بخيرة شباب عقول الأمة، سنرسلهم إلي أوروبا وأمريكا للدراسة، ليعودوا إلينا مُحملين بأفكار تعود علينا بالنفع".. تلك كانت قرارات الحاكم، فأسرع رجال قصرة بالبحث في طول البلاد وعرضها، حتي استقر رأيهم علي سبعة من العقول المُضيئة، فأنعم عليهم الحاكم بعطاياه، فكانوا أول من يحمل لقب سفير بين بني جلدتهم، وخارج وطنهم شاهدوا ما لم يكن يخطر لهم علي بال، فأصابتهم النداهة كما تقول الأساطير.
تنقل الشباب السبعة بين كبري العواصم الغربية، من باريس إلي لندن، ثم عبروا المحيط إلي نيويورك، ماذا يمكن أن يفعل الإنتقال من بلد متخلف إلي أضواء المدينة العالمية، فلما وجدوا تلك المفاتن والأشياء الجميلة الرخيصة انغمسوا في الملذات وقصروا في تحصيل العلم ولم ينجحوا, وعندما عادوا إلى وطنهم، قرر الحاكم إعدامهم، فقد أرسلهم في مهمة محددة، ولكنهم نسوها، وانغمسوا في شيء آخر.
في اليوم التالي لعودة الطلاب السبعة إلي وطنهم أقام الحاكم حفلاً كبيراً، وفي الاحتفال راح يسأل كل واحد منهم عن دراسته وكيف سيُساهم في نهضة البلاد، فقال أحدهم أنا تعلـمتُ اللغات الأجنبية، وقال آخـر أما أنا فتعلـمت فنون التشكيل والرسـم، وقال ثالث مُبتهجاً أنا تعلـمتُ الموسيقى، وقال آخـر وأنا تعلمت فنون الإتيكيت والتعامل الراقي ... الخ، فلمْ يجد الإمبراطور في هذه العلوم ما يُمكن أن يُساهم في نهـضة بلاده، فسألهم عن فائدة هذهِ العلوم ومدى حاجة بـلادهم لها، ولم يجـد الجواب الشافي منهم، فأصـدر قراراً يقضي بإعـدامهم جميعاً، فأعـدِموا في نفس الحفلة التي أقيـمت للترحيب بهم، وقـام بعـدها بإرسـال بعثات أخـرى ليتعلموا علوماً بشـرط أنها تفـيد بلاد الشـمس المُـشرقة.
حقاً لا أعلم من اين جاءت تلك القصة، وهل هي قصة واقعية أم مجرد اسطورة يتناقلها الشعب الياباني عن بدايات نهضته في عهد الإمبراطور ميجي الإمبراطور الـ122 لدولة اليابان التقليدية، فطبقا للرواية سالفة الذكر جاءت تلك القرارات ببدء النهضة اليابانية في نهاية القرن التاسع عشر، وتحديدا في العقد الثاني لحكمة الذي امتد لسته عقود، لتبدأ اليابان في صناعة دولتها الحديثة بعد دولة مصر محمد علي بأكثر من سبعون عاماً
المشهد الأول:
(نهار خارجي- أمام مكتب شكاوي الأدوية)
شجار وسباب، عويل نسوة ونحيب أطفال، رجال يدفعن بعضهم البعض، وشيوخ رفعن أيديهم إلي السماء داعين المولي أن يرفع مقته وغضبه عنهم.
علي غير عادتي وقفت علي كورنيش النيل أنظر بعيون فزعة إلي ذلك المشهد المؤلم، فقد إحتشد بضع المئات أمام مكتب الشكاوي باحثين عن الدواء، توافد أغلبهم قبل أن تشرق شمس هذا اليوم، بل أن بعضهم إضطر ليبيت ليلته ليحجز موطئ قدم في طابور لا ينتهي، فشكل ذلك الحشد ازدحاماً كاد يقطع نهر الطريق.
أعترف إنني لم أكن أنتوي الإنضمام إليهم حتي لعمل تحقيق صحفي عن آلامهم، فقد بُح صوتنا كثيراً ولا حياة لمن تنادي، أنين أمي وصراخها تلك الليلة اجبرني علي المجيء بحثاً عن حتي شريط دواء، بأقدام مرتجفة تقدمت من ذلك الحشد، لا أعلم ماذا أفعل وقد إلتفوا حول المكتب التفاف السوار حول المعصم، لم يتركوا منفذاً واحداً يمكنني من التواصل مع أي من مسئوليه.
"كلنا مش لاقين دواء يا بني.. وبنلف كعب دائر من صباحية ربنا علي شريط واحد".. لا أعلم كيف لم ألمح تلك العجوز الجالسة علي صخرة شاردة، ولماذا وجهت لي تلك الكلمات، ومن أين لها أن تعلم إنني أسعي لتخطي الجميع، كلماتها جعلتني اشعر بشيء من الخجل، فإذا كانت أمي تئن ألماً من أجل الدواء، فهناك الملايين أيضاً يحلمون به، فأطرقت برأسي أرضاً، وأطلقت العنان لإبتسامة هادئة، ثم إقتربت منها اشاركها عزلتها بعيداً عن مشاحنه شجاراً يبدوا إنه لن ينتهي.
فوزية جمال، ذلك إسمها، لم تتجاوز الخامسة والأربعين من عمرها، حفر الزمن قساوته علي قسمات وجهها، فجعلها تبدوا وكأنها عجوز تجاوز الستين، بشرتها السمراء منحتها طيبة أهلنا الأولين، اضطرت للسفر من قريتها الصغيرة بمحافظة القليوبية والحضور الي القاهرة مبكرا للوقوف في طابور لا ينتهي بحثاً عن ذاك الدواء، لم اتحدث معها، فقط أطلقت لها العنان لتشكي همومها، تحدثت عن عذابات زوجها المريض، وكيف إنها إضطرت لتركة بمفرده منذ فجر هذا اليوم، مُتجاهله أطفالها الصغار، لتُحضر له دواءً إختفي منذ أمد بعيد.
المشهد الثاني:
(نهار داخلي- إحدي منازل وسط القاهرة)
هدأت السماء بعد يوم عاصف، ألقت الشمس أشعتها في هذا الصباح، عمت السكينة أرجاء المدينة، وخلت شوارع الحي العريق بشرق العاصمة من الناس، لم يعد هناك صوت يعلو فوق صوت طيور خرجت رغم برودة نهاية الخريف تبحث عن الطعام لصغارها...
داخل إحدي شقق البنايات الشاهقة المُطلة علي الشارع الرئيسي، إنطلق المنبه كطلقة نارية يشق فراغ الغرفة، وعلي غير العادة، ودون أن تمتد يد النائم علي الفراش لتطرح ذلك المُزعج أرضاً، تململ الرجل نافضاً عنه إجهاد ليلة إضطر لقضائها أمام الراديو متابعاً لثورة الجزائريين ضد المحتل الفرنسي التي إنقضي علي إشتعالها أيام قليلة.
أزاح الرجل الغطاء عن جسده الضئيل، جلس علي حافة الفراش، استند براحتية علي ركبتيه، أثقل النُعاس جفنيه، فراح يبحث بأطراف أصابع قدمية عن حذائه، وما ان وجده حتي نهض يتلمس طريقة وسط ظلام فرضة عصيان جفنيه الراغبان في العودة إلي الفراش، سار ببطء حتي وصل أخيراً إلي باب دورة المياة، ودون أن يفح عينيه راح يغسل وجهة بالماء البارد، ثم التقط منشفته وأخذ يجفف وجهة، بعناية، رويداً رويداً بدأ في فتح عينيه حتي إعتادت علي ضوء شمس تسللت آشعتها من نوافذ منزله.
جلس الرجل علي أريكته يحتسي قهوة الصباح كعادته، بين يديه إحدي الصحف يطالع ما بها من عناوين عله يخرج بقصة، دون ملل راح يتنقل بين الصفحات بحثاً عنه، إلي أن وجده أخيراً، بريق عينيه وارتعاش يديه ينبئان بذلك، فما يراه يحمل فيه طياته قصة مثيرة، رغم أنه مجرد خبر صغير لا يحمل من تفاصيل أو معلومات يمكنها أن تدل سيناريستياً ومخرجاً عظيماً مثله، ولكنها علي الأقل حملت له طرف خيط ستجعله يخط بيده واحده من أهم أعمال السينما المصرية التي خرجت في منتصف خمسينيات القرن العشرين.
"من حكمدار بوليس العاصمة إلى أحمد إبراهيم القاطن بدير النحاس .. لا تشرب الدواء الذى أرسلت إبنتك فى طلبه.. الدواء فيه سم قاتل.. الدواء فيه سم قاتل.. عند سماعك هذه النشرة بلغ الحكمدارية، وعلى من يعرف أحمد إبراهيم المذكور المبادرة بتحذيره، إذا كان قريباً منه أو إخطار الحكمدارية فوراً"
هل تذكرون تلك العبارات الشهيرة التي تكررت علي لسان أحدهم في واحدة من أروع قصص خمسينيات السينما المصرية، كانت تلك هي الحادثة التي جذبت إنتباه السناريست كمال الشيخ، وشكل حولها فكرة لينقلها إلى الكاتب الراحل على الزرقانى الذى نسج من الفكرة قصة، ثم عاد كمال الشيخ ليُصيغ لها السيناريو والحوار، وبدأ مشاوراته مع المنتجين حتى تحمست الراحلة آسيا للعمل، وبدأ تصوير الفيلم، ليشهد ديسمبر 1954 ميلاده "حياة أو موت".
لم يكن "حياة أو موت" مجرد فيلماً سينمائياً، ولكنه كان حالة تكشف لنا بعد واحد وستون عاماً كيف كان الإنسان المصري يعيش إنساناً في وطنه، يكفي أنه أجبر العالم المحتشد في مهرجان كان السينمائي علي الوقوف إحتراماً وانبهاراً لتحرك الشرطة المصرية وإنقاذها لـ"المواطن أحمد إبراهيم"، التهبت أيدي نجوم هوليود وبوليود وكبار النقاد بالتصفيق تحية للإنسان المصرى الذى يدرك قيمة الحياة، ولإنسانية رجال الشرطة الذين قرروا أن يسخروا كل طاقاتهم لإنقاذ مواطن بسيط.
دعونا نعترف أن الحديث عن "حياة أو موت" اليوم أضحي شيئاً في غاية الأهمية، ففي كل شارع وكل حارة في بلادنا الألاف من هذا المواطن "أحمد إبراهيم"، هذا المواطن لم يعد قادراً علي شراء الدواء، وحتي إن إمتلك ثمنه، فالدواء نفسة لم يعد موجوداً، ولم يكلف حكمدار العاصمة أو أي حكمدارية في ربوع الجمهورية أنفسهم عبء السعي لانقاذ أرواحهم، فأضحي النداء الذي كان منذ ستون عاماً أيقونة الإهتمام بالمواطن يخرج بهذا الشكل "من حكمدار بوليس العاصمة إلى أي أحمد إبراهيم في أي حتة.. إشرب السُم فالدواء لم يعد موجوداً.. عند سماعك هذه النشرة أبلغ الحكمدارية لتوفر لك مكاناً في مقابر الصدقة، وعلى من يعرف هذا الأحمد إبراهيم المذكور المبادرة بنُصحة، إذا كان قريباً منه، أو إخطار الحكمدارية فوراً لتقوم بالازم نيابة عنه"