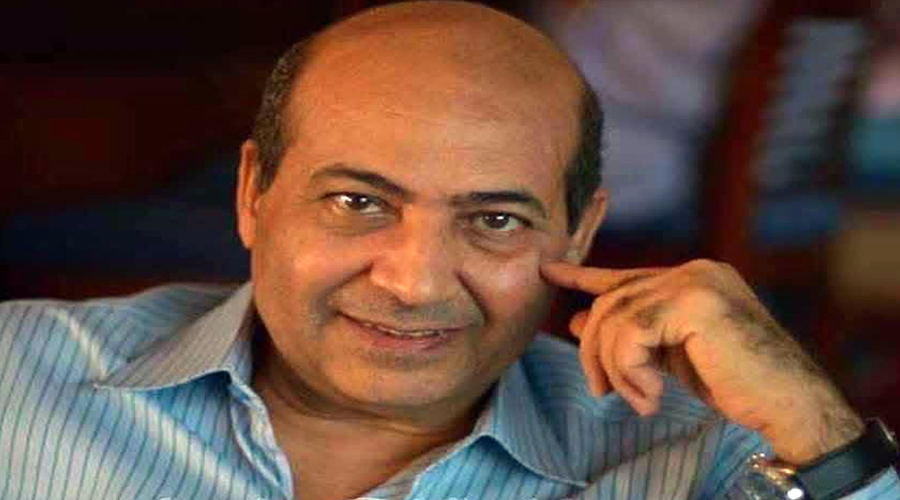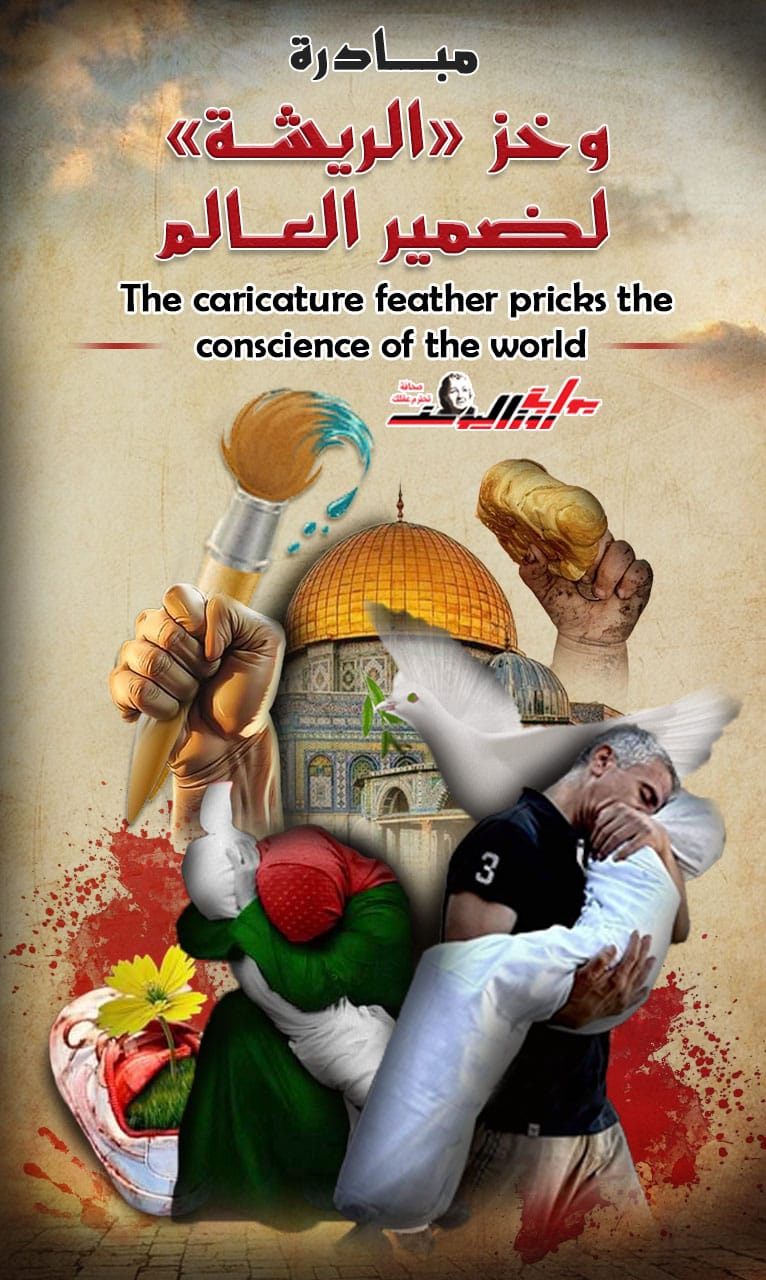السرد متعدد الحركة وتاريخ جيل معاصر في محبة المحبة
قراءة في رواية "الحزن والبهجة" لـ"تامر صلاح الدين"

السرد متعدد الحركة وتاريخ جيل معاصر في محبة المحبة قراءة في رواية "الحزن والبهجة" لـ"تامر صلاح الدين"
أعدت الدراسة: الأديبة منال يوسف
التقدمة التي يدفع بها الكاتب إلى قارئه من قبل أن يخط سطرًا في روايته- ما يطلق عليها عتبات النص- إنما هي نذور وجب على كاتبها الوفاء بها، سواء أكانت تلك النذور كلمات استدعاها الكاتب من نصوص آخرين وذيلها بأسمائهم، أم كلماته نفسه، مرر إلينا بها وعوده بما سوف نستقبله في الصفحات التالية، حين تبدأ الصفحة الأولى من متن النص وحتى نطوي آخر صفحاته عائدين إلى تلك النذور ونحن نقول: لقد وفى كاتبنا الوعد!
العنوان أول النذور (الحزن والبهجة)، وفي التعريف التعين والخصوصية أيضًا، وفي المفرد حميمية اللقاء، يأتي الحزن وحيدًا في مرض قريب أو موت عزيز، يلتصق بالروح ويبقى، تُولَد البهجة في بيوت الأهل، تسري في جنبات البيت، تقفز في قلوب الأولاد وهم يمرحون على السلم، تطل من الهدايا التي يجلبها الأحِبّة، وتضوع من نباتات الشرفة.
في الجزء الأول المُكوّن من تسعة أقسام يمتزج الحزن بالبهجة، لكن البهجة تفرض سطوتها بتفاصيل الطفولة ودفء العائلة، ومرحهم، وعواطفهم النبيلة، ودعمهم الصغار ورعايتهم لهم وتوجيههم، وينتهي بالحزن الذي يأتي بالمرض والفقد، لكن العنوان يأتي مبتدئًا بالحزن، لأن البهجة ابنة اللحظة، أما الحزن باقٍ مستقر"ثم يبقى الحزن، ومفاجأة المفاجأة التي تٌغلّف الوجود في الملمات" ص 89، لذا نجد الراوي يغزل البهجة ذائبة في الأحزان في الجزء الأول من الرواية، بينما الحزن الجائح فيما تبقى من سطور في الجزء الثاني المكون من خمسة أقسام يكتب نفسه ويكتب الراوي أيضًا، يدمغ في تحدٍ سيرة ذاتية جاءت غير مكتملة في اتساقٍ مع تقدمة الكاتب: "الواقع الثري لا يمكن كتابته كاملًا.. يلزمه بعض الخيال؛ ليصدقه الغرباء" هنا لا تجد حياة كاملة من الأحداث؛ لا ذِكر لحياة الراوي في العمل مثلًا، أو علاقاته بالمرأة، حلقات في حياته آثر أن يتخطاها في الحكي، مكتفيًا بذكر العلاقات الأسرية مع الأم والخالات والعمة- ربما لأن الواقع أثرى من أن يسرد كله كما قدم الكاتب، ومن يدري ربما يسردها في رواية أخري قادمة- اكتفى ببعض من سيرة ذاتية مفعمة بالجمال والمحبة التي وعدنا بها في تقدمته الثانية: "نكتب عمن نعرفهم، لنقدم لهم الجمال في أنفسهم، وفي العالم".
فإذا جاءت لوحة الغلاف- كما هو مكتوب- صورة عائلية التقطت عام 1949 فقد لاحت لنا أولى علامات الخصوصية التي تشع دفأً عائليًا في طيات الرواية، تكاد عينيك لا تشبع من تتبع مشاهدها، فإذا كنت في نفس المرحلة العمرية للكاتب أو قريبًا منها؛ سوف تجد تفاصيل عالقة في الروح من شكل البيوت، والأشياء، والعادات، لون الحوائط، والملابس، والسلوكيات. وإذا ما كنت من جيل أكثر حداثة، ستعيش تلك الرواية بكل تفاصيل زمنها، كأنك بينهم تتفقد حياتهم، تتفاعل مع أحداثهم، تتلمس أشياؤهم، تتذوق طعامهم، وتتنفس معهم هواءً ملؤه المحبة والجمال الذي نذرهما الكاتب في مطلع كتابه.
التأريخ حين يكون مبدءًا
لا يخلو عمل من أعمال تامر صلاح الدين من مبدأ التأريخ؛ صدر له من قبل رواية (إمام المرج) زخرت بالمعلومات التاريخية عن فترة هامة من تاريخ مصر ممزوجة بالأحداث الاجتماعية لحياة أسرة، تنبئ عن الحالة الاقتصادية والسياسية في مصر من خلال نسق قصصي طويل تنبت منه تفاصيل ثرية إلى أبعد الحدود.
يرتبط الحدث الخاص غالبًا عند الكاتب بتاريخ محدد لحدث عام يسرده كأنما مصادفة:
1- من خلال صورة العم الوسيم في غرفة نوم الجدة، والذي كان مهندسًا عسكريًا، استشهد عام 1945 عقب الحرب العالمية الثانية "عندما بدأ الجيش المصري في تطهير "العلمين"رغم رفض قوات الحلفاء منْحنا خرائط الألغام، وبسبب الخسائر البشرية الكثيرة، توقفت تلك العمليات" ص10. 2- في حكايته عن العم الفقيه، واستدعاء أمه له وقت مرور الأب بفزعه الليلي المتكرر؛ وفي سياق وصف العم "في سنين فتوته، ألقي القبض عليه مرتين، واحدة بواسطة الإنجليز عندما كان في الرابعة عشرة، بسبب مظاهرة شارك فيها، أو هتف معها، أو تصادف وجوده في الجوار، لا أذكر التفاصيل، لكنه على الأرجح حاول مقاومة المعتدين فكسر ذراعه الأيمن، وبدلًا من علاجه، أجبروه على العمل كأسير، بعد ساعات طويلة، وجده عمي الشهيد في ثكنة إنجليزية في كوم الدكة، يحمل أكياسًا من الرمل ويرصها مع آخرين كمزاغل، الحرب الثانية في أوجها، ومصر محكومة بالدفاع المشترك، والمحتلون مفترض أن يغادروا وفقًا لاتفاقية 36، بملابسه الأميرية أصر أن يفرج عن أخيه وعن سائر المعتقلين" ص85، ثم يحكي بعد ذلك عن إخفائه العجز الدائم الذي أصاب ذراعه اليمنى.
3- يؤرخ لوجود التليفزيون في مصر من خلال شراء الأب له، وكونه بالأبيض والأسود"من المعروف أن التليفزيون المصري بدأ بث في مصر عام 1960 في ذكرى ثورة يوليو" بعد الاعتياد على استعمال الراديو وحضوره في أكثر من موضع ضمن أحداث الرواية" بدأ بث الراديو 1934". 4- انتشار هجرة المسيحيين خارج مصر.
5- بدء وجود فكرة حجاب المرأة، ليس مجرد الحدث، وإنما كيفية التعاطي مع تلك الأفكار من قِبَل النساء باختلاف أعمارهن ومستواهن التعليمي والفكري، ما ينبئ عن نظرة النساء إلى الأمر في تلك الفترة، قناعاتهن أو قدرتهن على تبديل نمط، ربما لم يلتفت بعضهن، ولم يربطنه بالإيمان- ما كان واقعًا بالفعل من قبل الدعوات إلى الحجاب - كما حدث مع الخالات اللواتي كن يصلين ويصُمن ويقمن بكل الشعائر والعبادات، ويمارسن طقوس الدين دونما الالتفات للحجاب، مع الاحتفاظ بكل المثل والقيم العليا{في نهاية السبعينيات ألقي عود ثقاب في أرض جافة، انتشر الحجاب، السيدات في عمر أمي من سكان المدن غطين رءوسهن بطرح متوسطة الطول واحتفظن بالجيبات والفساتين القصيرة، الريفيات اللائي كن يعقصن إيشاربات صغيرة بها شراشيب ملونة، وضعن فوقها طرح كبيرة، كن يزحنها ليدسسن النقود في صدورهن، الشابات اختفين بحجاب ونقاب وإسدال، حتى بنات المدارس الحكومية بدأن في تغطية رءوسهن، نار في هشيم}ص131، نجد أن الشابات الأصغر سنًا هن من تأثرن بالفكرة ومارسنها كما أُريد لها أن تكون، بينما ظلت الخالات بغير حجاب أمام الغرباء{الجارات المسلمات أيضًا تعاملن باعتيادية مع كشاف النور والمياه وبائع أنابيب الغاز، والخضري وبائع الخبز الذي يلبي طلبات البيوت، كأن شيئًا لم يكن} هل رضخن للحالة العامة للمجتمع في شعور بالحرج؟
ثم كيف تم استغلال الدين في السياسة من خلال الحجاب- والذي أصبح من قبل موضة وتوفير نفقات الكوافير والماكياج- كيف تحول الزي من الدين إلى الشعار السياسي؛ حينما تستغله الوهابية ووضعوه على مطبوعاتهم، وجعلوه رمزًا للمرأة الشريفة، وتحولت المرأة التي لا ترتدي الحجاب إلى عاصية أو مسيحية أو كافرة.
ولا يأتي التأريخ عامًا سياسيًا أو اجتماعيًا فقط، بل يأتي أيضًا مغلفًا بالخاص:
1- في حكايته عن العم الذي صمم "وابور جاز" متعدد الرءوس تعلوه طبقات من مواسير المياه التي تمتزج بالماء البارد مباشرة من الخلاط العتيق في"دوش البانيو" الفسيح الذي كان ينفرد به منزل الأسرة "بالطبع في سبعينيات القرن الماضي، كان العالم يعرف سخانات الماء، لكنها بالنسبة إلى طبقتنا كانت رفاهية لا ضرورة لها، ثم أن سخانه هذا كان موجودًا منذ بناء البيت 1951" ص9. 2- وهو يحكي عن تفاصيل موت جدته وعدم إخبار الأسرة لعمته التي هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية 1966"أعد زوجها مُركّبًا لتبييض "الدشت" لإعادة تصنيعه كورق أبيض موفرًا على الدولة مبلغًا كبيرًا..تجاهلوه شهرًا بعد شهر..قدم الاختراع إلى شركة أمريكية، طلبته فورًا فحصل مع زوجته وابنيه التوءم على الإقامة قبل أن يغادروا القاهرة متجهين إلى أوهايوا" ص13، الأمر الذي تكرر مع غيره من العلماء الذين برعوا في الخارج بعد أن أهملتهم الحكومة ولم تهتم لإنجازاتهم التي أرادوا أن يمنحوها لشعبهم في رعاية بلدهم الذي يعيشون فيه!
المفارقة الزمنية والجنوح نحو الاسترجاع:
إذا كان العمل الحكائي ينبني على الزمن باعتباره الهيكل الذي يرتكز عليه، وهناك كما هو الحال زمنًا للقصة "زمن خطي خاضع للترتيب الطبيعي المنطقي، تُقدم فيه الأحداث مرتبة ترتيبًا متتاليًا} فإن كاتبنا هنا اتجه نحو التقنية الحديثة في كتابة الرواية؛ إذ قام بتعديل اتجاه السرد من السرد النمطي الخطي إلى سرد متعدد الحركة نحو الأمام والخلف؛ ما يدعى: الاستباق والاسترجاع، حيث تحدث المفارقة الزمنية، ما يعني أن ترتيب الزمن في الحكي ترتيب زائف-بحسب جيرار جنيت-حيث يقوم السارد بترتيب السرد في غير تتابع الأحداث في المادة الحكائية، ويلجأ تامر صلاح الدين في روايته: الحزن والبهجة إلى تلك التقنية، بدأً من أول سطر في الرواية، يمكننا تلمس زمن الحكي في الرواية بالتقدم في قراءتها؛ فلا بد أن السارد قد تخطَّى الأربعين من العمر، وماتت أمه، ها هو الآن يفكر في حياته، يزن الأمور، ويبحث في منطق حياته والآخرين{تحدثني الأشياء؛ لتكشف لي حقيقة وجودي، أعيش في عالم لم أصنعه، ولم أضف إليه، أدوات المائدة، الطاولات المنزلية، الأرائك، الشراشف، المناشف، درجات السلم، الألوان وتلك الجدران التي تأويني، لغتي وهويتي، ديني وعقيدتي، اسمي ورسمي وملء قلبي، ومشاعري ذاتها، صممها لي آخرون} ويقول: "كل ما حدث أنني انتقيت من جملة مواد ومفردات ومصنوعات ونماذج وجدتُها في طريقي، وُضعت هاهنا من أجلي ومن أجل الآخرين، الذين لم يختاروا هم أيضًا بل انتقوا فحسب" ص147: 1- لكنه يبدأ الحكي بـ"استباق" حين يقول في أول سطر من الرواية: "منذ توفى والدي في لحظة غائمة من يوم 4 فبراير 1984 اعتدت التسلل ليلًا إلى غرفتها" ص7- يعني هنا غرفة الأم.
ثم ينطلق بالحكي عن علاقته وإخوته بأمه في طفولتهم؛ تربيتها لهم، المبادئ التي أسست عليها علاقتها بهم وبالله وبالمجتمع ، وحتى بأنفسهم، العادات الحسنة التي وضعت بذرتها فيهم ورعتها، مجابهة الشيطان بالحيلة "لكنها بدأب لا ينقطع، تأمرني بالصلاة، أتحجج بقصر سروالي، تؤكد: لا بأس؛ صلِ اليوم بهذا، وغدًا جهّز آخر" ص8، تطمئنه حين يفزع من الأحلام الجميلة المليئة بالفراشات، تحتضنه{نصحتني أن أستمتع باللحظة إذا تكررت}ص12، احتوائها لأخطائه؛ هي التي نصحته بعدم تناول "المرتاديلا" طعام زميله المسيحي في المدرسة، لكنه فعلها مرة وأخبرها حين شعر بوخز ضميره “ربتت كتفي مشددة: لا تعاود” ص 39، تسامحها والأب مع المختلفين في الديانة "ساعتها أوضحا؛ أن الدين لله وأننا لا نملك من أمرنا شيئًا" ص 26.
تتنامى الأحداث من الطفولة إلى الشباب في ظل عائلة تسري في عروقها المحبة، ويشارك كل فرد فيها في تربية الصغار ودعمهم، العم الفقيه، الخالة التي تهتم بتقديم النصح والأكلات الصحية، الخال الذي يصاحب الصغار ويمنحهم خبرته واهتمامه وحبه وهداياه وصداقته، كثير من أحداث العائلة برؤية السارد العليم، المشارك، ورحلة من التفاصيل الجميلة الممتلئة بالحزن والبهجة.
2- حتى مرض الأم، وهنا يتدخل السارد لاجئًا إلى تقنية الاسترجاع الداخلي (يستدعي أحداثًا سابقة يكمل بها الفراغات في النص لتكتمل الصورة، وتقع تلك الأحداث داخل زمن الحكي) فيعود لاستذكار طفولته مع أمه: "كل التفاصيل الدقيقة التي نعمت بها والدتي أراها رأي العين، واضحة جلية، بالنسبة إليّ لم ترحل، بل أشرقت.. أتبعها صغيرًا إلى بيت جدتي،..... إلخ" ص 130.
3- يرى جاستون باشلار: "أن الذاكرة لا تعمل دون استناد جدلي إلى الحاضر.. فهي تعيد وضع الفراغ في الأزمنة غير الفاعلة .. إننا حين نتذكر بلا انقطاع إنما نخلط الزمان غير المجدي بالزمن الذي أفاد وأعطى" وهنا يلجأ الكاتب أيضًا إلى الاسترجاع الخارجي(يستدعي أحداثًا ما قبل زمن الحكي) ومن ثم تنوير اللحظة الحاضرة، حكايات يكمل بها الصورة من خارج زمن السرد.؛ يحكي عن شباب العم، استشهاد العم الآخر 1945، حكاية العمة التي سافرت 1966 وتفاصيلها، عن الجد-من حكايات الجدة وهي على فراش المرض- نقاش الأويما، ذي الشخصية المتفردة، الحنون، صاحب المال الوفير والمبادئ النبيلة: "أختك تعطيها ولا تأخذ منها" وحين أحضر ابنه إناء الورد من الحديقة العامة، قال له: "لقد سرقتني وسرقت البلد، اذهب وارجعها مكانها" ص 75، لذا كان حريًا بالسارد أن يقول: "عندما رحل ترك قطع من الموبيليا النفيسة واثنين من الجرامافون وسيرة بيضاء تتبعتنا حتى مشينا".
في مفارقات زمنية بين الاسترجاع الداخلي والخارجي، الاستباق والتداعي، تفاصيل الحياة في تلك الحقبة من الزمن، تفاصيل دقيقة؛ أكثرها جميلًا، وبعضها يقبع مطمئنًا تحت مطرقة الواقعية القذرة؛ حين يحكي عن بعض تصرفات الأولاد، القميئة التي تستدعي القئ، أو لفظ يصدر عن شخصية ما هنا أو هناك، مدفوعًا "أي السارد" برغبته في تبيان صورة كاملة عن الشخصية أو الأحداث، مأخوذًا-كما أظن- بسحر البوح.
اللغة ورهان المفارقة الخطرة في جمع الشاعرية مع مفردات الواقع اليومي الشعبي: يقف الكاتب ثابتًا بين جناحي الشاعرية في اللغة والعامية اليومية بمفرداتها المستخدمة في التعبير عن الأشياء، كل في موضعه:
حين يكون الحديث عن الذات وشعورها نحو الأب، الأم، الزملاء، الأسرة من الجدة والخالات والأعمام تكون اللغة الشاعرية الشفيفة سيدة التعبير:
1- "في غرفتها يوجد عش أبي وأمي وفراشهما الوثير بألحفته وملاءاته الكثيرة الحريرية والقطنية بألوانها الصافية الحضنية" ص 15-في وصف حجرة الوالدين.
2- "أشتم رائحة النجيل والرمل والممرات وقد تشبعت بهواء الشتاء النقي وأمطاره السكندرية الخاصة والخالصة، أشتاق كأنني مقبل على الفردوس إلى أكف زميلاتي وزملائي في الفناء بألواننا الزرقاء الصوفية المميزة وتلك الأحذية "الفرنييه" اللماعة المستديرة التي تبرز منها سيقان الفتيات بجواربهن البيضاء جدًا والتي تتأرجح على بعضها كرات من القطن الملون" ص 23- في استرجاع ذكريات الطفولة في المدرسة.
3- "أنظر فأراها بفستانها الملون القصير وبلوزتها الناصعة التي تستر ذراعيها، تمر من بين شعاع الشمس فيلتمع شعرها الكستنائي الناعم براقًا بألوان كثيرة كريش رقبة ديك جميل" ص130- صورة الأم وقت الطفولة.
4- "لو كنت خُيرت لاخترت أن أكون قطرة في سحابة، تجوب العالم وترى الدنيا، تلامس قمم الجبال وتتجول في الفضاء، تناجي السماء وجهًا لوجه، وتسقط وقتما تحب، ترطب وتثمر وتتغلغل في أعماق الأرض، قبل أن يأخذها التيار إلى مكان آخر، تتحول من سائل إلى جماد ومنه إلى بخار، يصعد مرات بعد مرات، يعرف قصة البدء ويتخيل شكل الختام، خلود فاعل، منذ اللحظة الأولى وحتى إسدال الستار على العالم" ص 148- آثر الكاتب أن ينهي روايته بتلك اللغة التي تنتج صورًا شاعرية، كأنما هي جمل موسيقية في معزوفة سرمدية تعلو وتهبط، لكنها أبدًا لا تصل.
وحين يكون الحديث عن أفراد العائلة من الرجال المؤثرين، تحضر لغة وحشية؛ تتناسب تمامًا وحِدّية الصفات الشخصية لهم: "يأتيه مشايخ وجيران ومعارف ولا معارف لينهلوا من استقامته الفجة، وعدله النابي" ص8- في وصفه للعم الذي لديه إجابات عن كل ما يتعلق بالشرع والشريعة في ذات الوقت الذي لم يفرض على أي من الأطفال أي شيء.
ويستعمل الكاتب اللغة هنا استعمالًا خاصُا يخرج بها عن المألوف؛ ما يسمى بـ"الانزياح"، يصف المحسوس أو المسموع بالمرئي والعكس، يمزج الحواس في مجازات مدهشة، في مواضع عدة تأخذ بالقارئ إلى عمق المشهد، يكاد أن يرى نفسه مشاركًا فيه:
1- في تراسل الحواس يصف الهمس بالأسود في حالة مرض الأب "تقشف البيت وظلله همس أسود". 2- وفي عزف الأب على الكمان من دون مهارة "يعزف صولو غير مهندم". 3- وفي وصف الموبيليا في البيت "الموبيليا سلسة القسمات" وهي موبيليا ذات طابع فرنسي رقيق وراقٍ، كانت أحد العناصر التي تأثر بها النجار المصري في ذلك الوقت الذي زامن المَلَكِية والاحتلال الفرنسي، وكان للمثاقفة دورها في الحياة المصرية، ومنها ملابس المرأة على وجه الخصوص، الموضة والأزياء. 4- في وصف زميله بطرس الأبيض جدًا "محبته مغلفة بشمع النذور".
5- في وصف الخيالين والجمالين في الأهرامات الذي يجيد الأب التحدث إليهم بلهجتهم "كانوا بسمارهم الغويط الماكر".
6- في وصف إحدى زميلاته الذي بدأ في الانجذاب إليهن في بداية مرحلة المراهقة على اختلافهن،مع اتفاقهن في شيء واحد، هو الأنوثة المميزة، حتى لو كانت الفتاة جورجيت بـ"مغناطيسيتها المتسخة". عن المشاعر التي لا يظهرها الأب على الدوام، الأب الذي يجب استدعاء ذكراه، الحاضر في مكان ما غير مرئي، المعترف بوجوده كظل كبير محسوس لا ملموس- بحسب تعبير الكاتب- ينشغل بالعمل من أجل تأمين الحياة، لكنه يمرر لأبنائه وجبة ساخنة جاهزة من دون أن يطلبوا ويعود سريعًا إلى العمل، ويحمل في قلبه أضعافًا ربما لا تظهر، يبني شخصية ابنه ويفرض له مكانة بطريقته في التعامل معه أمام الغرباء{كنت أسترجعه لا ليقف إلى جواري ويعضدني، بل لأنه رحل مبكرًا، وحتى اليوم لا أشعر بالاكتفاء منه، نصائحه في القتال والمواجهة، والسخرية والتصرف، والدبلوماسية، والمجاملات البسيطة والطيبة، معاونة الباعة الجائلين وهو بكامل حلته وأناقته عندما تعلق دواليب عرباتهم في عثرة ما}ص44، يمد يده في الوقت المناسب تمامًا "وجدته بجسده القوي قد حملني على ذراعه ومنحني قبلة حياة على خدي أشعر بها وأراها دائمًا كحَسَنة على الأنف" في لحظة فارقة لطفله، ويظهر عاطفة لا تعدو حضن أو قبلة، يبقى أثرها كوشم لا يغيب، يضعها الراوي هنا موضع "الحَسَنَة" الجميلة التي تبقى ما بقيت حياة صاحبها(حسنة غير مرئية!).
أظهر الكاتب اختلاف دور كل من الأب والأم،الأم التي علمت أبناءها القراءة، وتركت لهم حرية اختيار القصص صغارًا، اشترت المجموعات القصصية ودفعتها لهم ليتثقفوا في سن مبكرة، شاركت الأب في ترسيخ روح التسامح، تحملت غيابه ومرضه، وبعد وفاته شمرت عن ساعديها وقلبها وتحملت المسؤولية بكل شجاعة ونبل، ثم إذا حان مرضها، جاء السارد؛ هذا الذي شارك الأبوان في تهيئته ليكون تلك النفس شفيف الروح الذي يستشعر الأحداث وتخايله أرواح الأحبة الراحلين، جاء يجلد ذاته بأن مرض الأم لم يكن الزهايمر-على الرغم أن الأمر مُسلم به بالاستناد إلى الأطباء والتشخيص والعلاجات-بل الاكتئاب لانفضاض كل تلك البهجة التي أحاطت بها مع كل ما فيها من أحزان ومصاعب، لكنها بهجة وجود الأبناء ودفء قربهم، يتساءل في أسى: لماذا لم يكتشف الطبيب هذا الأمر؟ لماذا لم يصف الطبيب ذاك الدواء؟ كأنما شيء ما كان ليتغير! لكنها كما ذكر في سطور الرواية الأخيرة رحلة لا اختيار حقيقي فيها-وأخص أنا: في المرض والموت.
ويمكننا أن نشعر من الحكي أن أفراد العائلة هم هكذا أيضًا يشبهون موبيلياتهم؛ طيبون، متعاونون، مطبوعون بالمحبة، لينوا الطبع مع الاحتفاظ بعراقة الأصل؛ الخالات يرصصن أحذيتهن "كقطع الحلوى في فتارين المخابز الكبرى" ويتعاملن برقي فيما بينهن، وما بينهن والأخريات من خارج الأسرة، يهتممن بنظافة الصغار، يقدمن لهم الطعام والوقت والمحبة ومبادئ السلوكيات القويمة.
اختار الكاتب اللغة العامية المتداولة في التعبير عن الأفعال والأشياء كما هي في بيئتها الواقعية، عارية من أي محاولة لفرض مفردات موازية تؤدي المعنى، متسقة ومنسجمة مع عادات وأفعال أصحابها، وضعها بين علامتي تنصيص؛ "الطبلية"، البلاط "الرزي" كما كانوا يسمون اللون الأبيض حين يختلط بالأسود؛ تلك البلاطة الشهيرة في ذاك الوقت في كل البيوت المصرية البسيطة، "البيجامة الكستور"وكان الشعب كله يرتديها حين كانت الحكومة المصرية تصرفها بسعر زهيد من إنتاج المصانع المحلية، "أبلة" اللفظ المتداول الاستخدام في مخاطبة المعلمة، "التختة"المنضدة التي يجلس إليها الطلبة في الفصول، "ماء الغليّة"الماء الذي تم غلي الملابس به عند غسيلها وقت كانت النساء يغلسن الملابس يدويًا فيقمن بغليها أولًا للحصول على نظافة جيدة، "عين الكانيف"الفتحة في أرض الحمام كانت تستخدم للتغوط قبل التطور وصناعة الحمامات في شكلها الحالي، "شلاضيمه"،"البسطة"، "فَقَعَه بالروسية" أي ضربه في رأسه برأسه،.... إلخ، ما يزيد عن ثلاثين وأكثر من تلك المفردات والتعابير تأخذ مكانها في ثقة جنبًا إلى جنب مع اللغة الشاعرة والصور الرقيقة حد الشفافية.
وحين كان يمكنه أن يحولها إلى مفردات لغوية بالفصحى بسهولة، لكنه آثر أن يبني بها إلى جانب اللغة الشاعرية ذلك الطريق الذي لم ينفصل أبدًا في أحداث روايته؛ حيث امتزجت التربية الأصولية في مدرسة"سانت جوزيف" وفي البيت أيضًا مع الأم المتعلمة الموظفة، بالعادات المصرية في الشوارع الشعبية، والمدارس الخاصة نصف الشعبية، تربية الحمام في بلكونة المنزل إلى جانب لوحة الكانفاه العارية الشهيرة في حجرة النوم، العم الفتوة القوي الذي أسس إذاعة أهلية مع صديقه يبثان منها الأغاني، ثم يخرجان فـ"يحطمان المقاهي". اللياقة في الحكي حين لا ينسى أن يبدأ بـ{زميلاتي} قبل {زملائي} في حديثه الشاعري وقت استذكاره أيام الطفولة، إلى جانب الواقعية التي تقترب من الفجاجة في بعض المفردات المتداولة في البيئة الشعبية، لا يطغى استخدام أي صورة من اللغة على صورتها الأخرى، ولكن يعملان معًا على بناء عملًا واقعيًا، يزهو كاتبه بأرستقراطية لا تخجل من حضور شعبي متغلغل في عمق الشخوص والأماكن والأشياء... واللغة أيضًا.
جنبًا إلى جنب،"للمبة السهاري"للإضاءة حين انقطاع التيار الكهربائي، "وابور الجاز" لطهي الطعام والأعمال التي تحتاج إلى وقود؛ مع العربات الـ"كابراس كلاسيك""المرسيدس""البيجو"، تجوُل الأب في عزب الصعايدة في محرم بك وكرموس؛ مع ارتباطه بالـ"جريج" الذين كانوا يشكلون أكبر مواطني المدينة من الجاليات، تناول الطعام على الطبلية من طبق واحد والأطعمة الشعبية المتداولة "السخينة"،"لقمة القاضي"،"العصيدة" وغيرها ؛ مع عزومات الخال في سانتا لوتشيا وغيرها من الأماكن الراقية. جنبًا إلى جنب، ماري، الراهبة المُعلمة ونصائحها في الرسم وإضافة "البانتير" إلى لوحة الطفل، مع "أبلة تفيدة" في مدرسة جرين وسلوكيات الأولاد - بما فيهم السارد نفسه- المشاغِبة التي تؤدي أحيانًا إلى التعرض للأذى وإخفاؤه عن الأهل. الثقافة والحرص على تصفح الجرائد مع تكليف البائع بإحضارها يوميًا كجزء أساسي من نفقات البيت، مع الاعتقاد بالعفاريت وأعمال السحر؛ مع مجلات "البوردا" وخيوط الكانفاه، والخالة التي تشرح اللحن والسلم الموسيقي وطريقة مزج الألوان للرسم.
جنبًا إلى جنب، الثلاجة الإيديال عالية الصوت، مع الملابس ذات الماركات العالمية، الساعات والولاعات الأصلية، أنواع العطور الفرنسية والسجائر المستوردة، والحذاء الـ"بالص" والجاكت ذي الفراء كـ"رجل مالربورو".
جنبًا إلى جنب، تلك الحالة من التشكك في الآخر المختلف دينيًا، كأن يصرخ أحدهم: تلك الشيكولاتة المُهداة مُسْكِرة، أو: ابصق على الصليب؛ مع تقبُّل الحلوى المرسلة إليهم في المناسبات المسيحية من مدرسة سانت جوزيف خصيصي إلى أهل البيت الذي لم يمكث أطفاله بها سوى عامين.
تلك المفارقات التي جعلت من بطل الرواية، السارد، المشارك، شخصية ثرية، في لفتة استطاع الكاتب أن يقتنصها في التأثير على نفسية الطفل وتفاعله مع الأشياء من حوله، شعوره بالخوف والوحدة حين تأخر الأب في الحضور إلى مدرسة سانت جوزيف لاصطحابه، بينما انصرف أغلب زملاؤه، يقول:"نظرت إلى السيد المسيح، اكتشفت أنهم جددوا الألوان، أو استبدلوا التمثال بآخر لا يشع بذلك التسامح القديم، انحناءاته مبالغ فيها ويحدق إليّ بعين صفراء، كملابسه غير المهندمة، جزعت وشرعت في البكاء" ص22، لكنه لم ينس أبدًا في استرجاعاته ابتسامة مريم في سانت جوزيف "العريضة تطل علينا بمحبة وتواضع بالغين".
وبعد.. صدرت الرواية عن دار روافد للدراسات الثقافية والنشر فى 157 صفحة من القطع الصغير، وفيها استطاع الكاتب بكل تلك التفاصيل التي جاءت مُحكَمة في بنية زمنية سردية شيقة، أن يشغل القارئ عن الفراغات في سيرة ذاتية آثر المؤلف ألا يقترب منها.
نذر الرواية للمحبة ووفىَّ الوعد.