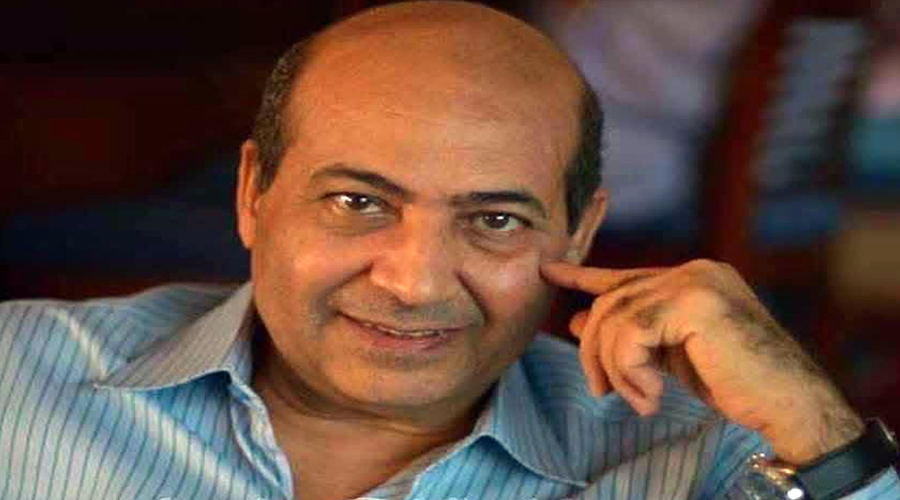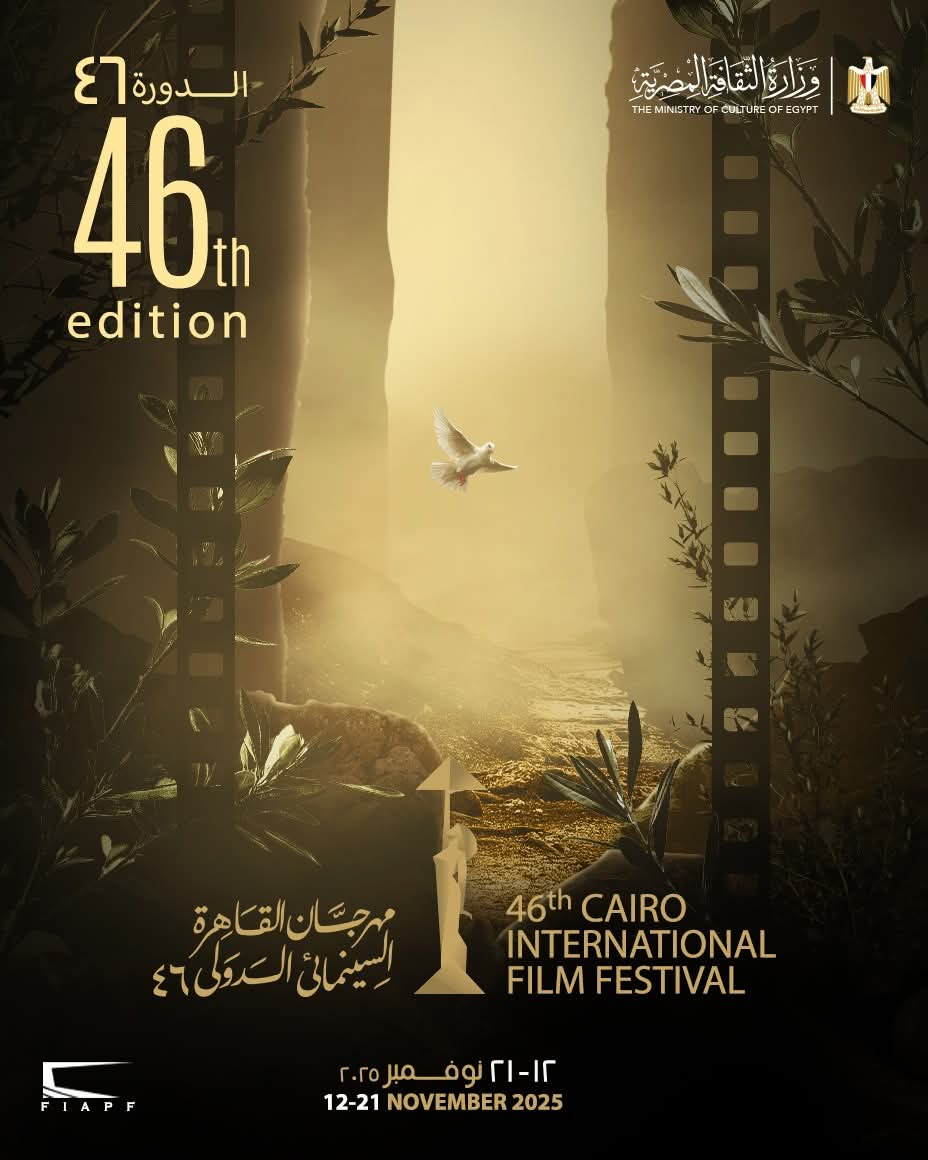شنقيط وغرائب عادات المواريث

فاطمة زيدان
تُعد مدينة شنقيط من أبرز المراكز العلمية والثقافية في الغرب الإسلامي، والتي شكلت منذ نشأتها محورًا لحركة علمية نشطة اتسمت بانتقال المعارف وتراكمها عبر الأجيال. تميزت هذه المدينة الواقعة في شمال موريتانيا بدورها في رسم ملامح الهوية الثقافية والدينية للمنطقة، وبروز نخبة علمية عرفت بـ"الشناقطة"، الذين حملوا اسمها في ترحالهم العلمي خارج حدودها.
وفي سياق هذه المكانة العلمية، ظهرت مجموعة من العادات الاجتماعية الفريدة، من أبرزها توريث الكتب والمخطوطات ضمن التركة الأسرية، وهو تقليد نادر في المجتمعات الإسلامية، يعكس المكانة الكبيرة التي يحتلها العلم في فكر المجتمع الشنقيطي وحياته اليومية. نسعى في هذا المقال إلى تسليط الضوء على ظاهرة توريث المكتبات الخاصة في بلاد شنقيط، من حيث الجذور الثقافية، محاولين تفسير مكانة الكتاب في منظومة الإرث لديهم.
عرفت موريتانيا منذ القرن الثامن عشر باسم "بلاد شنقيط"، نسبة إلى المدينة التاريخية التي تأسست سنة 800هـ/1397م، وكانت محطة رئيسية لقوافل الحجاج القادمين من غرب أفريقيا. وقد اكتسبت هذه المدينة مكانة علمية استثنائية، فانتشر منها العلماء، وارتبطت تسميتهم بها، حتى صار لقب "الشنقيطي" دالًا على التبحر في العلوم الإسلامية واللغوية. وتعددت الآراء حول أصل التسمية، حيث يرى بعض الباحثين أن الكلمة ذات أصل بربري صنهاجي وتعني "عيون الخيل"، بينما يرجّح آخرون الأصل العربي المركب من "سن قيط"، بمعنى طرف جبل قيط القريب من المدينة.
إلى جانب تسمية شنقيط، عُرفت البلاد تاريخيًا بعدة أسماء، منها "بلاد المغافرة" نسبة إلى القبائل المغفرية، و"أرض البيظان" كما وردت في الوثائق الفرنسية، و"بلاد المليون شاعر" في الأدبيات العربية الحديثة، وصولًا إلى اسم "موريتانيا" الذي تبنته الإدارة الاستعمارية الفرنسية رسميًا في منتصف القرن التاسع عشر..
لقد وضعت المكتبات الخاصة ضمن قسمة التركة، فكانت توزع بين الأبناء بحسب قيمتها، وربما تخصص للعالم الأبرز في الأسرة، أو توقف لصالح طلبة العلم. وتنوعت محتويات هذه المكتبات بين الفقه، والتفسير، والحديث، والعقود، والأنساب، واللغة، والطب، وعلوم الفلك، وغيرها من المعارف، مما جعل منها سجلات ثقافية واجتماعية واقتصادية متكاملة.
وقد اتخذ الشناقطة إجراءات دقيقة للحفاظ عليها، فوضعت في صناديق خشبية أو جلدية، وأغلقت بأقفال، وأحيانًا دفنت داخل جدران البيوت الطينية لحمايتها من السرقة أو التلف.
وقد كشفت الدراسات الحديثة أن هذه المكتبات لم تكن مجرد مجموعات كتب، بل تشكلت من خلال التوريث العائلي على مدى قرنين أو أكثر، مما جعلها امتدادًا معرفيًا متجذرًا في الوعي المجتمعي. ففي مدينة شنقيط وحدها، ُجدت مكتبات تضم آلاف المخطوطات، منها ما يعود إلى القرن الرابع عشر، وظلت العائلات تحرص على توريثها كما تورث الأملاك، بل رفض بعضها عرض بيعها حتى من قبل مؤسسات رسمية، باعتبارها جزءًا من الهوية لا من الملكية.
وقد كانت أغلب المكتبات التقليدية في شنقيط ونظيرتها "أولاته" تكونت عبر التوريث، وصارت تمثل رصيدًا معرفيًا متراكبًا من إنتاج الأسرة العلمية الواحدة. وفي شهادة محلية نُقلت عن أحد حراس هذه المكتبات، قيل: "لا تستطيع الدولة أن تفرض يدها عليها — فهي جزء من كياننا"، وهي عبارة تختزل تصور الشناقطة لكتابهم باعتباره امتدادًا روحيًا وسندًا شرعيًا لا يجوز التفريط فيه.
وبهذا فإن عادة توريث الكتب في بلاد شنقيط ليست ظاهرة هامشية، بل تعبير عن نسق ثقافي متكامل، يرى في العلم أصلًا من أصول الاجتماع، وفي المعرفة ضمانًا للاستمرار. لقد ورث الشناقطة أبناءهم ما يحفظ العقول لا البطون، وما يبقى بعد المال، فحفظوا به ذاكرتهم، وساهموا في استمرارهم الحضاري في وجه التحولات والمتغيرات.
نستشف مما سبق أن، في معظم المجتمعات، يترسخ في الأذهان أن التركة تعني ذهبًا أو عقارًا أو مالًا، وأن نفع الميراث فهو مرهون بما يُعين على الحياة اليومية ويؤمن المستقبل. وهذا تصور صحيح لا ينتقص من قيمة المال، فالناس محقون في حرصهم على الميراث المالي، لما له من أثر ملموس وسريع الأثر.
لكن في بلاد شنقيط، حيث تنعقد الصلات بين القلم والكرامة، وبين الورق والهوية، سادت فلسفة أخرى: أن العلم هو الميراث الأبقى، والنفع الحقيقي لا يقاس بالعملة، بل بما يبقى بعد فناء المال.
فلم تكن المكتبات تُهدى، بل تُورث، ولم تكن المخطوطات تُباع، بل تصان كالجواهر النفيسة.ورأى الشناقطة أن الكتب أنفع للورثة من المال، لأنها تحفظ القيمة وترتقي بالنفس، وتورث العز والمعرفة.
باحثة دكتوراة في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية