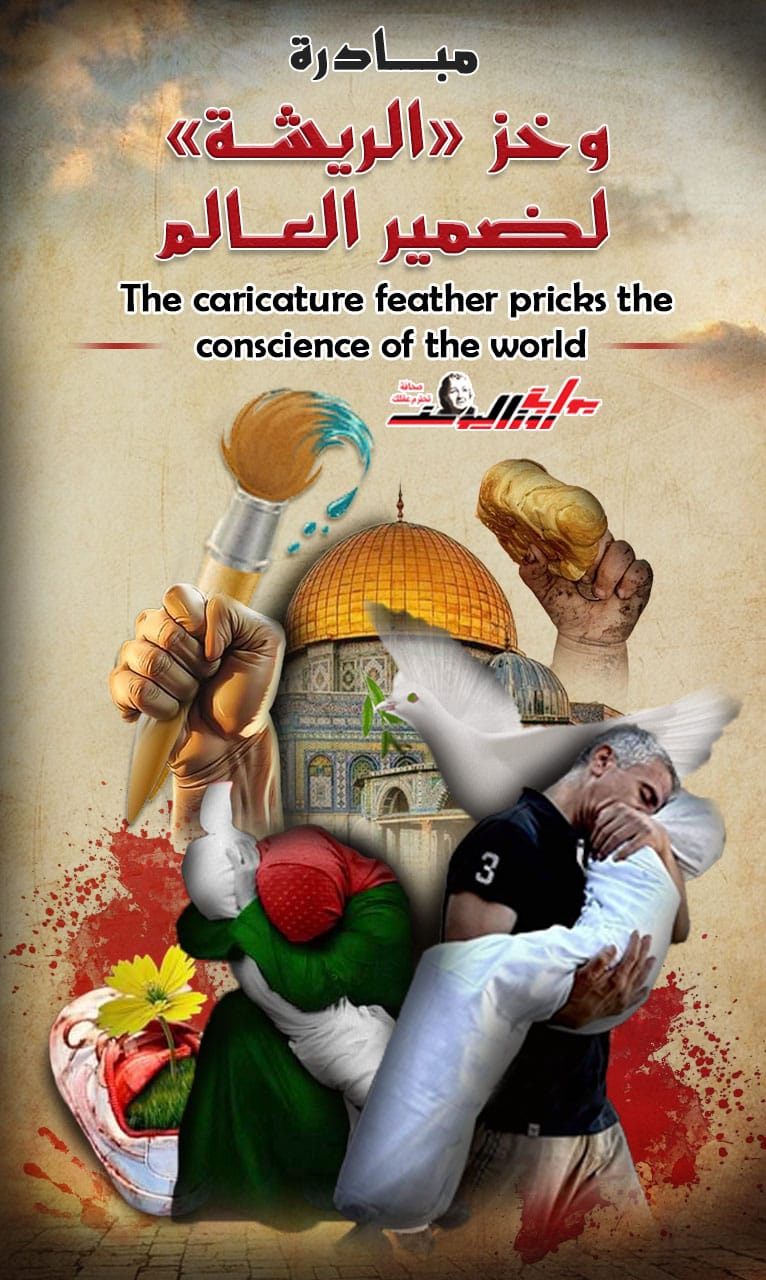الرسام وصائغ الكلام

مودى حكيم
إذا كان بوسعك أن تحب ، ففي وسعك أن تفعل أي شيء، فالحب هو قوة غير محدودة تستطيع أن تغير العالم الذي في داخلك”.
وكان أنطون بافلوفيتش تشيخوف على صواب. فالحب يأخذك إلى مطارح تكتشفها في نفسك، ما كنت تعرفها قبل أن يستولي عليك ويحتويك، ويكون عندها الإبداع، فلا يذوي خاطر في خيال فنان، ولا كلمة على رأس قلم كاتب.
الوجوه المختبئة في الزمان الذي مضى، تأتي إلى ذهني. مع كرت السنين ما محا فؤادي ذكراهم، وما غابت قصص عشقهم، التي فجرت إبداعهم، فذابوا، وأذابوا، وأعطوا نتاجًا على القماش والحجر والورق ، تصافح مع الزمان وبقي عصيا على النسيان يمارس سطوة على الأدب والفن في العالم العربي وما بعده…
كان يوسف فرنسيس، بعد تخرجه سنة ١٩٥٧ من كلية الفنون الجميلة معيدًا فيها عندما كنت طالبا، فأصبح صديقًا صفيا عندي، إكتسبت منه ما أسعفني في المهنة بعد تخرجي.
ويوسف فرنسيس، لمن لا يعرف، رسام تشكيلي، حمل لوحاته إلى معارض في بولنداوفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ولبنان … ولوحاته على حيطان “متحف الفن الحديث “ في القاهرة، و”متحف الفنون الجميلة” في الإسكندرية. مر يوسف فرنسيسعلي “ صباح الخير “ وترك علي صفحاتها رسومات ولا أحلي.
شغف بالفن السابع، فدرسه ونال ديبلوما فيه وفي فن كتابة السيناريو. بعدها أعطى السينما العديد من الأفلام التي شكلت علامات فارقة مميزة ومتميزة في السينما المصرية، ككاتب سيناريو ومخرج.
ذات يوم، قدمني يوسف فرنسيس إلى نسيم هنري حنين،وكان يدرس الهندسة المعمارية، وشقيقه الأكبر منه سنا صموئيل، الذي كان سبقنا وتخرج من قسم النحت. والأخوان حنين من “أسيوط”، ولدا في كنف عائلة توارثت حرفة صياغة الذهب كابرا عن كابر.
لقد شدني صموئيل،عرف في ما بعد باسم آدم، بجميل خصاله، وعمق مبادئه، على رصانة في التفكير، يخضع له التعبير إن حادثك خضوعًا غريبًا، فتوطدت الأواصر بيننا، حتى عندما غادر مصر مع زوجته للسكنى في فرنسا حيث بقي فيها زهاء ٢٥سنة، فكنت ألتقيهما أثناء اقامتي في غربتي الثانية في العاصمة البريطانية، في عطلة نهاية الأسبوع في منزلهما قرب Port de Sèvres .
ومن أحلي الاوقات التي أمضيتها في باريس، كانت في منزل يوسف فرنسيس وزوجته الثانية الكاتبة مني سراج، فكنا، الفنان جورج البهجوري والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي وأنا، وعدد من المصريين المقيمين في العاصمة الفرنسية، ونزل الفن والأدب والشعرعلي الكلام، الذي لا يحلو إلا في ليل باريس.
من « أسيوط » إلى « باب الشعرية »،كانت رحلة عمر صموئيل حنينبعد تخرجه، أمضى سنوات في « مرسم الأقصر »، غادر بعدها إلى ميونخ حيث أكمل دراساته الفنية وتفتح ذهنه على فنون الآخرين، وعاد للقاهرة ليزين بريشته صفحات “ الصبوحة “ برسوماته المتميزة. وحظي بها صلاح جاهين في رباعيته. ومن الصلصال إلى ورق البردي ، نحت ورسم، وكان يركب الألوان بنفسه من ما توفره الطبيعة، وبعيدا عن زيف التصنيع المتعارف عليه في الألوان والأصباغ، فيمزج الجير، والحديد،والمنجنيز، والكروم، ثم يخلط الكل بالصمغ العربي…وتلك خامات مصرية قديمة إستعملها السابقون من المصريين في كتاباتهم ورسوماتهم.
إقترب صموئيل حنين من قسطنطين برانكوزي، وهنري مور،وأرتولد مارتيني، وجياكومتي، وهؤلاء شكلوا النحت الحديث. أسس « سيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت « ، وهو ورشة سنوية ومعرض يقوم على دعوة نحاتين من أنحاء العالم شتى، لتجريب ونحت وعرض منحوتاتهم من حجر « جرانيت » المحلي.
كان صموئيل عندما يتعب من الإزميل يرتاح مع نعومة الريشة بين أصابعه، قال مرة: «حين أتعب من الإزميل والحجر وتفرغ طاقتي، أهرع إلى الرسم لإلتقاط أنفاسي وشحن طاقتي عاطفيا وفنيا».
كان صموئيل ينحت بازميله فينطق الحجر، وليس مستغربا ان يلقب بعدها بانه “كليم الحجر”، “وكاهن النحت “.
عاش صموئيل قصة حب مضنية، بدأت خيوطها تنسج سنة ١٩٦٠؛ سنتها دخل “صباح الخير” رساما، وسنتها إلتقى عفاف، شقيقة بدروعلاء الديب، عالمة الأنثروبولوجيا،فكان حب وعشق وحواجز بغيضة كانت تؤول، ولم تزل، بين قبطي عاشق ومسلمة متيمة.
ولأنه، كما قال المتصوف جلال الدين الرومي :“قد تجد الحب في كل الأديان، لكن الحبيب لا دين له”.
حطم صموئيلوعفاف تلك الحواجز. وحبهما تحول إلى زواج. وقفت عفاف إلى جانب حبيبها الفنان في مسيرته الفنية، ناقدة، مشجعة، تتدبر بدراية وحب شؤون حياتهما، ويتجدد حبهما كل يوم ويثمر إبداعًا على البردي والحجر. تركا مصر سنة ١٩٧١ إلى فرنسا وما عادا إلا سنة ١٩٩٦ فسكنا “الحرانية” في بيت بناه من طين وخشب.
إذا كان صموئيل حنينينظر فيرى، فتتفاعل مرئياته في نفسه، فيبدأ بإزميله ينطق الحجر، فإنشقيق زوجته، علاءالديب، يتفاعل هو الآخر بمرئياته، يصوغ الكلام فينطق بوحًا حينًا، ونقدًا لاذعًا حينًا آخر، فيه عافية اللغة وصحتها، يحمله كل وجدانه وعشقه.
أسهم بدر الديب،الروائي والناقد ورئيس تحرير “جريدة المساء” التي صدرت بمباركة نظام يوليو ١٩٥٢، في تكوين ثقافة شقيقه الأصغر علاء،فرعاه وأخذ بيده، بعدما تخرج من كلية الحقوق، أسوة بالكاتبين البارزين أحمد بهاء الدينوفتحي غانم، وشجعه على الإطلاع على أدب الغرب فنهل من معين كتب أدبائه ومفكريه. وقد فتح له في لغة “راسين”ما لم يفتح لسواه، ورجحت خلف لسانه لغة “شكسبير”، فأجاد اللغتين، الأمر الذي سمح له وضع ترجمات من هاتين اللغتين إلى العربية، من أبرزها”عزيزي هنري”، وهي كتابات عن شخصية هنري كيسنجرللصحافية الفرنسيةدانيال أونل، وترجمة مسرحية صموئيل بيكيت “لعبة النهاية”، إلى جانب عددا من قصص هنري ميلر. كان علاء الديب في الرواية من عصبة جيل الستينات الذي تفيأ في ظل يوسف إدريس، ترك الديب على أرفف المكتبة العربية روايات خمس غيرت لغة ونهج الرواية العربية: “زهر الليمون”،”أطفال بلا دموع”،”قمر المستنقع”، "عيون البنفسج” و”أيام وردية”.
في سنة ١٩٦٥، كتب علاء الديب حوار فيلم “المومياء” بالعربية الفصحى عن قصة كان شادي عبدالسلام كتبها باللغة الفرنسية،وقد تصدر هذا الفيلم لائحة أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية. و في سنة ١٩٩٦ نشر علاء الديب الحوار في مجلة “ القاهرة”، ضمن عدد خصصه غالي شكري، رئيس تحرير المجلة، لتكريم مؤلف ومخرج وكاتب حوار “المومياء”. وهو في“روز اليوسف”، أغوته “صباح الخير”،فمشى إليها ، وكتب على مدى أربعين سنة زاويته”عصير الكتب”، التي تمدد صداها إلى خارج مصر، فقدم علاء في زاويته ما زاد عن ١١١ كتابًا في القصة القصيرة، والرواية، والشعر، والسياسة، والتاريخ، والموسيقى، وعلم الاجتماع… عرض، حلل، ناقش، وكان قلما مرهوب الصرير في النقد، وما كان يخرج من “عصير الكتب” أسبوعيًا هو الشهد المصفى. وكما عايشت قصة حب صموئيل حنين وعفاف الديب،عايشت قصة حب شقيقها علاء وعشقه للمرأة التي سلمها مفاتيح قلبه وبيته.
لم يكن مضى على وفاة جمال عبدالناصر كثير وقت، لما دخلت علينا في “صباح الخير”، ذات يوم، عصمت قنديل، للتدريب على المهنة. فكان أول تكليف لها ضمن خطة التدريب التي وضعت لها، كتابة تحقيق عن مشاعر وإنطباعات البسطاء من أهالي مدينة”بني سويف” بعد وفاة عبدالناصر.
وكان من الطبيعي بحكم تدريبها أن تلتقي عصمت بمعظم الزملاء في التحرير والقسم الفني الذين يقفون وراء صدور المجلة… وكان لقاء مع علاء الديب، العائد من “المجر “ بعد رحلة دراسية، رق قلبيهما، إلتقت المشاعر، لتبدأ قصة حب تكللت بالزواج.
تحولت رغبة عصمت، بعد زواجها من الرجل التي أحبت، في ممارسة الصحافة، إلى خلق مناخ مناسب لرعاية الحالة الإبداعية عند زوجها، فهجرت الصحافة والكتابة، وتفرغت للبيت، وأنجبت أحمدوسارة ،التي حققت رغبة وطموحات أمها، فأصبحت صحافية يعتد بها، عملت في وكالة “أسوشيتد برس” في بيروت، ومنها قامت بتغطية الكثير من الحوادث منها ما جرى في سوريا واليمن… أما أحمد فقد خطفه الفن السابع فدرس الإخراج .
كانت عصمت سكرتيرة زوجها، “راهب المعادي”،نسبةً إلى الفيللا التي سكناها في المعادي، تضبط مواعيده، تدقق وتراجع مقالاته قبل النشر وكانت تردد عند الحديث عن علاء: “أي كاتب، مهما علا قدره، تجد في كتاباته هنات هينان، نقطة غائبة، فاصلة ليست في مكانها المناسب و…خلافه”.
كانت عصمت تستعين بالأشقاء على الله، فمتابعة علاء شقاء في حد ذاته، فالرجل كسول، غير منضبط، لا يلتزم بمواعيد، ومعذب كبير، فقد عانيت شخصيا من إهماله مواعيد تسليم مقالاته، وكثيرا ما فاجأنيفي اللحظةالأخيرة بالإعتذار، فنضرب أخماسا بأسداس، نبحث عن سد الفراغ واللحاق بعجلة الطباعة.
إتفق ذات يوم مع لويس جريس على كتابة مسلسل جديد، فلم يلتزم، ولم يسلم الحلقات الخمس الأولى في الموعد المضروب، فما كان من لويس جريسإلا ان وضعه أمام الأمر الواقع بنشر إعلان مسبق عن المسلسل!
وعلاء الديب، سكير عتيق من سكارى الغرام في مصر.في مذكراته “ وقفة قبل المنحدر” وفي فصل تحت عنوان”حريتي والقرش” يروي تجربة عمله في إحدى المؤسسات في الخليج، وكم أضناه فراق مصر، كتب:
“قرص الشمس المخنوق بالغبار، لم يجعلني أصدق أنني في مكان واقعي.كنت وكأنني خرجت الى حافة العالم أو إلى الجحيم.أين يا دنيا نسيم العصر في مصر؟ وأين النيل؟”. من المفارقات ، أن يجمع شهر فبراير بين تاريخي ولادة ووفاة علاء الديب: فقد ولد في ٤ فبراير ١٩٣٩ وتوفي في ١٨ فبراير ٢٠١٦.
ظلت عصمت وفية لذكرى علاء، حبها الأول والأخير ، تحافظ على آثاره الأدبية والفكرية.