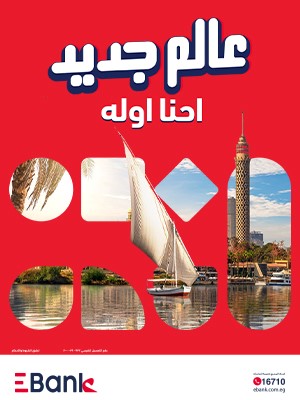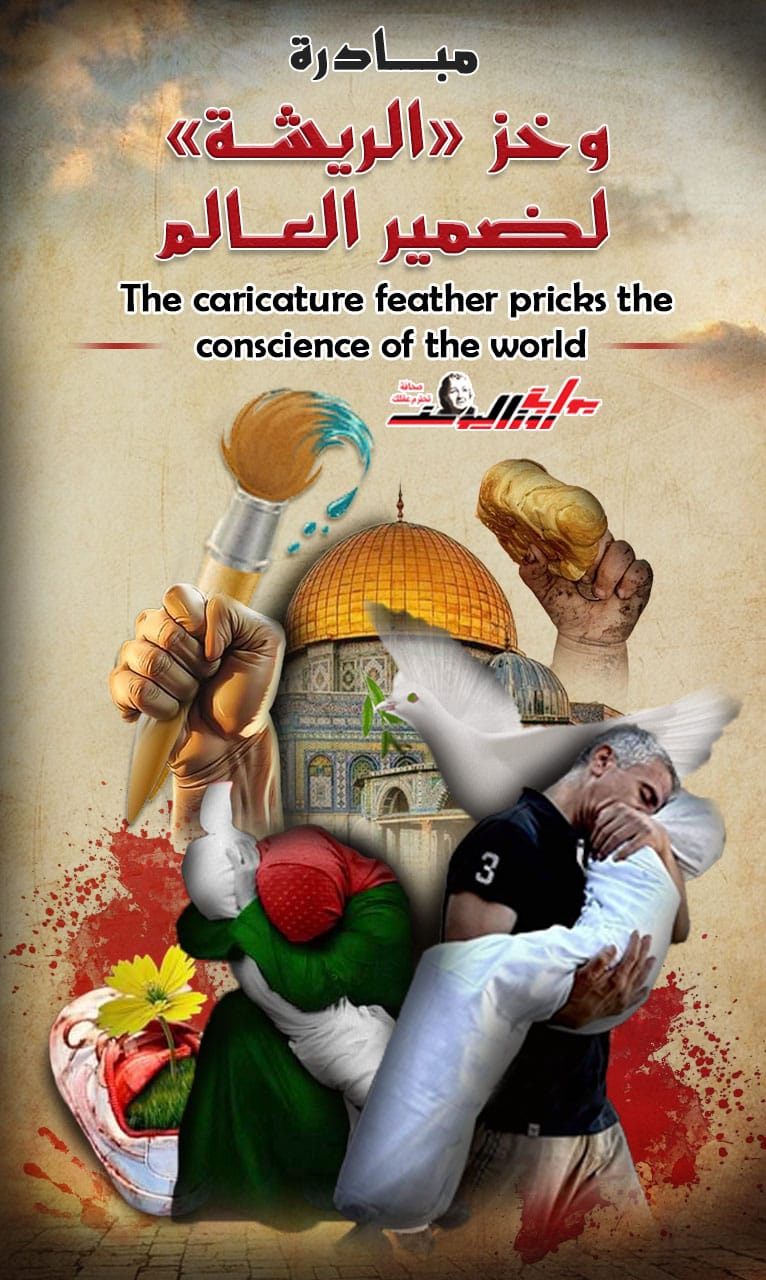مودي حكيم
إمام المتمردين
عبدالرحمن الشرقاوي: فلاح فقيه.. صحفي ثائر جريء.. وشاعر مُجَدّد
المكان: المنزل رقم ١ "مينستر درايف Minister Drive « كرويدون »، جنوب شرق لندن.
الزمان: ذات يوم من سنة ١٩٧٦.
في صدر غرفة الاستقبال، جهاز تليفزيون، تتلألأ منه أضواء ملونة تنبعث من خلف الشاشة الزجاجية الكبيرة.
قبالة الجهاز تَرَبّع شريف (١٠ سنوات) على الأرض، يفور ويغلي حماسة، وهو يشاهد مباراة في كرة القدم، يتراقص جسده النحيل، يمينًا وشمالًا، مع حركة اللاعبين في الملعب.
دخل عبدالرحمن الشرقاوي، مَسَح الغرفة بعينيه، استرعت انتباهه حماسة شريف، أحسست وأنا أقف الى جانبه، أنه ابتهج الى أغوار قلبه برؤية الصبي، لمع في عينيه بريق غريب، يشي بالطيبة والوداعة والحنان، اقترب من شريف وقال، ومشروع ضحكة كبيرة ترتسم على شفتيه:
« مين بيلعب يا شريف؟ ».
أجابه الصبي، من دون أن يرفع نظره عن الشاشة، من خوف أن تفوته لحظة مما يدور في الملعب أمامه: « ليفربول ضد تشلسي يا عمو... ».
ترك عبدالرحمن الشرقاوي ابتسامة منتشية على شفتيه، تماوجت نبرات صوته بالود، سأل شريف:
« ممكن أتفرج معاك يا شريف؟ ».
من دون أن يُجيب، أفسح شريف له مكانًا الى جانبه، تهلل وجه عبد الرحمن الشرقاوي:
«طيب ...يا سيدي أدينا قَعَدنا».
وتربّع على الأرض الى جانب الصبي، وبدأ يشاهد المباراة بالحماسة نفسها، وراح، بحنو الأب و وداعته، يتبادل مع الصبي التعليقات حول ما يجري أمامهما، ويتعمّد الإستفسار، فيصغي الى الصبي باهتمام، يجعله يتمادى من دون كلفة، مرات خَفّف من حَنق شريف، ومرات أخرى نسي نفسه تأخذه الحماسة، فيبدأ يضرب كفا بكف... وظلّا هكذا حتى دوّت صفارة الحكم الأخيرة.
هذا المشهد الإنساني الواقعي، الذي لم يفارقني طوال ٤٤سنة، لم يكن غريبا على عبدالرحمن الشرقاوي، صاحب الشمائل الفواحة، العفيف النفس، الليّن العريكة، النقي السريرة، الذي لم يعرف طوال عمره الكره ولا الضغينة، فليس في حياته مكان سوى للمحبة.
يومها جاء لمنزلي، مُلبّيا دعوتي للتعرف على عائلتي الصغيرة، فهو جاء إلي لندن في زيارة عمل، و للوقوف على ما أقوم به في إدارة مكتب «روزاليوسف»، الذي كان كلفني بتأسيسه وإدارته في العاصمة البريطانية.
ما كان عبدالرحمن الشرقاوي يبغي من المكتب، هو أن يزيل الشوائب التي لحقت بسمعة المؤسسة المصرية العريقة، في لندن وسائر العواصم الأوروبية، فقد وصمتها المؤسسات الإعلامية في تلك العواصم بأنها تميل الى الشيوعية، وتغالي في التنظير لها، الأمر الذي أثّر على انتشار وتوزيع « روزاليوسف»، وأصاب مواردها المالية في مقتل، بعدما قطعت المؤسسات والشركات الأوروبية الإعلانات عنها.
وقد تمكنت، الى حد بعيد، من أن أُسهم في رفع الحيف والضيم عن المؤسسة، بتكثيف التغطية الصحافية من لندن، فزاد اهتمام الصحافة البريطانية بما ينشر في «روزاليوسف»، إضافة الى حملة علاقات عامة واسعة النطاق، خفّفت من غلواء الادعاءات المتجنية التي طاردت طويلا المؤسسة و مطبوعاتها.
ولم يكن لي ذلك كله، لولا دعم عبد الرحمن الشرقاوي، وتفهمه، بما عُرف به من رجحان الرأي وبُعد النظر، فما عدت منه برأي في أزمة، إلا و كان ختام الأزمة مصداقا عليه.

عرفت عبدالرحمن الشرقاوي قبل أن ألتقيه، ما عدت أذكر، كيف وقعت بين يدي مقالة له، كان نُشُرها في «الفصول»، التي كان يصدرها محمد زكي عبد القادر، فأسَرني أسلوبه، وجذبني تفكيره، فرحت أقتفى دربه، أتابع ما يكتب وينشر، نثرًا كان أم شعرًا.
شدّتني إليه في إجاداته، عبارته المتماسكة، وخياله الرائع، وتعبيره البارع... وعندي أن عبد الرحمن الشرقاوي أعاد الى النثر رواءه.
ولطالما كنت أعجب كلما نزل اسم عبدالرحمن الشرقاوي على الكلام، يبدأون بذكر قصيدته المشهورة «من أب مصري الى الرئيس ترومان»، التي نشرت في ديسمبر سنة ١٩٥٢، ويحنو ماضي الرجل!
فعلى الرغم من أن تلك القصيدة ،كانت بدايات مدرسة الشعر الحديث، التي أقام الشرقاوي دعائمها وطيدة، ومكّن لها ، نظراً و قولاً، بما كان ينشر بعدها... وعلى الرغم من أنها أول قصيدة سياسية تهاجم السياسة الأمريكية، فشاعت، ورُدِدت في كل مكان يتحرك فيه لسان بين فكين، ونُشرت مُزينة برسومات المبدع حسن فؤاد، وبيع منها ما يربو على مليون نسخة.. على الرغم من ذلك كله، لم تكن البداية التي وضعت عبد الرحمن الشرقاوي على درب الأدب والشعر والفكر.
بداياته كانت في «الفجر الجديد»، التي كان أصدرها سنة ١٩٤٦ أحمد رشدي صالح، وكانت يسارية الهوى، وبعدها عقد مقالات في « الفصول »، « الطليعة »، « الشعب »... إلا أن أحداً لم يلتفت الى هذا الكاتب المتمرد، الثائر، أو أعاره انتباها... حتى عندما عاد من باريس في مطلع سنة ١٩٥٠ بعدما أتم دراسته القانونية العليا، وكتب في « المصور »، ونشر قصصه فيها على مدي سنتين من الزمن، لم يهتم به غير القلّة من المُثقفين اليساريين والتقدميين، على الرغم من أن طبقة نثره هيهات أن تجدها في صحافة هاتيك الأيام، من يكاد أن يبلغها، في روعة الألفاظ، ودِقّة المعاني، الى براعة في وضع الأشياء في موضعها في مقامات الكلام، ليس بعدها براعة، وبقي عبد الرحمن الشرقاوي في العتمة، حتى هَدَرت الدبابات في المحروسة، في ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢، فطار العرش والتاج والصولجان، وقامت الجمهورية، فغيّرت مصر، وغيّرت حياة عبد الرحمن الشرقاوي.
كان المتمرد، الذي ينغل في داخل عبد الرحمن الشرقاوي، ينتظر تلك اللحظة، لحظة أن تنتفض البلاد، وينعتق الغلابة من أسر المحتلين والاقطاعيين، وتقوم ثورة، أي ثورة، ليرتاح ويطمئن.
كان المتمرد العنيد، علت به السن، وأدركه التعب، بعد سنوات طويلة من الرفض و الاحتجاج.
كان لم يبلغ الحلم بعد، عندما ذاق مرارة الحبس، يومها، خرج مع رفقة له، يهتفون في أزِقة « الدلاتون»(مركز شبين الكوم)، قريته ومسقط رأسه: « الله حي...الله حي...سعد جي».
فألقى الخفراء القبض عليهم، وحجزوهم في غرفة «السلاحليك»، في دوار العمدة، فبات عبد الرحمن الشرقاوي ليلة في الغرفة المعتمة.
وظلّ المتمرد هائجاً، فائراً، عالي الرأس، عصّي المِراس، غير هيّاب، لا يهون و لا توهن عزيمته، هاجم المحتلين البريطانيين، فاعتقل سنة ١٩٤٧، وأودع في زنزانة واحدة مع محمد مندور وعبد العزيز فهمي.
حمل راية « ثورة يوليو »، عاليًا، كتب في مجلة «التحرير» لسان حال مجلس قيادة الثورة، التي كانت تحت إشراف جمال عبد الناصر، مقالات كان لها طنين ورنين، أصبح بعدها «أديب الثورة » وشاعرها، والمعبِّر الحقيقي عن المنحى المقاوم، الرافض فيها، وعن الوجه اليساري التقدمي.
فإبداعات وإجادات عبد الرحمن الشرقاوي، فجّرتها «الثورة»، فلا يمكن فهم أعماله النثرية، والشعرية، والمسرحية، من دون ربطها بتلك الثورة، وتطوراتها، وتحولاتها الداخلية والخارجية.
و مثلما كانت « الثورة »، سببًا في إبداعه، كانت أيضا السبب في أزمته، وصدمته، في آن معًا.
وجد جمال عبدالناصر أن مجلة «التحرير»، لم تعد كافية وحدها لمخاطبة الناس، وشرح وتوضيح ما تنويه وتعتزم السلطة الحاكمة القيام به، فاستقر الرأي على إصدار جريدة يومية، تحشر رأسها بين الجرائد اليومية التي كانت تملأ صباحات القاهرة بالعناوين والأخبار.
فكانت «الجمهورية»، التي ترأس انور السادات مجلس إدارتها، وأُختير مأمون الشناوي ليترأس تحريرها، وانضم الى الجريدة الوليدة التي صدر عددها الأول في السابع من ديسمبر سنة ١٩٥٣، عدد من كُتّاب مجلة « التحرير »، أبرزهم كان عبد الرحمن الشرقاوي.
و حدث أن كتب أنور السادات، في ذات عدد، مقالا حذّر فيه من « الخطر الشيوعي الأحمر »، و زحفه الدؤوب الى المنطقة، وفي العدد نفسه كَتَب عبد الرحمن الشرقاوي، مطالبا بالحوار مع الشيوعيين، بدل التحذير والتخوف منهم، ولم يجد رئيس التحرير غضاضة في نشر المقالين المتعارضين في عدد واحد، إلا أن أنور السادات استشاط غيظًا، وأمر باحضار الشرقاوي، فقام البوليس الحربي بإحضاره الى الجريدة.
هوى السادات بقبضته على طاولة المكتب، وبنبرات غاضبة قال:
« كيف يا عبد الرحمن بترد على مقالي في العدد نفسه؟».
فرد عليه الشرقاوي بهدوئه المعهود مستفسرا:
« هو سيادتكم بتكتب؟ ».
تكوّر الغضب في عيني السادات، أخذته الحدة، فأمر بنقله الى سجن البوليس الحربي.
أمضى الشرقاوي الليل في الزنزانة العفنة، في الصباح تفاجأ بالياور يفتح باب الزنزانة، ويقوده الى مكتب آمر السجن، ليجد أنور السادات في انتظاره، فاصطحبه الى منزله في «الهرم»، لتطييب خاطره، وخلال تناولهما الإفطار، قال له السادات بوّد:
« إنت يا عبد الرحمن أثرت أعصابي... كيف يا راجل ما تعرفش إنني بكتب منذ قبل الثورة؟ ».
وتقطّع الإشكال، واستمر عبد الرحمن الشرقاوي في كتابة عموده اليومي في «الجمهورية»، إلا أن شيئا ما بدأ يتغير في ذهن الشرقاوي حيال تصرفات أولي الأمر في البلاد.
ولحادثة الشرقاوي سابقة، حكاها هو لي، كانت جرت مع إحسان عبد القدوس، الذي بعدما كتب في « روز اليوسف » مقالا انتقد فيه تصرفات بعض الضبّاط، أُعتقل و أودع السجن أياما، وبعد الإفراج عنه، اتصل به جمال عبد الناصر وقال له بتودد:
« إيه... اتربيت، طيب تعالى بكرة وأفطر معايا ».
و تمضي أيام و تأتي أخرى. في سنة ١٩٦٤ سار ذكر عبد الرحمن الشرقاوي كل مسير، فقد كان عقدًا في المجلات المصرية والعربية، الواسعة الانتشار إذ ذاك، كثيرًا من المقالات الفكرية، والأدبية، والسياسية، الى جانب عدد من المسرحيات الشعرية، والأبحاث التي أيّدها بالناصع من الأدلة، والإثبات، والأصول، بحيث أصبح ما يكتب مرجعًا مهمًا للبحث والتتبع، فغدا من أبصر أهل زمانه نحو اللغة العربية وصرفها و مفرداتها…
وعلى الرغم من ذلك كله، فوجئ، ذات يوم، برسالة مفادها أن قراراً أُتخذ بالاستغناء عن خدماته وطرده من جريدة «الجمهورية»! كان ذلك الإجراء التعسفي، ضمن حملة واسعة طالت أربعين كاتباً بارزاً، منهم طه حسين وعبد الرحمن الخميسي، وقف خلفها المشير عبدالحكيم عامر.
ولقد أثّر فيه هذا التصرف تأثيرًا بالغًا، أصاب اعتداده بنفسه، ولم يستقر وعي عبد الرحمن الشرقاوي إلا على شيء واحد، هو تنّكر « الثورة » له، وأن جمال عبد الناصر، بما له من حول و قوة، كان عاجزًا عن حمايته و حماية كتّاب على رفعة في المستوى والقدر، فسقط شيء خطير في داخله كان متعلقا بمصير مصر.
وما زال محفورًا في ذهني ، ما قاله لي بمرارة، في ذات لقاء بيننا، أراد فيه نفض كتمات صدره: « لم أكن أتوقع أن تصل الحال ببعضهم الى هذا الدرك، وأن يبدأ الصراع على السلطة باكراً، إنهم بَدَل استخدام قوة القانون يستخدمون قانون القوة ».
شيئان على درجة من الأهمية استحوذا على فكر عبد الرحمن الشرقاوي:
الإصلاح الزراعي، وقد ذكر لي مرات عِدّة، إنه قدم لجمال عبد الناصر مسوّدة اقتراحات حوله، طُويت ولم يؤخذ بها!
ثم، إيجاد سياسة خارجية مختلفة في تصوراتها و منحاها، مع بروز العدائية الأمريكية.
وكأنما الشرقاوي وجد فيما كان يجري ويدور، حبر قلمه، فكتب عملين، هما في اعتقادي، أهم إبداعاته: قصيدة «من أب مصري الى الرئيس ترومان»، التي كانت علامة فارقة، وبداية مدرسة جديدة في الشعر الحديث، إذا أوقفنا على بلاغة الشعر، وتناسق النظم، ورِقّة السبك والعاطفة، ودقّة المعنى، والسهولة والانسجام، ذهب عنا غرابة ذلك الخلود الذي لم يزل يلّف تلك القصيدة على مدى ٦٨سنة، وهي كانت أيضا أول قصيدة سياسية، أفصحت عن الواقعية السائدة في السياسة الخارجية و المرتبطة إرتباطًا وثيقًا بنهج السياسة الداخلية.
و كانت بعدها « الأرض »، بداية الأدب الواقعي الاشتراكي، وما أحدثته الثورة في الريف.
خَلَع الشرقاوي على هذه الرواية، ثوباً لغويًا قشيباً، أنيق المنسوج، نقش كلماته و لا نقش الجمال في برودة الرخام، وبين أسطر «الأرض»، تحذيراً للثورة من الفشل و من الخيانة، من خلال ربطه الواضح بين الحفاظ على الأرض، والحفاظ على نبض المعركة الوطنية الداخلية.

و حدث أن امتشق الدكتور لويس عوض، القلم في وجه الشرقاوي، منتقدا كتاباته عن الفلاحين، وكال له تهمة إنه يرسم شخصيات هؤلاء الفلاحين من خياله الخصب، فتلك الشخصيات، عند عوض، لا تمت الى الواقع المُعاش بصِلة!
فردّ عبد الرحمن الشرقاوي :
« إن الفلاحين الذين أكتب عنهم هم أهلي، فأنا فلاح من المنوفية مركز شبين الكوم، وأنا علي صلة بأهل قريتي ووالدي يعيش في القرية وأهلي كلهم يعيشون في القرية، الموتي والأحياء، وأنا أكتب عمن أعرفهم وعما أعرفه في حقولنا وفي قُرانا، وأعتقد أن الدكتور لويس عوض لم يعرف الفلاحين لأنه يعيش في المدينة علي الدوام، وأنا مستعد علي أية حال لاستضافته في قريتي أية مدّة يراها، شهورًا أو أعواماً، ليتعرف على الفلاحين الذين أكتب عنهم ».

عندما بدأ جمال عبد الناصر، خوض معاركه العربية، منافحا في الجزائر الرئيس الفرنسي غي موليه، ومؤيدًا الثورة الجزائرية، أدرك عبد الرحمن الشرقاوي، أن رياح الاتجاه العربي ستهب علي مصر، فكتب مسرحية «مأساة جميلة» عن المناضلة الجزائرية "جميلة بوحريد"، وكانت تتواءم مع موقف الثورة وعبد الناصر، وكانت أيضا حدثا فنيا رائدا، إذ إنها كُتبت بالشعر الحديث، فاستخدم الشرقاوي «شعر التفعيلة» الذي كان من روّاده، و كرّت حبات سبحة المسرحيات: «الحُسين ثائرا »، «الحُسين شهيدا »، « النسر الاحمر »…
إلا أن مسرحية « الفتي مهران »، في نظري، هي الأبرز بين مسرحياته، والأعمق أثراً و تأثيراً و دلالة، فقد كتبها في فترة دخل فيها عبد الناصر، ومن معه وحالف وتحالف معه، في خلاف مع اليسار، وفي مرحلة بدأ فيها اليمين يتسلل الى مراكز القوى، ويتكمش بمفاصل الحكم والدولة، فكانت « الفتى مهران » رسالة مفتوحة الى جمال عبد الناصر، لكي يُبَدِل ويُغيّر تحالفاته، و خياراته، وقراراته، وينقذ ما يمكن إنقاذه، ويحمي الثورة من الانكسار الداخلي وتضعضعه، الذي تسبب في الهزيمة سنة ١٩٦٧ وما بعدها... و كانت خيبة الشرقاوي، كما أسَر لي مرارا، هي أن الرسالة، لسبب ما، لم تصل جمال عبد الناصر، فكان ما كان.

لم يكن جرح « النكسة »، قد التأم بعد، عندما رحل جمال عبد الناصر عن الدنيا، وترك مصر نهبًا للجماعات الدينية، التي كانت خبيئة، تقتات من آثار « النكسة »، مُتهمة الفِكر اليساري التقدمي بأنه وراء الانكسار والهزيمة... فبرزت، ونَمَت، وتمّددت، أسعفها في ذلك، لجوء أنور السادات اليها لضرب الناصرية و اليسار! فانتقلت المعركة أيام حكم السادات من « حركة التحديث »، التي كانت بدأت تأتي بالجنى على زمن عبد الناصر، الى العودة الى «السلف الصالح»، و«الأصولية»، التي تمثلت في مرحلة الخلفاء الراشدين، والأصولية المستنكرة، تلك، كانت أخطر تحول في مصر.
كان عبد الرحمن الشرقاوي يعيش هاجس هذا الخطر الداهم، ويعرف أكثر من غيره مضاه وأذاه على النسيج الاجتماعي المصري، فعَكَف على إيجاد فكر تقدمي يتكون من مزج الفكر الإسلامي الحديث، مع الفكر اليساري التقدمي، تمامًا كما فعل « الأزهر » مع حركة « سان - سيمونيانزم » Saint-Simonianism، وهي حركة سياسية اجتماعية فرنسية قامت في النصف الأول من القرن التاسع عشر، مُلهَمة بأفكار الكونت دو سان سيمون، واسمه كاملا "كلود هنري دو روفروي " Claude Henri de Rouvroy و التي انبهر محمد علي و ابنه إبراهيم باشا باتباعها، عندما حلّوا في مصر، لتطبيق أفكارهم الإصلاحية والإسهام بنهضتها، ( من أتباع تلك الحركة فرديناند ديليسبس مهندس قناة السويس)، إلا أن ما قام به « الأزهر »، تحلل، واندثر، وإختفت معالمه وآثاره الفكرية، وتوقفت الحركة التحديثية للفكر الديني، ومسايرته للتطور والإصلاح الاجتماعي.

كان عبد الرحمن الشرقاوي، كما يستشف المُتتبع لتطوره الفكري، من المتأثرين بالحركة ال « سان- سيمونيانزم »، وأفكارها الإشتراكية و الإصلاحية، وهو أدار كل نتاجه وإبداعه حول تلك اللحمة القديمة بين « الأزهر » والحركة الإصلاحية الفرنسية، وليس أدّل على ذلك من كتابه «محمد رسول الحرية» الذي هاجمه «الأزهر»، ورماه المشايخ الإتباعيين والدوغمائيين بالانحراف عن « صحيح الإسلام »، أدانوه، وطالبوا بتجريمه وتحريم كتابه ومصادرته، فما كان منه إلا أن رفع ضيمه الى جمال عبد الناصر، الذي أنصفه وأثنى عليه بعدما قرأ الكتاب، فكمّم « الريس» أفواه مشايخ « الأزهر»، و سمح بتوزيع الكتاب، فانتشر، وأُعتبر بداية المعركة ضد الرِدّة و الأصولية، و مدماكًا لحركة التحديث.
ومضى عبد الرحمن الشرقاوي، يمتشق قلمه ويديره على الورق ضد «زمن الرَدّة»، فظهر «علي إمام المتقين»، و«الفاروق عمر »، و«أبو بكر أول الخلفاء الراشدين»، و«عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء»... وكلها سهام تستهدف الفكر الأصولي السلفي، الذي يستعين بالتراث والماضي العتم، المُختَلَف عليه فقهيًا وسياسيًا، للقضاء على المستقبل المستنير.
ولم يسكت عبد الرحمن الشرقاوي على ضيم، تصدى للذين تصدوا له، وجردوا بأقلامهم الخبيثة المدعية حملات التجني، وكان الشرقاوي في تصديه، جَدَلي، قوي الحجة، يعرف، دائما، كيف يدافع عن آرائه، بقوة، و شدة، دونما لين، أو هوادة، و من دون أن يخرج عن آداب المناظرة.
في مقال له بعنوان: « من يفسر لنا مبادئ الإسلام؟ ، أقام فيه وأقعد، كان نَشَره في «روز اليوسف» في زمن رئاسته تحريرها، فكَتَب مصارحاً رجال الدين بنواقصهم:
« إنهم لم يحاربوا أبداً أى صورة من صور الفساد الحقيقي التي تنهش في مجتمعنا، و هي تحت أعيُنهم يرونها في كل صباح و مساء ..لأنهم ينافقون الله .. لكنهم إذا انطلقت صيحة مخلصة لتنفض مبادئ الاسلام ما فيها و ماعليها من غُبار .. أخذتهم الصيحة، فأنفضوا يكيلون الإتهامات .. و أذكر أنهم ما إجتمعوا يوماً لمواجهة فساد و إقامة صرح بلا أذى ». ***
تلفت أنور السادات، و هو يبحث عن رئيس مجلس إدارة جديد لمؤسسة «روزاليوسف»، فلم يجد أفضل من عبد الرحمن الشرقاوي للمنصب، وهو كان قاسيًا عليه في بدء الأمر، كما مرّ معنا، ثم قرّبه منه، ونشأت بينهما صلة ودّية وثيقة.
وكان أنور السادات يعرف حق المعرفة، أن «صديقه» الشرقاوي من طينة الذين لا يصنعهم المنصب أو المسؤولية، إنما هم الذين يصنعون المنصب، ويترفعون بالمسؤولية الى الذروة.
و لأن رئيس الجمهورية هو الذي يختار ويعين ويُقيل رؤساء تحرير الصحف المسماة قومية، فقد اختار وعَيّن كل من فتحي غانم وصلاح حافظ لرئاسة تحرير «روز اليوسف»، وحسن فؤاد و لويس جريس لرئاسة تحرير «صباح الخير».
واجه عبد الرحمن الشرقاوي في التعامل مع مدير المؤسسة والعضو المنتتدب عبد الغني عبدالفتاح (الذي كان يطمع في منصب رئيس مجلس الادارة ) صعوبات، فقد وضع له العقبات منها خلو خزينة المؤسسة من المال، مما يستحيل معه تسديد رواتب العاملين وعراقيل أخري مما دفع الشرقاوي للاستغناء عنه، وتعيين لويس جريس أميناً عاماً للمؤسسة بشرط تطبيق العدالة الاجتماعية في أي قرار يصدره.
وكان همّ الشرقاوي رفع توزيع روز اليوسف، فقد لاحظ ارتفاع توزيع المجلة عندما ينشر إحسان عبد القدوس فيها وينخفض عندما يتوقف، وصادف أن نَشَر الزميل عبد الستار الطويلة حواراً مع الرئيس السادات فارتفع التوزيع، وهنا أدرك الشرقاوي أهمية ايجاد مادة للنشر تستهوي القراء، وفي تلك الفترة رحل "مصطفي النحاس"، وتمكّن الشرقاوي من الحصول علي مذكراته و تم نشرها، وكان الشرقاوي سبباً في إرتفاع مبيعات المجلة الي ما يزيد عن مائة ألف نسخة.
*** ما كاد الدكتور عبدالمنعم القيسوني، نائب رئيس الوزراء لشؤون المال والاقتصاد ينهي، في مجلس الشعب، عرضه للإجراءات التقشفية التي ستُدرج في الميزانية، لتخفيض العجز، مرضاة لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين، لتدبير الموارد المالية اللازمة ورفع أسعار الخبز والشاي و السكر واللحوم والمنسوجات وغيرها من السلع ... حتى إهتاج الناس، ونزلوا الى الشوارع، صرخوا، هتفوا، حطموا، حرقوا، وانتشر هشيم التظاهرات في المحروسة من الإسكندرية إلي أسوان... وانتفاضة الخبز هذه استمرت طوال يومي ١٨و ١٩ يناير ١٩٧٧.
رَضَخت الحكومة صاغرة، تراجعت عن زيادة الأسعار، فتراجع الناس عن الشوارع، خلال أيام الإنتفاضة، أصر السادات على تسميتها «انتفاضة الحرامية»، محّمِلا المسؤولية للحركات اليسارية و الشيوعيين على رأسها، وأعطى أوامر الى رؤساء الصحف والمجلات، الذين كان عيّنهم، أن يمتنعوا عن وصف الانتفاضة بانها انتفاضة الرغيف، إنما وصفها بانها انتفاضة المشاغبين المخربين و الحرامية، إنصاع بعضهم لأوامر «الريس»، إلا هو، وقف عبدالرحمن الشرقاوي منافحا ومعارضا الرئيس السادات، رافضا أن يكتب في «روز اليوسف» بأن ما قام به آلاف الناس هو انتفاضة حرامية و مشاغبين، إنما إنتفاضة جياع وغلابة ومحرومين.
أصر « سيادته » على طلبه، و أصر الشرقاوي على عناده، و قدّم استقالته من منصبه و من « روز اليوسف »، حمل أوراقه وقلمه وخرج... يومها وجد «الأهرام» تفتح ذراعيها لضمّه، وصفحاتها لحبر قلمه.

الهادئ، المتمرد، الثائر، الغاضب، الرائق، المؤرخ الطلعة، الشاعر الخصب، ما انقطع لكلامه دوّي و لقلمه صرير.
نادرة وقته كان... هو ذا عبد الرحمن الشرقاوي.