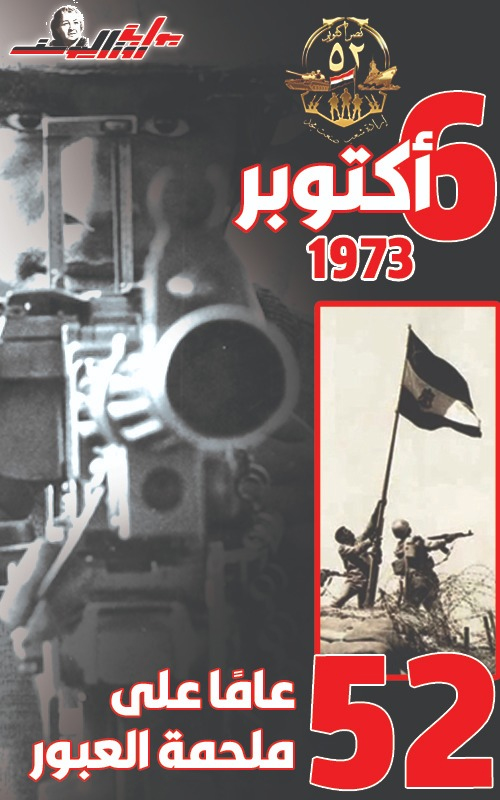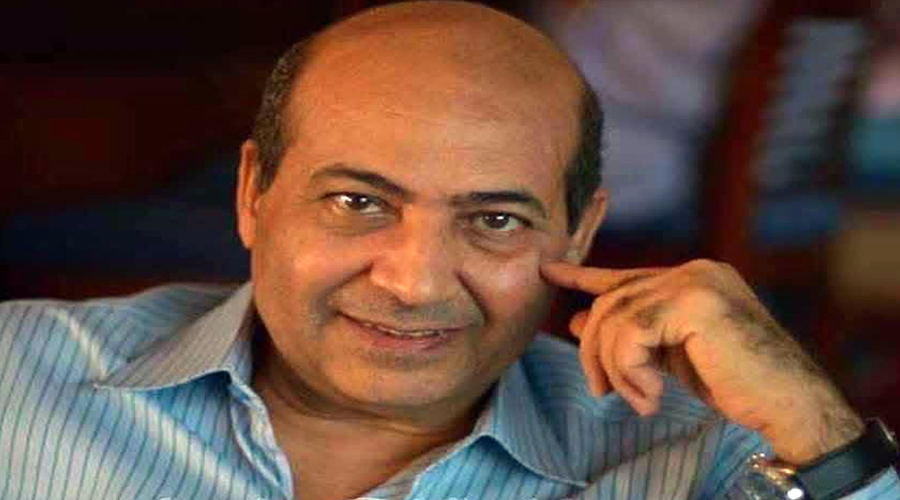محمد عبد السلام
مقابر الموتى الأحياء
بقلم : محمد عبد السلام
"هائمون.. زائغون.. شاردون.. هكذا يبدون.. كالموتى الأحياء".. لم أقصد تلك الخرافة التي برعت في تقديمها كاميرات مدينة هوليوود السينمائية، ولكنها الحقيقة المفزعة التي خلفها ذلك الشيء في أعماقنا، تمكن أخيرا من احتلال أجسادنا، لم يعد لخلايانا القدرة علي الانصياع لأوامر عقولنا، فراحت تتخبط هنا وهناك كالتائهة، اصطدمت بجدار صلب، رفض أن يفسح لها الطريق، كطفل صغير سقط علي الأرض يبكي، ومن خلفة اندفع أطفال المدينة يسقطون فوق جسده، راح يعاقب الجدار بإحداث فوضي هنا وهناك، وعندما جاء الطبيب أخبرنا أن النار تقضي علي الفوضى، فعكف علي إشعال ما أحدثه الطفل، يوما بعد يوم، ماتت الروح وبقي الجسد واضحي شبحا، يسير في شوارعنا كالموتى الأحياء.
الشمعة الأول
"هدير".. فتاه كأي فتاه علي سطح هذا الكوكب، ولكنها ليست كمثل أي فتاه أخري تعيش بيننا، للوهلة الأولي تظن أنها عجوز طاعن في السن، وما أن تقترب منها ستكتشف أنه ظن من النوع الأثيم، لم تتعدي العشرين، رغم ذلك تظنها في السبعين، وجه لم يعد ساطعاً، عينان غائرتان ذابلتان، خدان مسطحان متهدلان، وشفاه جافة حُرمت البسمة، تعجز قدماها عن حمل جسدها الهزيل ، تسقط ، تتهاوى على الأرض، فيُسرع المارة بحملها حتي تفيق، كانت يوما شمعة انطفئ بريقها.
صباح كئيب، دائما ما تقول هذا، فكل شروق شمس هو يوم حزين، كم حلمت أن تبيت ليلة بلا صباح، لكن الديك دائما ما يعاندها ويطلق الصياح، لتبدأ رحلته كل أربعاء مع الألم، تستقل قطار الشرق إلي القاهرة، إلي مبني اعتادت أن تصرخ فيه بلا صوت، أن تبكي بلا دموع، تشاطر قرنائها حياة الموتى، تعاند ذاك الطفل في أعماقها، تارة تنجح مع صغيرها، وتارة يكسرها.
طابور طويل لا ينتهي، تقف هدير انتظارا لجلسة الكيماوي، لا تدري أهو علاج، أم قاتل أخر ينهشها، فقد أضاع هذا الشيء هويتها، أخفي معالم أنوثتها، لم تعد تلك الفتاة التي كانت منذ سنوات، حتي صورة البطاقة المشوهة أضحت أكثر منها جمالاً، صارت تخبئ كل المرايا في منزلها الصغير، لم تعد تسير بجوار الفتارين الزجاجية، كانت تخشي أن تري صورتها فتفزع، دائمة الشرود، قسمات وجهها لا يحمل سوي هموم الدنيا وما عليها، ما جعلها أكثر مرتادي ذلك المبني إثارة للاهتمام والشفقة، بشكل جعلني أشعر أن وراء هدوءها وصمتها وتنهيداتها التي لم تتوقف أشياء كثيرة، ورغم ذلك تتواري عن الأعين حتي لا يري أحدهم ما فعلة ذلك الخبيث بجسدها الضئيل.
"درست الحقوق في بلاد يضيع فيها الحق.. أفهموني أنني سأحقق العدل فاختل كفتي ميزانه".. بضع كلمات سمعتها تهمس بها الفتاه حينما حاولت أن أتودد إليها، لم تنظر إلي، اخفت وجهها عني، ازدادت انكماشا وكأنها تخجل من شيء ماء، لم أتفوه بكلمة، احترمت ما فرضته علي نفسها من عزله، وقفت صامتاً، بين الفينة والأخرى تلتقط أذني بضع كلمات مبعثرة، "هما عارفين أنه مفيش فايدة.. يجيبوني من طنطا عشان يدوني أمل.. والكيماوي جبار، قاتل، بيموتني حتة حتة، ويسيب السرطان حر طليق"، أعياها الإنتظار في طابور يبدو أنه لا ينتهي، فعادت برأسها إلي الوراء لتستند علي جدار المبني...... ورأيت وجهها، بقايا أنثي.
وكأن ثعباناً قد لدغها، انتفضت فجأة وكأنها أدركت إنني أحملق في وجهها، لم تكن تريد ذلك، ورغم ذلك نظرت إلي عيني نظرة جعلتني أشفق عليها، ثم بدأت تتمتم من جديد بعباراتها المبعثرة: "إنت عارف يا اسمك اية.. انا بسافر من طنطا للقاهرة كل أسبوع مش عشان أخف من السرطان.. أنا عارفة أن مفيش أمل.. أنا بسافر اخرج أشوف الدنيا، أقابل ناس تانية، أشوف وشوش جديدة"، التفتت "هدير" إلي وكأنها تناست خجلها، تنهيداتها المتقطعة، ضربات قلبها المسموع، ينبئان عن صعوبة ذلك، لكن يبدو أنها تريد أن تواصل الحديث، "الصدفة كانت بدايتي والجهل والإهمال كتبوا نهايتي.. هل تصدق أن زلة قدم أصابت كتفي بورم سرطاني".....
"إذا كنت تبحث عن قصة يا بُني، تتبع الإهمال.. قصتك دائما خلف أحد المهملين".. منذ الوهلة الأولي لدخولي "روزا ليوسف" لم أسمع سوي تلك العبارة الخالدة لأستاذي عبد الله كمال، تلك العبارة التي مازلت أري واقعيتها في كل قصة كتبتها طيلة ثلاثة عشر عاماً، واليوم تقف "هدير" مثالاً حي لمصداقية قائلها الراحل عنا، فزلة قدم طفيفة أصابت كتفها الأيمن بورم طبيعي، ولكن أحفاد "أبقراط" في معهد طنطا للأورام كان لهم رأي أخر، قاموا باستئصال الورم دون معالجته بالكيماوي، ثم ودعوها مهنئين بالشفاء، ويوم بعد يوم، ينمو ورم جديد، بل وينتشر في جميع أنحاء الكتف، ووصل إلي حد أكل عضلات الكتف الذي أصابه العجز.
"بيني وبين الإهمال قصة غرام يا سيدنا".. هكذا أجابتني تلك الفتاة المسكينة، قالت عبارتها ضاحكةٌ، بانت نواجذها للمرة الأولي، وكأن اللؤلؤ صفف بين فكيها، لوهلة ظننت أن وجهها الحقيقي قد لاح لناظري، وراح عن عيني غشاوة شحوب وجهها، وعادت بنت العشرين لبهائها وصفائها من جديد، حتي خُيل إلي أن هذا الإهمال حبيب قديم أو عشيق راحل، فتلك الشمعة التي أذابتها النار لم يكتفي أحفاد "أبقراط" في طنطا بإصابتها بالخبيث، ولكنهم أضافوا لها في القاهرة نكهة الكبد الوبائي، كانوا يدركون أن هذا ما ينقص تلك الفتاة.
كالفرق بين الربيع والشتاء تحول وجه الفتاة من وجه صحو صبوح إلي وجه مكفهر ملبد بالغيوم، عاد الآسي والألم يحفر معالمه عليها من جديد، ، لم ترغب في أن تعيش البقية الباقية من حياتها وحيدة منبوذة من الجميع، لذلك أخفت سر إصابتها بالوباء الكبدي عن اقرب الناس إليها، كانت تعلم أن مشهد النهاية قد اقترب، وأنا أيضاً أعلم ذلك، وأنا اكتب تلك الكلمات هي الأن ترقد تحت التراب، نسيت ذلك المسخ العجوز الذي أكله الورم، لا أتذكر منها سوي ذلك الوجه الصبوح الذي ظهر للحظات، وفي مخيلتي تلك النواجذ وصفي اللؤلؤ، وعين تذكرت لونها الأن، خضراء تسر الناظرين.
الشمعة الثانية
لا يمكن علي الإطلاق ان تترك هذا المبني المخيف قبل أن تلقي نظرة علي طابق البراعم، البعض يطلق عليها جنة الاطفال، والبعض الاخر يطلق علية جناح العصافير، عن اي جنة واي عصافير يتحدثون، عصافير بلا أجنحة ام جنة تحولت إلي جحيم، فنظرة واحدة إلي وجوههم ستجعلك تدرك أن الجنة اكفهرت وتلبدت بالسواد، والعصافير سقط أجمل ما فيها.
"يا بنات يا بنات يا بنات اللي ماخلفش بنات.. ماشبعش من الحنيه ولا داقش الحلويات".. ما أن تخطو قدميك ذاك الممر المُظلم، حتي يتنامى إلي مسامعك ذلك الصوت الملائكي، صوت للوهلة الأولي تظن أنه آتٍ من أعماق وادي سحيق، أو من جوف كهف عميق، عبثاً ألتف حول نفسي بحثاً عنه، لا أدري من أين يأتي صوت الكروان هذا، خلف أحد تلك الأبواب المُطلة علي الممر حتماً يئن ملاكي بصوت شْجن، ببطء تحركت قدماي، لا تعلم إلي أين، فجميع الأبواب مغلقة، عدا باب واحد في أخر الممر، لا أعلم لماذا لم انتبه إلية، بصيص من الضوء يعافر لكي يتسلسل من خلال شق صغير، أسرعت الخطى وقد أيقنت أن خلفة كرواني الحزين، وقفت أمام الباب مشدوهاً، إنها غرفة الألعاب إذا، هكذا حملت لافتته، اختلست صاحبة الصوت الشْجن ما بين الجلسة والأخرى لتلهو قليلاً.
بأصابع مرتجفة مددتُ يدي، برفق دفعته، حرصت علي أن لا يُصدر صوتاً يُزعج هذا الملاك الحزين، رويداً رويداً لاح خلف الباب جسدها الضئيل، تمسك بين يديها لُعبتها المفضلة، عروسة جميلة، تحتوي بكفها شعرها الذهبي، وباليد الأخرى تسرحه بمشط صغير، كانت كأم صغيرة تعتني بطفلتها، تصنع من شعرها ضفائر رفيعة، ثم تربط كل ضفيرتين بشريط أحمر، لم تنقطع عن الغناء، لم تلحظ وجودي، لم ترفع عينيها عن عروستها الأثيرة.
كجلمود صخر لم أتحرك ساكناً، فقد هالني ما رأيت، فتاة صغيرة لم تتعد السابعة ربيعاً، هزيلة الجسد ترتدي قميصاً أخضر، تهندم شعر عروستها، في حين لا يحمل رأسها شعرة واحدة، أسقطه الكيماوي بغدره المُعتاد، لم أشعر أنها توقفت عن الغناء، ولكنني انتبهت إلي إنها تستدير إلي، رأيتها، طفلة كأجمل ما يكون، بيضاء البشرة بُنية العينين، لم يسلبها اختفاء شعر رأسها وحاجبيها وأهدابها فتنتها الطاغية، تسيل الدموع علي وجنتيها الورديتين أنهارا، لم تنطق ببنت شفه، فقط راحت تمسح شعر عروستها، وهي تقول بصوت خافت، باسم، "شوفت شعر عروستي يا عمو.. عملتلها أحلي ضفاير.. ولما شعري يرجع زى الأول هعرف اعمل لنفسي ضفاير".
عادت الطفلة لغنائها من جديد، تجاهلت وجودي أو تناسته لم يعد هذا هو المهم، فما شغلها عني سرق البقية الباقية من عقلي، راحت تلك الطفلة التي مازلت أجهل أسمها تخاطب عروستها ببراءة تقطر دمعاً، "ماما أنا هنا ليه.. وشعري راح فين.. طب هيرجع تاني ولا كده خلاص.. عاوزة اعمل ضفاير زى عروستي.. راحت فين ضفايري يا ماما"، أمام تلك التساؤلات المشروعة لم يعد بمقدوري أن تفوه بكلمه واحدة، فتلك طفلة لم تدرك بعد أنها تتعايش مع مجرم أثيم، وحش فتك ببراءتها وحرمها أجمل سنوات عمرها، بل حرمها عمرها كله، فقد ماتت فجأة ودون سابق إنذار، ماتت دون أن يجيبها أحد علي تلك التساؤلات، ماتت دون أن تعلم أين ذهبت ضفائرها..................
الشمعة الثالثة
نهار خارجي: قرية دندنة – القليوبية – 26 ديسمبر 1956
ليلة من ليالي الشتاء، السماء كعادتها ملبدة بالغيوم، تعانقت السحب، وأمطرت، بين الحين والأخر تنشق السماء عن أضواء برق مصحوبة بهزيم رعد هادر، أضفي علي القرية لوحه كئيبة، أعلي منزل طيني كاد أن يذوب تحت وطأة الأمطار، جلس "جابر" يراقب الطريق بعيون ملؤها الرعب، ينتظر زائر لم يدعوه، يعلم أنه لا يضمر له خيرا، لذا وقف في هذا الجو قارص البرودة يرقب الطريق.
في الأفق تحرك ركب من ثلاث سيارات عسكرية، يحيط بها عشرات الجنود والخفر حاملين أسلحتهم النارية، لم تهتز أبدانهم لبرودة الجو، لم يبالوا بما علق بأقدامهم من وحل، من اعلي منزلة شاهدهم "جابر"، خفق قلبه ألما، لقد جاءوا من أجلة، ارتعدت أطرافة، ليس لبرودة الشتاء، ولكن لبرودة هذا اللقاء، هب واقفاً وكأنه يلتمس غوثاً، راح يخبط علي رأسه نائحاً، "يا خراب بيتك يا جابر.. يا خراب بيتك"، بخطوات متعثرة هرع "جابر" بالنزول علي السلم الطيني باحثا عن مخبأ.
داخل غرفة الخزين الصغيرة، انزوي "جابر" في ركن خلف أجولة الذرة وشكائر القمح، جالسا القرفصاء مُحيطاً جسده الضئيل بحصيرة بالية من الخوص، حاول كثيرا أن لا يصدر صوتاً، ولكنه فشل فشلا ذريعاً، فقد خلق اضطراب قلبه وارتعاش جسده وارتجافه أوصاله وأنفاسه اللاهثة حالة من الضوضاء، كاد قلبه أن يتوقف من الرعب، ملئ الرعب وجهة المتقيح، كانت نظراته الزائغة للباب وتقلصات وجهه العصبية توحي بأنه ينتظر رسولاً الموت.
جلس "جابر" في مخبئة يسترق السمع، فانه يسمع الأن أصواتهم، ضربات أقدامهم الثقيلة علي الأرض، أفلتت منه صرخة مكتومة كادت تنبئ عن مخبئة، فعاد يضغط بكفيه علي فمه كيلا يصدر أي صوت، ازداد تمسكا بجدران منزله المحاصر، ففي صالة منزله وقف شيخ الخفر يصرخ في أولاده وزوجته "فين جابر يا أم العيال.. العمدة مشدد علينا نسلمه للنقطة"، سمع "جابر" صرخات زوجته وطفليه، وتنامي الي مسامعه صوت اقتحام غرفة الخزين، لم يبحثوا كثيرا، فقد هب "جابر" واقفا كاشفا عن مخبئة، وراح يصرخ "أنا لم أفعل شيئا ... أنا لم ارتكب جريمة".
لم يبالي الجنود بتوسلات "جابر"، فأسرع جابر يتشبث بأي شيء، كان الجنود يجرونه من قدمه وأصابع يده التي برزت عروقه المشوهة تنغرس في تراب أرض منزله لتتشبث بها في مشهد يذكرنا بمحمد أبو سليم في فيلم الأرض، ولكنها انفلتت لتمسك بقدم اصغر أبنائه مستنجدا به، ففوجئ به ينتفض ويبتعد عنه وكأنه شخص ملعون، فاستسلم "جابر" وترك الرجال يسحلونه فاردا يده أمامه وملقيا وجهه على الأرض حتى غبر التراب وجهة وشعر رأسه، كان يتأمل وجوه أبنائه بعيون زائغة لن تراهم مرة ثانية، وأذان تسمع نحيب زوجة تقف على احد أركان المنزل، تحاصرها فوهات البنادق من كل صوب وحدب، تتابع بعيون دامعة زوجها الذي احتلت جسده روح شريرة جعلت منه مسخ بشع تحسبه شبح.
لم يكن "جابر" يعلم عندما وجد نفسه فجأة في سيارة البوليس إلى أين سيصطحبونه، وماذا سيفعلون به ولكنه لم يعد يهتم بعد أن رأى بعينه نفور أولاده وزوجته، تحركت السيارة وسط حشود أهالي قريته والقرى المجاورة، بصعوبة بالغة تمكنت سيارات الشرطة من الخروج من القرية بـ"جابر"، مرت ساعات طويلة، وجابر ينظر من نافذة السيارة لا يعلم الي أين سيذهبون به، أخيرا وصلت السيارة بحملها الي بقعة معزولة في الصحراء بعيدا عن الحياة، بقعة لا تسكنها إلا الأفاعي والذئاب.
ستون عاما عاشها "جابر" داخل تلك البقعة المنعزلة، بقعة أطلقوا علي بابها اسم "مستعمرة الجذام" لا يعلم عنه احد أي شيء عاش منبوذا طريدا من مجتمع لفظه وكأنه جرثومة يخشون أن تصيبهم بلعنة المرض الموبوء، ستون عام عاشها "جابر" داخل المستعمرة حياة "الزومبي" أو "الموتى الأحياء"، تلك الكائنات الأسطورية التي اخبرنا عنها الأدب اللاتيني في أول وصف لمرضي الجذام الذين تم الكشف عنهم في جزيرة هايتي في النصف الأخير من القرن التاسع عشر.
رحلة طويلة قد تستغرقها للذهاب إلى مستعمرة الجذام بمنطقة أبو زعبل التابعة لمحافظة القليوبية، ورغم بعد المسافة عن القاهرة ومشقة الطريق إليها، إلا أن الرحلة قد تكون فرصة حقيقية للاقتراب من عالم "الموتى الأحياء"، لم تكن الوسيلة الوحيدة للذهاب إليها متوفرة كما يعتقد البعض، فعليك أولاً أن تستقل قطار أبو زعبل المتهالك من محطة المرج الجديدة للذهاب إلى محطة أبو زعبل، وتستغرق الرحلة 20 دقيقة، وبجوار المحطة يقف عشرات من سيارات "التوكتوك"، وبمجرد أن تخبر أحدهم برغبتك في الذهاب الي مستعمرة الجذام سيبدي تزمراً وريبة وضيقا، فالجميع هنا يخشي الذهاب الي هذا المكان الموبوء، وتحت وطأة "لقمة العيش" سيوافق في النهاية علي الذهاب بك في رحلة تستغرق 17 دقيقة وسط الصحراء وبعض حدائق التين الشوكى الي المستعمرة.
ها هو أخيرا وجدته أنه العم جابر في صورته وهيئته يهيم على وجهه على عكازين ويرتدي حذاء تم تصنيعه بشكل خاص متكور وقد قصر طوله بفعل بتر الأطراف، أسرعت أنادي عليه لأسمع قصته مع تلك المستعمرة، التفت إلي بوجهه نحت فيه الجذام وجعله أشبه بأسد، قائلاً بلهجة ريفية مرحة: "لسه فيه حد فاكر جابر... جابر مات من سنين يا ولدي... دفنتوه بالحيا وسيبتوه يعيش مع الديابة والعقارب"، رفع "جابر" عكازية ثم التفت إلي غرفة بتر الأطراف قائلا بسخرية: "الاوضه دي يا ولدي دخلتها كتير.. وكل مرة بتمني أن السلاح ينزل علي رقبتي ويخلص عليا.. لكن العمر طويل.. وسنة ورا سنة عايش مشوفتش حتي ولدي"، ثم التفت أي مرة ثانية وراح يلكزني بعكازه قائلا بحده مفاجأة: "إرحل يا بني... ارحل لحسان تتعدي مننا.. ولا نتعدى منك إنت.. الوباء بره بقي كتير".
كلمات العم "جابر" ألجمت لساني عن الكلام، عذرته كثيراً علي ما قاله، فقد عاني الرجل الأمرين طيلة ستون عام مضت، تركناه طويلا يعاشر الذئاب والثعالب والثعابين والعقارب، كشخص موبوء طردناه من حياتنا، حتي زوجته وأولاده لم يكلفا خاطرهما بالسؤال عنه، ماذا عساي أن أفعل بعد كل هذا، غير إنني أسرعت إلي فتي التوكتوك ليعود بي من حيث أتيت.