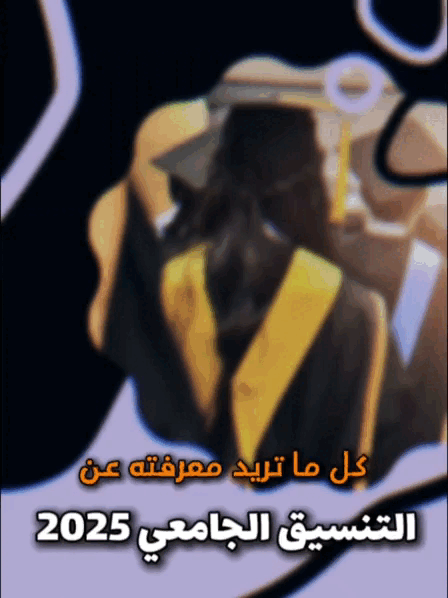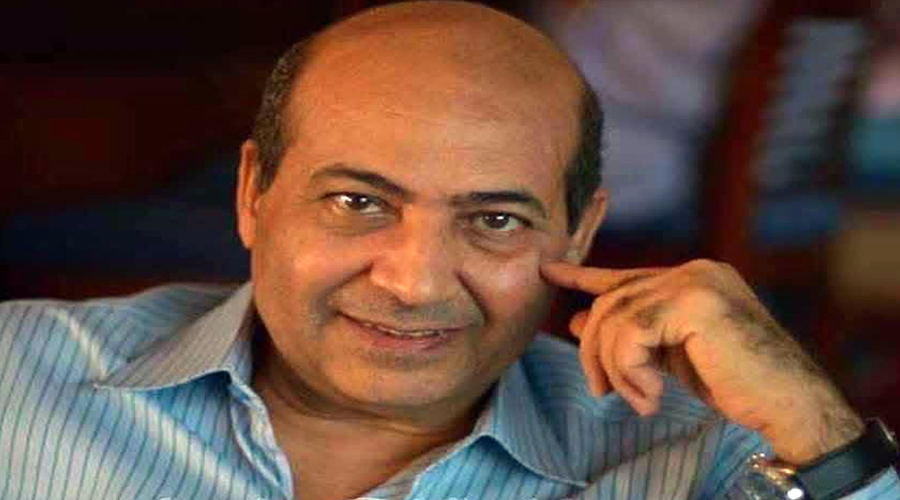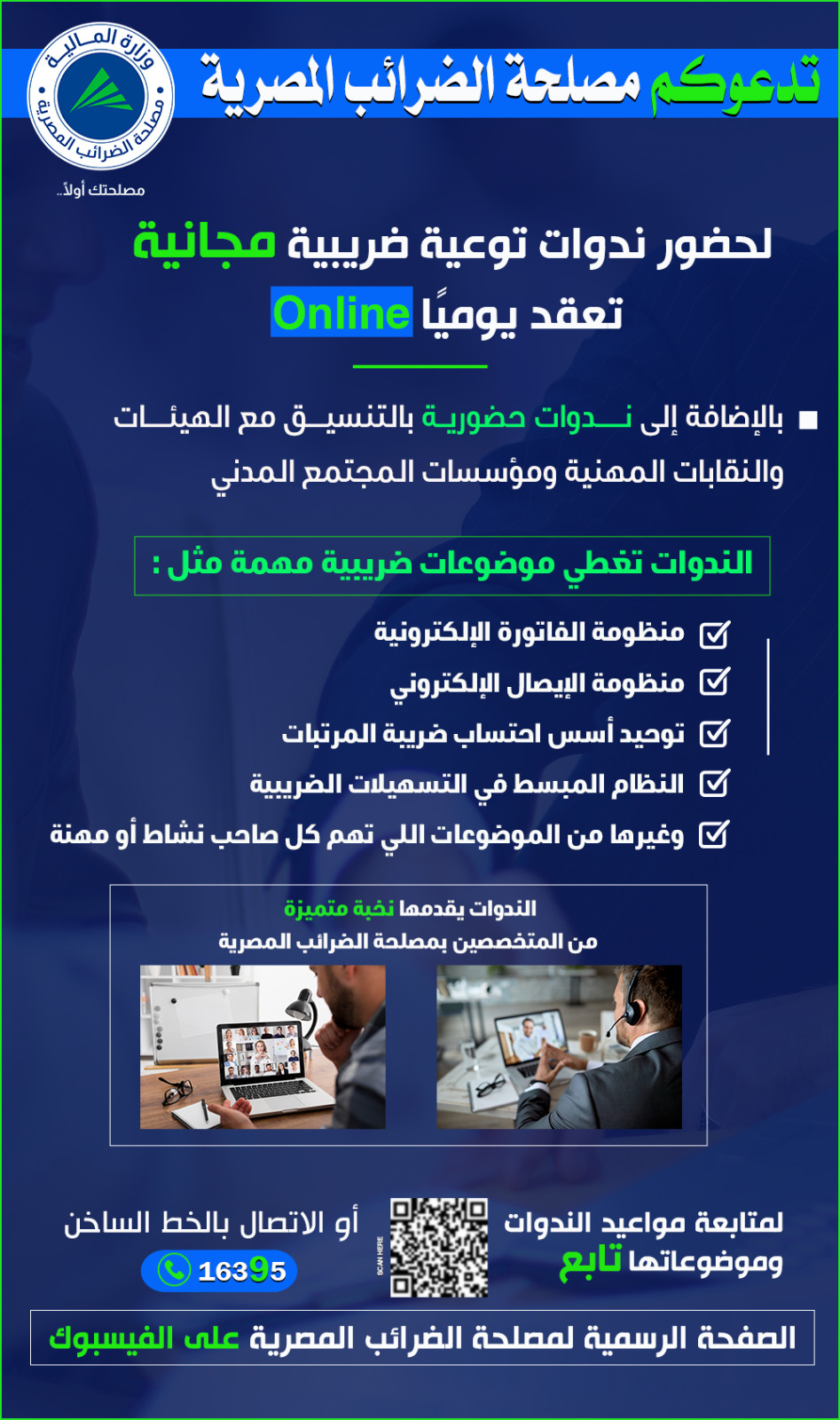بمحاضرة عن الهجرة النبوية
انطلاق الأسبوع الدعوي لمجمع البحوث الإسلامية في رحاب الجامع الأزهر

سلوي عثمان
انطلقت فعاليات الأسبوع الدعوي، الذي تنظمه الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، بالتعاون مع الجامع الأزهر، تحت عنوان: “الهجرة النبويَّة.. تدبيرٌ إلهيٌّ وبُعدٌ إنسانيّ”، وشهدت فعاليات اليوم الأول حضورًا جماهيريًّا ملحوظًا داخل الظلة العثمانية بالجامع الأزهر، بمشاركة علماء الأزهر، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
وأكّد أ.د. أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في مستهل كلمته خلال ندوة اليوم الأول من الأسبوع الدعوي أنَّ الهجرة النبويّة الشريفة تمثّل مناسبة كريمة تُذكّر بأعظم حدث وقع في تاريخ الإسلام، وهو انتقال النبيّ ﷺ من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة، بأمرٍ من الله تعالى، لتأسيس مجتمع جديد، وبناء دولة تنطلق منها رسالة الإسلام إلى الآفاق.
وأوضح فضيلته أنّ الهجرة النبويّة جاءت محفوفة بالعِبر والدروس العظيمة، وظهر فيها جانب خصائص النبيّ ﷺ التي تفرّد بها، فقد خصّه الله بالهجرة، وخصّه بالإسراء والمعراج، وجعل له مقام الشفاعة الكبرى يوم القيامة، كما جاء في حديث صحيح رواه الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبيّ ﷺ يكون أوّل من يستفتح باب الجنة، فيقول له خازنها: “بِكَ أُمِرْتُ، لا أَفْتَحُ لأَحَدٍ قَبْلَكَ”.
وأشار عضو هيئة كبار العلماء إلى رفعة قدر النبيّ ﷺ، وسموّ منزلته عند الله عز وجل، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾، وبما رواه أن جبريل عليه السلام قال للنبيّ ﷺ:”لا أُذكَرُ إلا ذُكرتَ معي”، ولذلك اقترن اسمه باسم الله تعالى في الأذان والتشهّد، وتوقّف فضيلته عند مشهدٍ مؤثّرٍ من لحظة مغادرة النبيّ ﷺ لمكة، إذ خرج منها متوجّهًا إلى المدينة وقلبه يتفطّر شوقًا إلى أحبّ بلاد الله، وقال وهو يودّعها بعين دامعة:”واللهِ إنّكِ لَأَحَبُّ أرضِ اللهِ إليَّ، وأحبُّ أرضِ اللهِ إلى الله، ولولا أنّ قومكِ أخرجوني منكِ ما خرجت”، فجاءه الوحي في لحظتها يُثبّته ويُبشّره: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾.
وبيَّن فضيلته خلال كلمته أنَّ الهجرة لم تكن فرارًا، بل تأسيسًا لدولة إسلامية جديدة، أُقيمت على ثلاثة أسس متينة: أولها توثيق الصلة بالله، وثانيها توثيق علاقة المسلمين بعضهم ببعض، وثالثها توثيق الصلة بغاية الإسلام الكبرى، لتكون الهجرة بذلك مدرسةً خالدة في الفهم والتخطيط والعمل والبناء.
من جانبه، أكد فضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الهجرة النبويّة ليست مجرّد حدث تاريخي أو انتقال جغرافي، بل هي مسارٌ بنائيٌّ ونهضويٌّ لصناعة الأمة، لا يدركه إلا مَن امتلأ قلبه بالتصديق والإيمان، مستشهدًا بموقف سيدنا أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه الذي رفع يديه قائلاً: “الصحبةَ، الصحبةَ يا رسول الله”، ليكون تصديقه القلبي هو البداية الحقيقية لرحلة الهجرة.
وأوضح فضيلته أنّ الهجرة تنقسم إلى هجرة “مبنى” وهجرة “معنى”، مشيرًا إلى أن رسول الله ﷺ جمع بين الهجرتين؛ إذ هاجر بجسده وروحه، بينما يُطلب من المؤمنين اليوم أن يهاجروا بقلوبهم إلى رسول الله، فيتحقق فيهم المعنى الروحي للهجرة، وهو التعلّق القلبي برسول الله ﷺ، بحيث يتصل قلب المؤمن بقلب نبيّه، فيعيش في حضرته المعنوية كما لو كان في الروضة الشريفة.
وأشار فضيلته إلى أنّ التصديق القلبي هو الأساس في استحضار حدث الهجرة وفهم أبعاده، وهو ما يتطلب إخلاصًا في النيّة وصفاءً في التوجّه، لافتًا إلى أن الإمام البخاري صدّر صحيحه بحديث النيّة: «إنما الأعمال بالنيات...” ليؤكد أن كلّ هجرة – سواء كانت مكانية أو معنوية – لا تُقبل إلا إذا كانت خالصة لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
كما أكد فضيلة الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد لشؤون اللجنة العليا للدعوة الإسلامية، أن الهجرة النبويّة كانت حدثًا فارقًا غيّر مجرى التاريخ، وأنّ القرآن الكريم وصفها بالنصر، كما في قوله تعالى: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾، مشيرًا إلى أنّ النصر – بمفهومه الشامل – يُحدث تحوّلات كبرى في حياة الأمم، لأنه يُمكّن المنتصر من فرض قيمه وأفكاره وتقاليده على الواقع.
وأوضح فضيلته أن الهجرة لم تكن مجرّد انتقالٍ جغرافي، بل كانت إرادةً إلهية تجلّت في صورة نصرٍ مبارك، أتاح للناس أن يستمتعوا بوحي السماء، ويهتدوا بتعاليم النبوّة التي قامت على تقويم الاعوجاج وتصويب الأخطاء. وأكّد أنّ النبي ﷺ أسّس بهذا النصر مجتمعًا جديدًا في المدينة، غيّر العادات والأعراف التي كانت سائدة آنذاك، وهو ما يُعدّ من أهمّ وسائل التغيير الحضاري والتاريخي.
واختتم الدكتور حسن يحيى كلمته بالإشارة إلى أنّ من أبرز ثمار الهجرة المؤاخاة التي عقدها النبي ﷺ بين الأوس والخزرج، وبين الأنصار والمهاجرين، بعد أن كانوا في جاهليّتهم يقتتلون لسنين طويلة لأسباب واهية، دفنوا فيها أنفسهم بأيديهم من أجل ناقة أو ضرع. فجاءت الهجرة لتزرع أعرافًا جديدة يسودها الأمن النفسي والاجتماعي، وتُوحِّد الصفوف وتُقيم مجتمعًا متماسكًا يقوم على الإيمان والتكافل.