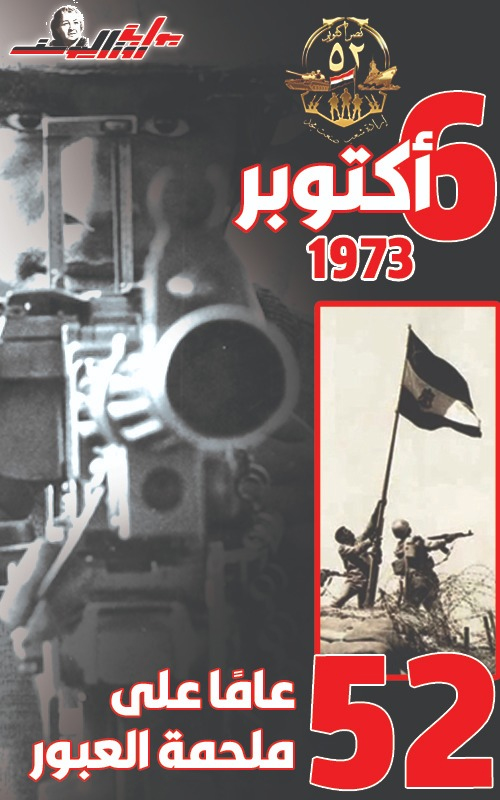أحمد باشا
من أرض المعارك إلى أرض الاتفاق.. «شرم الشيخ» تُنقذ «غزة»
ها هى شرم الشيخ تعود إلى الواجهة من جديد، لا كوجهة سياحية تتلألأ على شاطئ السلام؛ بل كعاصمة سياسية تحتضن واحدة من أهم لحظات التحول فى تاريخ الصراع «العربى- الإسرائيلى». فمن على أرض كانت يومًا تحت الاحتلال الإسرائيلى، تُعقَد المباحثات النهائية لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، برعاية مصرية مباشرة، وبمشاركة قطرية وتركية، وبتنسيق مع الإدارة الأمريكية التي أعلن رئيسها دونالد ترامب، مساء الأربعاء الماضى أن الجانبين توصّلا إلى اتفاق إطار؛ تمهيدًا لتوقيع الوثيقة النهائية فى شرم الشيخ خلال الأيام المقبلة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجّه دعوة رسمية لترامب لحضور مراسم التوقيع يوم الأحد المقبل، فى حدث يبدو أكبر من مجرد اتفاق، وأقرب إلى إعادة تعريف للمنطقة بأسْرها.
تلك اللحظة لم تأتِ وليدة ظرف عابر؛ بل ثمرة سنوات من الصبر الدبلوماسى المصري الذي ظل يعمل بصمت بينما يعلو صخب الآخرين. فالقاهرة، منذ اللحظة الأولى لانفجار الحرب على غزة قبل عامين، أدركت أن النزاع قد بلغ مداه، وأن النار لن تُخمدها إلا يد تعرف متى تُمسك العصا، ومتى تبسط الكفّ. وحين أنهكت الحرب الجميع- الفصائل الفلسطينية، والجيش الإسرائيلى، والشارع الدولى الذي أرهقته صور الموت- كانت مصر هى الطرف الوحيد القادر على صياغة مَخرج يحفظ ماء وجه الجميع، ويعيد للعقل مكانه وسط الرماد.
لم يكن الدور المصري مجرد وساطة شكلية؛ بل ممارسة حقيقية لسياسة الدولة التي تعرف وزنها وتاريخها. ففى الوقت الذي تبادلت فيه الأطراف الاتهامات، كانت القاهرة تنسج خيوط التفاهم بين العواصم المتباعدة، من واشنطن إلى الدوحة، ومن تل أبيب إلى أنقرة؛ لترسم خريطة دقيقة تحفظ للكل موقعَه دون أن تُسقط أحدًا فى الفراغ. وفى خلفية المشهد، كانت أجهزة الدولة المصرية الاستخبارية تدير الحوار الأمنى والإنسانى والسياسى فى آنٍ واحد، مستندة إلى فلسفة راسخة لا تتبّدل: لا تهجير، ولا تصفية للقضية الفلسطينية، ولا أمن لغزة بمَعزل عن أمن سيناء.
الاتفاق المبدئى الذي أُعلن من واشنطن يتضمّن ثلاث مراحل تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار، يعقبه تبادُل كامل للأسرَى والرهائن، ثم انسحاب تدريجى للقوات الإسرائيلية من داخل القطاع؛ تمهيدًا لإعادة الإعمار بإشراف دولى وتمويل عربى واسع. وهو اتفاق- رغم تعقيد تفاصيله- يعكس إدراكًا متبادلاً بأن لا أحد خرج منتصرًا من الحرب، وأن استمرار النزاع لم يَعد خيارًا قابلًا للاستدامة. إسرائيل تبحث عن مَخرج يحفظ هيبتها العسكرية، و«حماس» تبحث عن صيغة تضمن بقاءها السياسى فى مرحلة ما بعد النار، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى إنجاز دبلوماسى يُعيد لها بعضًا من نفوذها الشرق أوسطى، أمّا مصر؛ فهى وحدها من تمسك بالخيط الواصل بين كل هؤلاء، وتُعيد صياغة المشهد على قاعدة أن السلام لا يُشترى؛ بل يُصنَع بميزان من الحكمة والمسؤولية.
أن تُجرى مراسم التوقيع فى شرم الشيخ له دلالته العميقة، فهذه المدينة التي كانت يومًا تحت الاحتلال، تشهد اليوم انسحابًا جديدًا- لا من سيناء هذه المرة؛ بل من غزة- وكأن التاريخ يُعيد نفسَه فى صورة أكثر نضجًا وعدالة. شرم الشيخ التي احتضنت قمم الحرب والسلام، تعود اليوم لتؤكد أن مصر ليست طرفًا عابرًا فى المعادلة؛ بل هى قلبها النابض، وحارس توازناتها.. فحين يدعو الرئيس السيسي نظيرَه الأمريكى إلى الحضور، فذلك ليس مجاملة دبلوماسية؛ بل تأكيد رمزى على أن القرار يصدر من القاهرة، وأن مَن يريد السلام فى الشرق الأوسط لا بُدَ أن يمر عبرها.
قد يختلف المراقبون حول تفاصيل الاتفاق وآفاقه، لكن لا خلاف على أن مصر أنقذت غزة من السقوط فى العدم. ففى لحظة كانت تُنذر بانفجار إقليمى شامل، تحركت القاهرة بعقل الدولة لا بعاطفة الشعارات؛ لتصوغ صيغة حياة من قلب الموت.. ومن بين ركام الحرب، يخرج الآن احتمال السلام، لا كترف سياسى؛ بل كضرورة إنسانية تفرضها الجغرافيا ويكتبها التاريخ.
هكذا؛ من أرض عرفت رائحة البارود إلى أرض تُوقَّع فيها وثيقة سلام، تمضى شرم الشيخ لتُعيدَ تعريفَ دورها وموقعها. المدينة التي كانت عنوانًا للمعارك، تصير اليوم بوابة للعقل، وشاهدة على أن مصر، حين تتحدث، لا تتحدث باسم طرف؛ بل باسم المنطقة كلها وباسم الإنسانية جمعاء، وبصوت التاريخ الذي عَلّمَ العالمَ أن النيل لا يفيض ماءً فقط؛ بل حكمة أيضًا.
نقلًا عن مجلة روزاليوسف